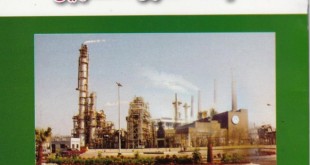ما الذي جرى في سوريا
- هو الكتاب الرابع للأستاذ محمد حسنين هيكل ، وقد صدر سنة 1962 .
- والكتاب من القطع المتوسط ضمن 198 صفحة ، ويحوي 14 فصلا :
1 - هجوم الربيع الذي نجح في الخريف !
2 - ما الذي جرى في سوريا ؟
3 - من المسئول عن إتمام الوحدة بين مصر وسوريا ؟
4 - ما أشبه الليلة بالبارحة .
5 - نقط الضعف في تجربة الوحدة .
6 - المشاكل الصغيرة في تجربة الوحدة وكيف عطلت زحف الشعب العملاق ؟
7 - حكاية حزب البعث في تجربة الوحدة .
8 - حكاية عبد الحميد السراج .
9 - من هم الذين قاموا بالانقلاب في سوريا .
10 - طبيعة المعركة ضدنا وحدودها .
11 - وحدنا في المعركة .
12 - 3 قوى تتجمع ضدنا .
13 - الليالي القادمة في الشرق الأوسط .
14 - مرحلة الصراحة والوضوح .
- لم يكن يقصد الأستاذ هيكل من هذه الأحاديث كلها عن سوريا وعن الذي جرى فيها ، أن تكون كتابا . وإنما كانت تفاعلا تلقائيا مع المشهد العنيف الذي شهدته دمشق فجر يوم 28 سبتمبر سنة 1961 ، والذي كان من أعقد المواقف في الدراما الهائلة التي تعانيها الأمة العربية كلها . لم تصدر عن الانفعال العاطفي بالحدث الكبير .. و لا الجانب العقلي عند الأستاذ هيكل قد نحى الفوران العاطفي وأبعد آثاره . فهو لم يستطع أن يترك العاطفة وحدها أن تشده إلى هذه الأحاديث ، ولم يرضى أن تكون إملاء حساب دقيق .. جامد ومشدود !
- أن الفهم العميق لقصة الوحدة بين سوريا ومصر ، هذه القصة التي عاشت ثلاث سنوات ونصف السنة ، سوف يكون لها من الآثار على المستقبل العربي ، ما يمتد إلى عشرات السنين . بل أن تفاصيل هذه التجربة سوف تمتد في تأثيرها ، إلى ما هو أبعد من فكرة الوحدة في حد ذاتها ، ومن المؤكد أن هذا التأثير سوف ينعكس أيضا على فكرة الحرية و الاشتراكية في المثل العربي الأعلى .
بصراحة بقلم محمد حسنين هيكل:هجوم الربيع الذى نجح فى الخريف!
ما أسهل الكتابة أيام السلام.
وما أصعبها فى ظروف الأزمات، أيام السلام تصبح الكتابة، كأنها النشيد، كأنها الأغنية، كأنها زقزقة العصافير صباح يوم من أيام الربيع.
وفى ظروف الأزمات يختلف الأمر.
الكتابة تصبح انتزاعاً من الأعصاب، قطرات دم من القلب، خصوصاً إذا كان الذى يريد أن يكتب، يحاول بطاقته البشرية المحدودة. أن لا يترك الزمام لعواطفه، لا يريد أن يستسلم لليأس القاتل ولا للأمل الخادع، لا يريد للمرارة فى مشاعره أن تجرف أمامها المبادئ والمثل، لا يقبل أن يبكى ولا يرضى أن يشتم.
محاولة صعبة، أشبه ما تكون بتجربة إشعال عود ثقاب وسط العاصفة وأمام الريح وتحت المطر.
هذا هو الذى أشعر به الآن. وسن قلمى يلمس الورق، ودوامة فى رأسى من الأفكار والصور، من التجارب والأحلام، من التلفت إلى وراء والتطلع إلى أمام.
أشياء كثيرة أريد أن أكتب عنها. خواطر مزدحمة تلح على. مشاكل كانت. أخطار قامت. أضواء خبت وأضواء تلوح.
هل أكتب أن العاصفة التى هبت على سوريا كانت أمراً متوقعاً؟
هل أقول إنه كان لابد للاستعمار، لقوى الاستعمار فى المنطقة، ولعناصر الرجعية، أن تلم صفها فى هجمة مركزة على الجمهورية العربية المتحدة، قاعدة النضال العربى وطليعته؟
ذلك قلته فى العاشر من شهر مارس الماضى فى مقال بعنوان هجوم الربيع، أى منذ أكثر من ستة شهور.
فى ذلك الوقت قلت أن ستار الهدوء الذى يغطى المنطقة العربية ستار كاذب، وأن شعارات التضامن العربى التى ترفعها القصور الرجعية فى المنطقة كلها أقرب ما تكون إلى قبلة الموت.
وأن الاستعمار وقد جرب فى كل ربيع ألوانا من الهجوم العسكرى، والنفسى، والاقتصادى، على القومية العربية، يجرب الآن أن يهاجمها بأسلوب جديد، أسلوب الاقتراب وذلك حتى “تقوم الجمهورية العربية المتحدة بتجميد فعالياتها وتجريد نفسها من أسلحتها وتحويل صوت دعوتها إلى همسة، وإشعاع ضوئها إلى بصيص خافت، ثم هى بعد ذلك تفقد قدرتها على الاندفاع، ثم قدرتها على الحركة”.
ذلك قلته بالحرف الواحد فى ذلك الوقت من شهر مارس سنة 1961.
ولكن هل أعيده اليوم، لأفعل كذلك الذى يضع يديه فى وسطه ويقول بالغرور والعناد:
– ألم أقل لكم؟!
لا أفعله بذلك القصد.!
ولا أذكره بكاءً على اللبن المسكوب.
ولكن أستعيده ليكون من فوائد الأزمة أن نعرف، وإلى الأبد، أن المعركة بين قوى الاستعمار وبين القوى الوطنية يجب أن تكون لها حدودها الفاصلة، وأن النضال بين فلول الرجعية، وبين طلائع التقدم يجب أن يكون ظاهراً لا يخفيه الإغضاء أو التراضى، أو الاستسلام إلى حل وسط!
هل أكتب.
– أين كانت أجهزة المخابرات والمباحث، وكل هذه الأدوات التى يرسمون لها صوراً كأنها الكابوس الذى يرزح على صدر النائم؟
من العجيب أنه كان ثمة تقرير سمعت عنه – ولست أملك هذه اللحظات وسيلة للتحقق النهائى من أمره – كان قد كتبه أحد المسئولين عن المخابرات، وفيه وردت معلومات عن الذين قادوا حركة التمرد فى دمشق، وعن تنظيماتهم، وعن نواياهم، ومع ذلك، فإن هذا التقرير، لم يجد الاهتمام الكافى!
هل أصرخ وأقول كيف حدث؟
مثل هذا يحدث فى كل مكان فى كل بلد. حتى فى أقوى البلدان.
ومع ذلك، فهل أقول، إننى أسمع فى ضميرى همساً يقول:
– الخيرة فيما اختاره الله!
إن فكرة الوحدة ما كان يجب لها أن تكون عملاً بوليسياً!
وأعرف فى هذه الثوانى، أن عشرات الأصوات، آلافها سوف تصيح فى وجهى:
– لقد كان واجباً حماية الوحدة من أعدائها!
ومع ذلك، فإنى أتمنى لو تسامح الذين يصيحون فى وجهى، بضع ثوان معى، أشرح خلالها منطقى.
دعونى أسلسل أفكارى، لتكون لى الفرصة التى أشرح بها تصورى.
دعونى أقل أولاً أن الوحدة التى تمت فى فبراير من سنة 1958، كانت عملاً سهلاً، خدعتنا سهولته، وصورت الأمر للأمة العربية على نحو هين ويسير.
صحيح أن نضال الأمة العربية من أجل وحدة شعوبها طويل ومستمر.
ولكن الذى حدث فى فبراير سنة 1958 تم بسرعة، وتم ببساطة، يمكن أن تصدق فى الأحلام ولكن لا تصدق فى الواقع الحى.
ولقد يقال لى:
– إذا كان الحلم قد تحقق، فلماذا لم نستطع الإمساك به، وتدعيمه، ومنحه قوة الحياة المستمرة؟
وأقول – بشرف – فى هذه اللحظة من لحظات الأزمة، التى يشعر الإنسان فيها أن لا حواجز من الأوهام بينه وبين ضميره:
– لقد كان ذلك من أصعب الأمور، لأن الأمة العربية لم تملك بعد مقومات التدعيم الحقيقى لوحدة شعوبها.
لقد كان يجب أن يكون هناك أساس فكرى عميق لإقامة الوحدة.
وكان يجب أن يكون هناك أساس اقتصادى قوى لإقامة الوحدة.
وكان يجب أن يكون هناك أساس اجتماعى قوى لإقامة الوحدة.
وذلك كله لم يكن قائماً،
وإنما كانت هناك مرحلة خطر.
وكانت هناك فوره عاطفية.
وفى وقت إقامة الوحدة، كانت سوريا تتعرض لضغط من جانبين.
من جانب حلف بغداد. تتقدمه الأسرة الهاشمية التى باعت تراث العرب والإسلام كله مقابل تيجان وعروش.
ومن جانب الشيوعيين. يتزعمهم الحزب الشيوعى السورى الذى أراد تحويل سوريا إلى قاعدة للعمل فى قلب العالم العربى.
وبين الضغطيين، وفى أعقاب عدوان السويس، تجلى الخطر، وكانت الفورة العاطفية رد فعل له.
وقامت أول تجربة للوحدة العربية.
وفى ذلك الوقت كانت الوحدة أشبه ما تكون بعملية دفاع طبيعية قامت بها الأمة العربية، وأكاد أقول الآن إن هذه العملية الدفاعية حققت أغراضها.
– أسقطت حلف بغداد وأزاحت كابوس الأسرة الهاشمية من العراق.
– أرغمت الخطر الشيوعى أن يتراجع عن سوريا، بل واستطاعت أن توجه إليه ضربة شديدة فى العراق.
ولكن إتمام الوحدة وتدعيمها كان يحتاج إلى ما هو أكثر من عمليات الدفاع.
إن الوحدة كان لابد لها أن تكون ما هو أعمق من ذلك وأبقى.
كان لابد لها لكى تبقى وتعيش فى تجربتها الأولى – أن تكون أبعد من الخطر المرحلى، ومن فورة العاطفة التى قامت كرد فعل له.
دعونى أقل ثانياً إن العناصر التى قادت اتجاه الوحدة فى سوريا، انساقت إليه بطريقة سلبية. أو بمعنى أصح – وهذا استكمال لما شرحته الآن – بطريقة دفاعية.
كانت الأحوال فى سوريا تتردى إلى هاوية مجهولة الأعماق.
وفى وقت من الأوقات بدا – أمام العناصر السورية التى انساقت فى اتجاه الوحدة – أنه إذا لم يحدث شىء من خارج سوريا، فإن سوريا سوف تقع إما تحت سيطرة حلف بغداد، وإما تحت حكم الشيوعيين.
وكانت تلك – على حقيقتها – هى الصورة التى شرحها ضباط الجيش وقادة الأحزاب السورية حينما قدموا إلى القاهرة يطلبون الوحدة بصورتها الاندماجية الشاملة.
فى ذلك الوقت قال لهم الرئيس جمال عبدالناصر:
إن إقامة الوحدة تحتاج إلى تمهيد أكبر.
إننا نحتاج على الأقل إلى خمس سنوات، لنضع أسساً حقيقية للوحدة.
أسساً اقتصادية.
أسساً سياسية.
أسساً شعبية.
ولكن الخطر كان يلهب ظهورهم، وفورة العاطفة تشدهم.
ومن ناحية أخرى – وأنا أقول الآن ذلك كله بصراحة – فلقد كان كل منهم يريد السبق إلى الوحدة لتكون له بعد ذلك – فى حمايتها – فرصة للتحكم فى أقدار سوريا، بعد أن عزت هذه الفرصة على كل منهم فى حمى الصراع الحزبى الذى كان محتدماً ذلك الوقت فى سوريا.
وأنا واحد من الناس الذين أعجبوا بحزب البعث – مثلاً – قبل الوحدة، أعجبت به خلال قراءاتى لفيلسوفه ميشيل عفلق.
ولكنى أيضاً واحد من الناس الذين صدمتهم تصرفات حزب البعث بعد الوحدة، فلم يكن فى رغبة قادته فى ذلك الوقت من شىء إلا محاولة الانفراد والسيطرة والتسلط على الأمور فى الإقليم السورى وحده.
كانوا يريدون يداً مطلقة هناك. لا أكثر ولا أقل.
وكان هذا حال غيرهم من العناصر التى انساقت فى عملية تنفيذ الوحدة سنة 1958.
دعونى أقل ثالثاً، إنه فى وجود هذه العوامل الدفاعية والسلبية التى قادت تيار الوحدة، لم تكن هناك فى الواقع بين الشعبين العربيين فى مصر وسوريا من روابط فعلية وإيجابية لقيام الوحدة، إلا شىء واحد. هو جمال عبدالناصر وشخصيته وشعبيته.
وأنا معجب بجمال عبدالناصر. مؤمن به.
ولا أظن أحداً يستطيع أن يتهمنى فى هذا الإعجاب أو هذا الإيمان.
ولكنى أقول – بقلبى وعقلى – إن “شخصية البطل” لا تكفى وحدها لتصنع وحدة الأمة العربية.
إن “شخصية البطل” يمكن أن تكون قوة دافعة، يمكن أن تكون قوة قادرة على التمهيد للأسباب الحقيقية للوحدة.
ولكن “شخصية البطل” لا يمكن بحال من الأحوال أن تكون كل أساس الوحدة وكل مضمونها.
إن “شخصية البطل” تستطيع أن تقود. وتستطيع أن تلهم.
ولكنها لابد أن تقود قوى شعبية عارمة.
لابد أن تلهم أسساً حقيقية راسخة.
ولقد كنت فى كثير من الأحيان، أشعر بالخطر الذى لابد أن تواجهه تجربة الوحدة التى قامت سنة 1958، من جراء ارتكازها فى الأساس على شخصية “البطل”.
وفى هذه اللحظة الحاسمة من تاريخ الأمة العربية، بعد ما حدث فى دمشق، أشعر فى أعماقى بعرفانٍ لا يحد.
لقد تحقق الخطر فى وجود “البطل”. وقعت النكسة، و”شخصية البطل” واقفة بكل قوتها وقدرتها. تملك أن تصحح خطأ الحوادث. وأن تصنع حركة حقيقية نحو الوحدة. تقوم على الأساس الصلب المتين، الذى لا يتعلق بفرد ولا يرتبط “بشخصية بطل”.
وإنما يقوم على حركة الجماهير نحو آمالها السياسية والاجتماعية والاقتصادية. وعلى هذه الحركة وحدها يقوم. ليبقى ويدوم.
هل أكتب:
– الحمد لله الذى ألهم جمال عبدالناصر فى لحظة الأزمة الحاسمة أن يكون ابناً طبيعياً لأمته فيأمر بإيقاف كل العمليات العسكرية؟
لقد كانت وقفة رائعة من مواقف قهر النفس ومغالبة العاطفة.
وقفة من مواقف الرجولة القادرة على تحويل مجرى التاريخ.
فى ساعة من ساعات يوم الخميس الأسبق. بعد قيام حركة التمرد فى دمشق، وقيام المظاهرات الشعبية المعادية لها فى كل مكان، خصوصاً فى حلب واللاذقية، كانت هناك قوات ضخمة على استعداد للتحرك.
كانت هناك فرقة من جنود المظلات، من جنود الصاعقة قوامها ألفا مقاتل تتأهب للهبوط فى اللاذقية وحولها.
وكان الأسطول كله على وشك أن يتحرك ليلحق بها. بل كانت بعض السفن التجارية قد تحولت فى ساعات إلى ناقلات جنود.
بل وبدأت طليعة قوة المظلات تهبط بالفعل.
بل وبدأ الأسطول يتحرك وعلى ظهره فرقتان كاملتان، بالسلاح والمدرعات. أى ما يقرب من خمسة وثلاثين ألف جندى.
كانت قوة الصاعقة قادرة – ولو وحدها – على السيطرة على ميناء اللاذقية، حتى تلحق بها القوة القادمة على الأسطول. وكانت هذه القوة كلها قادرة على احتلال شمال سوريا كله، والزحف على دمشق لضرب حركة العصيان.
وفى ومضة الإلهام الإلهى، تحول مجرى التاريخ العربى كله.
تدخل جمال عبدالناصر وأوقف كل شىء.
سأل نفسه فى هذه اللحظة الحرجة سؤالين:
أولاً – هل أرضى لقوات من الجيش الثانى للجمهورية العربية المتحدة أن تشتبك فى معركة عسكرية مع قوات من الجيش الأول؟
وأجاب على نفسه:
– ليس لمثل هذا حاولت الأمة أن تقيم جيشها القوى، وأن تضع تحت يده أقوى السلاح.
إن الجيش العربى القوى أعد للعدوان الاستعمارى. وأعد لإسرائيل.
ثانياً – ما هو ثمن النصر؟
وأجاب جمال عبدالناصر على سؤاله الثانى:
– الثمن مهما كانت النتائج سوف تدفعه الجمهورية العربية المتحدة. سوف تدفعه الأمة العربية. سوف تدفعه من دماء أبنائها، وسوف تدفعه إلى الأبد من فرقتها وانقسامها. ففى لحظة الاشتباك يمكن أن تتحول المعركة إلى “مصرى” وإلى “سورى” خصوصاً عندما يبدأ الدم يسيل أنهاراً فى سهول الشمال ورباه.
وبعد السؤالين. وبعد الإجابة عليهما. أوقف جمال عبدالناصر بنفسه كل التحركات العسكرية.
1- الطائرات التى كانت فى طريقها لإنزال قوات المظلات صدرت إليها الأوامر بإيقاف عمليات الإنزال. بل لقد حدث أن إحدى الطائرات كانت قد أنزلت بالفعل نصف جنودها، ثم وصلتها الأوامر فأقفلت بابها واستدارت عائدة بالنصف الباقى من هؤلاء الجنود.
2- عادت إحدى الطائرات إلى فوق منطقة الإنزال تتصل بالقوة التى كانت قد هبطت بالفعل، وتكرر إصدار الأوامر إليها، بأن لا قتال، وبأن لا معركة، وبأن على قائدها أن يتقدم بأفرادها إلى أقرب موقع سورى وأن يقدم نفسه.
3- تلقت قوات الأسطول وكانت قد وصلت إلى قبرص أمراً بأن تدور فى البحر وتعود إلى الإسكندرية وإلى بورسعيد.
ولما قيل لجمال عبدالناصر فى تلك اللحظة:
– ولكن هناك قوات من الجيش الأول تطلب النجدة وترفض إطاعة أوامر التمرد الصادرة لها فى دمشق!
ولما قيل له:
– ولكن هناك مظاهرات شعبية جارفة فى كل مكان من سوريا، وإن عناصر التمرد قد تتحرك لضرب هذه الإرادة الشعبية، ثم يبدو وكأننا تخلينا عن الذين وقفوا لحظة المحنة!
لما قيل ذلك كله. كان رد جمال عبدالناصر:
– تلك كلها تفاصيل.
لتكن هذه المحنة كلها استفتاءً جديداً لإرادة الشعب العربى فى سوريا.
ليسقط ثلاثة أو أربعة فى المظاهرات الشعبية أمام قوى التمرد بدل أن يسقط آلاف فى الصدام العسكرى ثم تكون فرقة الدم، ثم يستتب الأمر كله لعدو الأمة العربية.
لقد قامت الوحدة وبإرادة شعبية، وإذا كان تيار الوحدة يقمع الآن بقوة الدبابات، فإن ذلك – بصرف النظر عن مرارة الدقيقة – خير لمستقبل النضال العربى، لكى تتثبت الأمة العربية من إيمانها، ولكى تشعر أنها دفعت ثمن هذا الإيمان، ولكى تبقى لها دائماً حوافز الحركة والتقدم”.
هذا كله من ناحية.
ومن ناحية أخرى فقد كان المضى فى أى عمليات عسكرية – بصرف النظر عن تأثيره فى إخراج الوحدة عن طابعها كإرادة شعبية – فرصة يمكن أن يستغلها أعداء العرب.
كان الأسطول الأمريكى السادس. نفس الأسطول الذى تظاهر فى البحر الأبيض، عندما رتب الملك حسين انقلابه على الحكم الوطنى فى الأردن سنة 1957. نفس الأسطول السادس الذى أنزل جنوده سنة 1958 على شواطئ لبنان. نفس هذا الأسطول السادس كان يتحرك إلى البحر الأبيض.
كذلك كانت تركيا – واعترافها بحركة التمرد فى لحظة قيامها – ومطامعها فى الشمال السورى كله معروفة – قادرة على التدخل العسكرى فى الموقف.
كذلك كان بوسع إسرائيل أن تنتهز الفرصة لضربة تنهش فيها أى قطعة من الوطن العربى.
وخلال هذا كله، لم تكن الرجعية العربية، سواء فى قصر رغدان بعمان، أو فى مقر الشركة الخماسية فى دمشق، أو فى غير ذلك كله من المعاقل التى يكمن فيها أعوان الاستعمار وأعداء التقدم. لم يكن هؤلاء جميعاً سوف يتورعون عن الاستعانة حتى بالعدو نفسه ضد حركة القومية العربية التى تمثل عليهم خطراً سياسيا واجتماعياً واقتصادياً يهددهم أينما كانوا. فى الشركات الكبرى أو فى القصور.
هل أكتب عن ذلك كله الآن وأقول:
– الحمد لله.
الحمد لله أن العقل كانت له الغلبة على الكبرياء. وأن المستقبل العربى الطويل استطاع أن ينتصر على انفعال اللحظة.
ذلك كله أريد أن أكتب فيه.
أريد أن أكتب فيه كثيراً. بأعصابى، وبدم قلبى.
ولسوف أفعل. فأمامنا طريق طويل طويل. وأمامنا أيام من النضال وليال.
وإنما المهم فى هذه اللحظات، على حد ما قال جمال عبدالناصر:
“أن تكون لنا قدرة الرجال. على مواجهة العدو. وعلى مواجهة أنفسنا”.
بصراحة بقلم محمد حسنين هيكل: (1) محاولة لاستكشاف الحقيقة
نظرة إلى الوراء على التيارات التى تحركت ودارت فى دمشق يوم 8 مارس.
كان المنطقى، أن يكون حديثى هذا الأسبوع عن أفريقيا، وعن حركتها الماردة، التى قفزت بها مرة واحدة فوق هضاب أثيوبيا لتطلق صيحتها الهائلة التى عبر عنها “جوليوس نيريرى” رئيس تنجانيقا بقوله: “تريد أفريقيا أن تكون حرة لتعمل من أجل الوحدة، وأن تكون متحدة لتعمل من أجل الحـرية”.
ولقد قضيت معظم أيام الأسبوع فى أديس أبابا – أو زهرة الجبال إذا ما ترجمنا الاسم ترجمة حرفية عن اللغة الأمهرية.
تابعت المؤتمر، وحضرت جلساته لم أتخلف عن واحدة منها.
واستمعت وتحدثت إلى معظم شخصيات أفريقيا ممن شاركوا فى أعمال المؤتمر وبعضهم كنت أراه لأول مرة.
ولقد خرجت باكتشافات فكرية أحس أهميتها بالنسبة لى.
واستشرفت على آفاق واسعة تلوح عليها احتمالات غير محدودة فى تطور القارة ومستقبلها.
وقضيت ساعات عابسة، كتلك الساعات التى شغلت نفسى فيها من جديد بدراسة النشاط الإسرائيلى فى أفريقيا.وقضيت ساعات أخرى باسمة كتلك الساعات التى دخلت فيها مرة أخرى، فى مناقشات حامية الوطيس مع “سى الحبيب” أو الرئيس الحبيب بورقيبة. حامية الوطيس، كما قلت، لكنها ودية!
وذلك كله، كان ذخيرة تصلح للحديث هذا الأسبوع، وكان ذلك هو المنطقى على أى حال!
ومع ذلك، أى شىء فى هذا المشرق العربى يلتزم بقواعد المنطق؟
هذا سبب تليه أسباب أخرى.
بينها أننى عدت من أيامى الأفريقية الخمسة فوجدت على مكتبى أكثر من ثلاثة آلاف خطاب، نصفها على الأقل من سوريا، وحديث أصحابها كله عن التطورات المؤلمة التى تجرى الآن فى الشرق العربى، بعد أن بدأت قيادة حزب البعث فى سوريا مسيرها على طريق الصخور.
ولقد قضيت يوماً كاملاً أجرى بعينى على سطورها ولا أصل إلى آخرها.
ولقد خُيّل إلى أننى استمعت فى هذه الخطابات إلى ضمير الرأى العام العربى، وحكمه:
“أن أفريقيا بغير شك أمر بالغ الأهمية والخطر، لكن العالم العربى يواجه اليوم مشكلة مصير”.
ومع اقتناعى الكامل بأن كل التواءات قيادة حزب البعث فى سوريا وانحرافاتها لن تستطيع صد العالم العربى عن المصير الذى يريده. فلقد أحسست بأننى مطالَب بالبقاء مع مشكلة المصير أشارك فى مواجهتها بالشىء الوحيد الذى لا أملك غيره مع الأسف: “الكلمة”!
وماذا عندى هذه المرة لأقوله عن قيادة حزب البعث فى سوريا؟
فى الحقيقة أننى هذه المرة أريد أن أعرض تصوّراً عاماً وصلت إليه.
ولقد كان فى يوم من الأيام ظنا، وأخاله الآن أصبح عندى يقينا.
هذا التصور العام الذى وصلت إليه، هو أن قيادة حزب البعث فى سوريا، لم تكن فى أى لحظة من اللحظات بعد يوم 8 مارس مخلصة فى طلب الوحدة مع مصر أو جادة فى العمل من أجلها.
إن هدف قيادة حزب البعث فى سوريا هو أن تقيم دولة حزب البعث، ولما كان البعث بلا قاعدة جماهيرية، فإن دولة حزب البعث لا تقوم إلا على انقلاب يفتح الطريق إلى تسلط حزب البعـث.
وحتى تتمكن قيادة الحزب من الوصول إلى هدفها، فإنها تفعل ما تفعله الآن.
– تمضى فى تنفيذ مخططها بكل طريقة.بالدس والتآمر ضد القوى الشعبية. أو بالمذلة والهوان إن دعا الأمر أمام السلطة العسكرية!
وتتجنب فى هذه المرحلة أى صدام عنيف مع القاهرة تريد أن تكسب وقتا تخرج فيه من المرحلة الحرجة.
– فإذا ما انتهت من عمليات التصفية لكل ما يقف فى وجهها شعبياً، ثم أصبحت نتيجة لذلك الواجهة السياسية الوحيدة التى تستر السلطة العسكرية فى سوريا، حانت فرصتها أو هكذا تظن – لكى تمثل دور الأقوى – حتى فى القيادة العسكرية، ثم تحكم بعدها قبضتها على جهاز الدولة تمسك بسلطته الناس قهراً وقمعاً، ثم تتحول إلى معركة مع القاهرة.
والذى يستعرض تطورات الحوادث التى تعاقبت بسرعة خلال الشهور الأربعة الأخيرة ويترك التفاصيل الصغيرة جانبا، ويلتزم حركة الحوادث الشاملة، يصل – فى تقديرى – إلى هذه النتيجة أو بقربها.
ونحاول الآن متابعة الحركة الشاملة للحوادث. وبكل الإنصاف والموضوعية، نلتزم الدقة سواء فى العرض أو فى التسلسل!
لكن هناك مقدمة عراقية للموقف قبل أن تبدأ فصوله السورية:
بعد أن قامت الثورة فى العراق ضد حكم قاسم، مدت القاهرة يدها إلى النظام الجديد فى بغداد، مع معرفتها بدور حزب البعث فيه – تعاونا صادقا ومخلصا، على أساس وحدة الهدف.
ولم يكن حديث الوحدة الدستورية، فى أية صورة من الصور مطروحا للمناقشة بين القاهرة وبغداد.
وحين وصل إلى القاهرة أول وفد عراقى بعد الثورة ليشترك فى احتفالات عيد الوحدة فى 21 فبراير كان كل شىء كامل الوضوح.
للعراق مشكلاته.وله ظروفه، ومن حقه أن يحصل على الوقت اللازم ليستطيع حل مشكلاته ومواجهة المعقد من ظروفه.
وطليعة المشكلات. المشكلة الكردية التى وصلت إلى القتال المسلح فى حرب أهلية كاملة.
ومقدمة الظروف. ظروف قيام الثورة ذاتها والإجراءات التى رأتها لازمة لتأمين نفسها، والدم الذى يجرى ساخنا على أرض العراق الساخنة، وأكثر من عشرة آلاف معتقل رأت الثورة وضعهم وراء القضبان لاعتبارات تراها.
ولم تكن القاهرة فى عجلة من أمرها. وكل ما تمنته لزوارها – يومها – هو أن تنجح الثورة فى العراق وأن تتمكن بكل الكفاية من حل مشكلاتها والتغلب على ظروفها.
كان موقف الجانبين وقتها. واضحا. وأضيف: وأمينا!
ثم بدأ الفصل الأول فى سوريا:
يوم 8 مارس تحركت عجلة الحوادث فى سوريا، وحين نلتفت الآن إلى ما جرى يومها تبدو لنا – خصوصا – على ضوء ما تلاحق من حوادث بعدها – إشارات فى أحداث ذلك اليوم لها دلالتها، أهمها.
أن العناصر العسكرية التى قامت بالجزء التنفيذى من انقلاب يوم 8 مارس لم تكن واضحة فى اتجاهها الوحدوى.
ومن ألزم الواجبات الآن رسم صورة محددة لما وقع يومها.
– إن الذى تولى تنفيذ الانقلاب هو اللواء زياد الحريرى رئيس أركان حرب الجيش السورى الآن، ولم يكن زياد الحريرى. وأنا أقول ذلك بكل صراحة وأمانة – صاحب فكرة محددة. وإنما كان فى الجيش السورى وجوه – الذى نعرفه جميعا بعد الانفصال – ضابطا يحلم بحركة، وكانت من حوله كتلة تشايعه، وأحست به فى هذه الظروف قوتان:
قوة الضباط الوحدويين، العاملة فى الجيش السورى من أجل فكرة.
ثم قوة قيادة الانفصال، العاملة على تأمين الجيش السورى لحساب مصالحها.
وبينما حاولت قوة الضباط الوحدويين أن تتصل بزياد الحريرى، وتنسق العمل معه، حاولت قوة قيادة الانفصال أن تتخلص منه، أصدرت بالفعل قراراً تنقله بمقتضاه من قيادة الجبهة ملحقا عسكريا خارج سوريا.
فى ذلك الوقت، اتصل اللواء زياد الحريرى بمجموعة الضباط الوحدويين وبينهم اللواء راشد قطينى الذى عين يوم 8 مارس نائبا للقائد العام للجيش السورى يحاول تنسيق خطة معه.
ويبدو أن اللواء راشد قطينى، أحس أن اللواء زياد الحريرى على عجلة من أمره، بسبب ظروف نقله خارج الجيش، وكان يخشى عواقب التحرك السريع تحت ضغط عامل طارئ وفردى.
كذلك من ناحية أخرى أحس اللواء زياد الحريرى، أنه يواجه آخر فرصة أمامه ليحقق أحلامه فى قيادة حركة، وأنه إذا انتظر، أو إذا نفذ الأمر بنقله ملحقا عسكريا فلن يجد الدور الذى يحلم به.
ساعتها سوف يجد نفسه خارج مسرح الحوادث.
وإذا أعطى دوراً بعد نجاح أى انقلاب فلن يكون دوراً رئيسيا كما يتمنى.
ولابد – بروح العدل – أن نقول إن اللواء زياد الحريرى فى تقديره لاحتمالات الحركة الناجحة كان أبعد نظراً من غيره، فلقد سقط النظام الرجعى الحاكم فى دمشق قبل 8 مارس كما تسقط تفاحة ناضجة إلى حد العَطن من أول هزة للشجرة المريضة المنهوكة القوى.
وحين أحست القوى الوحدوية فى الجيش السورى بحركة اللواء زياد الحريرى. سارعت إلى المشاركة فيها وبذل كل الجهود لإنجاحها.
هكذا فى الصباح الباكر فى يوم 8 مارس كان فى مبنى الأركان العامة للجيش السورى مجموعتان من الضباط. أو ثلاث مجموعات :
مجموعة زياد الحريرى التى جاءت زاحفة من الجبهة.
مجموعة الضباط الوحدويين التى تحركت من عدد من المعسكرات القريبة من دمشق.
ثم المجموعة الثالثة التى زادت فى اللحظة الأخيرة، وفى مقدمتها عدد من الضباط الذين لم يشاركوا فى الانقلاب أصلاً، لكن سمعتهم فى الجيش السورى كانت طيبة يصلحون خصوصاً كواجهات تمتص التوترات العنيفة فى ظروف الانقلابات العسكرية التى تشترك فيها عناصر متناقضة بالأمزجة وبالأفكار وبالاتجاهات، وخير مثال لهذه المجموعة الفريق “لؤى الأتاسى” الذى عُين يومها قائداً عاماً للجيش السورى بعد ترقيته من رتبة العقيد إلى رتبة الفريق، والذى كان فى السجن قبل الانقلاب بشهور. وخرج منه صباح الانقلاب إلى دار الأركان العامة، والذى كان يقول يومها لكل من يقابله للتهنئة:
– ليس لى دور فيما حدث. إن الحركة أصلا قام بها الأخ زياد!
وليس يهمنى بعد ذلك أن الفريق غيّر رأيه، وقال فى أكثر من مناسبة إن فكرة الثورة فى سوريا كانت فى رأسه منذ زمن بعيد وأنها ولدت على شرفة جروبى فى مصر الجديدة حين كان الفريق فى القاهرة بعد الانفصال، تلك مسألة حقيقتها بين الفريق ونفسه، وإنما الثابت أن الفريق كان فى السجن شهورا قبل 8 مارس!
وأوضح دليل – بعد ذلك – على أن زمام التطورات كان فى يد العناصر التى لم تكن واضحة فى اتجاهها الوحدوى: هو تكليف السيد صلاح البيطار شخصيا بتشكيل الوزارة يوم الانقلاب. والاتجاه إلى حزب البعث بالذات ليكون الشريك السياسى الرئيسى فى تحمل مسئولية الحكم الظاهرة على الأقـل!
– أشهر مواقف صلاح البيطار قبلها. هو توقيعه على عريضة الانفصال.
– وسياسة حزب البعث يومها – أو قيادته – نفس ما كانت عليه منذ انسحب من تجربة الوحدة الأولى بعد أن فشل فى السيطرة عليها. أو فى استغلالها بقصد التسلط على سوريا والانفراد بحكمها باسم الوحدة وتحت ستارها!
ثم توالت تطورات ذلك اليوم الغريب تشكل الحوادث وفق النزعات الحقيقية للعناصر المسيطرة فى قيادة الانقلاب ومن غير صدام مع التيارات الغالبة من حولها خصوصا بين جماهير الشعب السورى.
وخرجت من منطق ذلك اليوم تركيبة تشكيل سياسى عجيبة لكنها تعبير واقعى عنه بكل نزعاته المتناقضة!
إن العناصر التى سيطرت يومها فى قيادة الانقلاب:
– لم تكن واضحة فى تفكيرها الوحدوى، لكنها من ناحية أخرى بحكم إقدامها على إسقاط حكم الانفصال، كان لابد لها أن تتخذ موقفا من قضية الوحدة تلزم به الرأى العام فى سوريا بحركتهـا، لكنه لا يصل إلى الحد الذى يلزمها هى بحركة الرأى العام السورى.
– ولم تكن واضحة فى تفكيرها التقدمى، لكنها من ناحية أخرى بحكم إقدامها على إسقاط حكم الرجعية، كان لابد لها أن تتخذ موقفا من قضية الاشتراكية يعطى واجهة تقدمية أو شبه تقدمـية، لكنه لا يصل إلى حد يقطع كل صلة بينها وبين العناصر المسيطرة على الاقتصاد السورى.
إن هذه الافتراضات المتنافرة المتعارضة وصلت جميعها بالذكاء الانقلابى إلى معادلة تبدو لنا الآن مفهومة.
اتجاه وحدوى. لكن على شرط أن لا يصل إلى وحدة!
واتجاه تقدمى. ولكن على شرط أن لا يصل إلى تطبيق اشتراكى!
– إن الوصول إلى الوحدة ينهى كل الآمال فى المغامرة التى تصدت لتنفيذ جزء كبير من عملية انقلاب يوم 8 مارس.
– كذلك فإن الاتجاه الحقيقى إلى التطبيق الاشتراكى يصفى الرجعية السورية أكبر العوائق على طريق الوحدة.
والمعادلة، مهما اختلفنا معها، بشرية فى جانب من جوانبها، فليس سهلا أن يتصدى واحد من البشر لمغامرة خطيرة بالليل، ثم يقف فى الصباح بعد نجاحه فيما قام به ليقول بملائكية:
– الآن انتهى دورى.
ثم يمضى إلى الظل!
ولقد كان الطريق واضحا لو أن العناصر المسيطرة على الانقلاب يومها كانت أصيلة فى موقفها الوحدوى والتقدمى.
– ساعتها كانت تعلن على الفور، وفى بيانها الأول عودة الوحدة. وبأى صورة قد تراها مصححة للتجربة السابقة، على افتراض أن لها رأياً بناءاً فيها.
– وساعتها كانت تعلن على الفور، وفى بيانها الأول عودة قوانين يوليو الاشتراكية التى سرقتها الرجعية مدبرة الانفصال!
لكن ذلك لم يحدث.
وعبّرت تركيبة الحكم الذى شكل يومها عن شىء آخر هو كما قلت: الاتجاه الوحدوى بشرط أن لا يصل إلى الوحدة، والاتجاه التقدمى بشرط أن لا يصل إلى التطبيق الاشتراكى.
هكذا دخلت قوى وحدوية فى الوزارة لا تقدر على فتح الطريق إلى الوحدة أو الاشتراكية.
ودخلت قوة البعث فى الوزارة والوحدة والاشتراكية عندها شعارات وليس داخل الشعارات مضمون حقيقى.
– لكن الميزان يومها فى مبنى الأركان العامة للجيش السورى كان دقيقاً، وأحست قيادة حزب البعث بدقة الميزان، واستشعرت على الفور المعادلة الدقيقة المطروحة للتجربة فى سوريا وسارعت إلى الاستفادة منها.
طلبت حصة الأسد فى الوزارة وفى المجلس الوطنى لقيادة الثورة.
وطلبت إعادة بعض العسكريين البعثيين الذين سرحوا من الجيش السورى.
وهكذا كان، خصوصا وأن ذلك مرحليا يناسب منطق المعادلة المطروحة للتجربة فى سوريا، يضاف إلى ذلك اعتبار هام وجديد هو أن حزب البعث فى سوريا يمكن أن يكون جسرا مع حزب البعث الحاكم فى العراق، تعود به اللعبة التقليدية فى المشرق العربى، وهى موازنة القاهرة ببغداد.وبغداد بالقاهرة.
وفى نهاية يوم 8 مارس، كانت القاهرة ترى بعض أجزاء الصورة، ولا أدعى أنها كانت ترى الصورة كاملة، وحتى لو رأتها كاملة فما أظن أن ذلك كان يغير موقفها فى شىء.
كان الموقف الذى اتخذته القاهرة يرتكز على دعامة رئيسية واحدة:
هناك فى دمشق الآن انقلاب ضد النظام الرجعى الانفصالى. ومن ثم فنحن معه، نسانده ونؤيده على طول الخط.
وهكذا على أساس من سياسة وحدة الهدف تصرفت القاهرة بمنتهى الوضوح والقوة.
أيدت وساندت.
أكثر من ذلك، وقطعا للطريق على أى مناورة، كانت القاهرة أول من اعترف رسميا بالنظام الجديد فى سوريا وبعث الرئيس جمال عبدالناصر بعد دقيقة واحدة من إعلان تشكيل الوزارة فى سوريا برقيته الشهيرة إلى المجلس الوطنى لقيادة الثورة.
لم تكن القاهرة تريد أن تفرض وحدة. الوحدة فى رأيها لا تفرض.
لم تكن القاهرة تريد أن تفرض اشتراكية. الاشتراكية تمليها إرادة الجماهير السورية.
بل لقد كانت القاهرة تؤمن أن خير طريق إلى الوحدة والاشتراكية فى سوريا هو أن تفسح المجال كاملا لإرادة الشعب السورى حرة بغير أى ضغط. حتى من غير محاولة،و لو غير مباشرة للتأثير عليها لا من قريب ولا من بعيد!
هكذا أيدت. وساندت.
ثم اعترفت. وابتعدت تماماً. عن كل تفاصيل فى سوريا.
لكن الشعب السورى كان له رأى يختلف.
يختلف عن النزعات المتحكمة فى مبنى الأركان، والمعادلة العجيبة التى فرضتها هذه النزعات للتجربة فى سوريا.
ويختلف عن الحساسية المفرطة فى القاهرة هذه التى أملت سياسة التأييد والمساندة والاعتراف. والابتعاد.
لكن رأى الشعب السورى هو بداية الفصل الثانى.
فلتكن استراحة قصيرة هنا!.
بصراحة بقلم محمد حسنين هيكل: (2) ما الذى جرى فى سوريا؟
و3 حقائق أساسية فى مقدمة الحديث!
مهما كان من أمر ما حدث فى سوريا.
ومهما كان من أمر ما سوف يحدث فى سوريا.
فهناك فى هذه اللحظات الجياشة بالعواطف والمشاعر المتضاربة، والأفكار والآراء المتصارعة – حقائق أساسية لا ينبغى لها أن تتوه فى الفوران وتغيب فى تقلباته، أو تتوارى فى أكوام التحليل والتنقيب والتفتيش عن الأسباب والمسببات.
أولى هذه الحقائق أن الشعب العربى فى مصر والشعب العربى فى سوريا يجب أن تبقى لهما دائماً هذه العلاقات التى ربطت بينهما منذ الأبد وإلى الأزل.
ثانية هذه الحقائق أن عروبة مصر ليست عاملا تهزه نكسة عاطفية، وليست مرحلة عابرة يمكن أن ينتهى توقيتها، بل إن عروبة مصر حقيقة من حقائق الطبيعة ذاتها.
ثالثة هذه الحقائق أن وحدة شعوب الأمة العربية حتمية كالقدر، وإن كان التمهيد إليها والسعى من أجلها وتحقيقها أملاً وشعاراً وفعلاً، يقتضى – كما يتضح من التجربة – عملا وطنيا فى كل بلد عربى، يطور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية فيه إلى مستوى تحقيق الوحدة.
بعد هذه الحقائق الأساسية الثلاث، يتحتم علينا هنا، فى هذه الجمهورية العربية المتحدة، أن نفتح باب المناقشة الحرة على مصراعيه فى التجربة الأولى للوحدة العربية، فإنه عن هذا الطريق وحده تتحول المأساة التى وقعت فى سوريا، إلى تجربة حية تفيد الأمة العربية فى مستقبل نضالها، الذى يتوقف عليه مصيرها الواحد، وعن هذا الطريق وحده، يمكن أن تحصل الأمة العربية على فائدة، أو على شبه فائدة، لكل الجهد الذى بذل، ولكل الدم الذى أريق، ولكل الأعصاب التى التهبت، بسبب سوريا، سواء داخل سوريا أو خارج سوريا!
وأريد هنا أن أضيف، دون ما محاولة لخديعة النفس أو تعليلها بالأمانى لقبول الأمر الواقع، أن الوحدة بين مصر وسوريا – خلال العمر القصير الذى عاشته – حققت أعمالاً باهرة – تساوى كل ما نحس به الآن من وخزات المرارة والألم.
حققت تجربة الوحدة الأولى فى عمرها القصير عدة أهداف:
– حين قامت الوحدة – أولاً – كان حلف بغداد قوياً فى المنطقة، قادراً على الضغط على شعوبها لتحطيم مقاومتها الوطنية، وإخضاعها لنفوذ الاستعمار.
كانت للقوى الاستعمارية، الطامعة فى المنطقة، قوة رئيسية – هى حلف بغداد – قادرة على الحركة المنظمة الواسعة النطاق.
ولكن قيام الوحدة ضرب القوة الرئيسية للاستعمار فى ذلك الوقت بإسقاط حلف بغداد، وبعدها تحولت هذه القوة الرئيسية المركزة إلى فلول متناثرة، لم تفقد “قوتها” ولكن فقدت “تجمعها” الرسمى الذى كان واضحاً فى بداية سنة 1958.
وصحيح أن الاستعمار الآن غيَّر أسلوبه، سواء بسبب المقاومة الوطنية لأحلافه العسكرية، أو بسبب التغيير الكبير الذى أحدثه التطور الذرى والصواريخ البعيدة المدى والعابرة للقارات التى قللت كثيراً من قيمة الاحتفاظ بقواعد عسكرية على أراضى الشعوب رغم إرادتها – إلا أن هذا لا يؤثر على الإطلاق فى قيمة النصر الشعبى الذى أحرزته الوطنية العربية ضد الاستعمار فى تلك المعركة من حربها الممتدة معه، هذا النصر الشعبى الذى كانت الوحدة بين مصر وسوريا عاملاً حاسماً فى تحقيقه وإبرازه.
– حين قامت الوحدة – ثانياً – كانت الحدود ضائعة ما بين الوطنية العربية وما بين الشيوعية، وكان سبب ذلك أن الشيوعيين حاولوا الوقوف فى الجبهة الوطنية أثناء الحرب مع الاستعمار فى المعركة الكبرى ضد الأحلاف.
ولقد بدأت المعركة الكبرى ضد الأحلاف برفض مصر – سنة 1955 – أن تنضوى تحت لواء أى حلف استعمارى، ثم امتدت إلى تأكيد الشخصية العربية المتحررة – أثناء مؤتمر باندونج – ثم واصلت اندفاعها إلى معركة كسر احتكار السلاح، ثم مضت إلى حد الاشتباك عسكريا مع الاستعمار فى معركة السويس، ثم واجهت محاولة العزل بالحرب النفسية وبأساليب الدس والمؤامرات طوال سنة 1957 – وفى ذلك كله كان الشيوعيون يقفون فى الخط الوطنى، ويساعدون فى المعركة بكل قوتهم من أجل أهدافهم بالطبع. وكانت أهدافهم فى ذلك الوقت متشابكة مع أهداف القومية العربية، مختلطة بها.
ومع أن ذلك كان وضعاً تحتمه الضرورة، إلا أن وقف هذا التسلل، وفرز العناصر الشيوعية عن الجبهة الوطنية العربية الأصيلة – كان أمراً لابد من مواجهته.
وكانت الوحدة بين مصر وسوريا هى النقطة التى تحددت عندها الخطوط، واتضحت فيها المعالم، وافترقت عليها الأهداف، يدلل على ذلك ويحدده، أن يوم إعلان الوحدة بالذات كان هو اليوم الذى فر فيه خالد بكداش رئيس الحزب الشيوعى السورى. من سوريا.
– وحين قامت الوحدة – ثالثاً – كانت الاشتراكية العربية، مجرد حلم قائم على مكارم الأخلاق يراود بعض الحالمين، وكانت الرجعية العربية متداخلة فى الصف الوطنى، وكان هذا التداخل عاملاً يعوق التوضيح الثورى لأهداف الإنسان العربى وحقوقه، ولمطالبه الحيوية فى الكفاية والعدل.
ولكن اقتراب الوحدة، جعل العناصر الرجعية تكشف عن نفسها بسرعة، فلقد كان تلاقى آمال الشعوب المناضلة، قادراً على تفجير الشرارة الثورية، التى كان يمكن على ضوئها أن يرى الإنسان العربى حقيقة الاستغلال الاجتماعى الذى يرسف فى أغلاله.
ومن هنا فليس من الصدفة – مثلاً – أن صاحب الجلالة الملك سعود دفع للعقيد عبدالحميد السراج، مليونى جنيه إسترلينى، لكى يقوم بانقلاب يحول دون إتمام الوحدة.
وأؤكد هنا – أنه ليس من هدفى أن أهاجم جلالة الملك سعود – ولكن من هدفى أن أحاول استعراض الصورة شاملة لكى تبين كاملة أمام شعوبنا التى مازالت المعركة أمامها طويلة، والتى تملك حقاً لا نزاع عليه فى الاستفادة من تجاربها.
وإذن ألخص الانتصارات الثلاثة التى حققتها تجربة الوحدة العربية الأولى فى عمرها القصير، ألخصها فى ما يلى:
1- وجهت تجربة الوحدة ضربة كبيرة إلى القوة الاستعمارية الرئيسية التى كانت تهاجم شعوبنا سنة 1958 – وهى حلف بغداد.
2- استطاعت تجربة الوحدة أن تقوم بعملية فرز كانت ضرورية، وأخرجت من الصف الوطنى العربى، ما كان قد تسرب إليه من العناصر الشيوعية.
3- أرغمت الوحدة، قوى الرجعية أن تكشف عن وجهها، وفى نفس الوقت حققت الوحدة نقطة انطلاق عملية نحو الاشتراكية بقصد تحرير الإنسان العربى من كل الاستغلال والرق الاجتماعى وبالتالى ساعدت على بلورة حركة الجماهير العربية نحو أهدافها الاجتماعية.
وهذه الانتصارات الثلاثة كلها ليست بالأمر الهين. وحدوثها فى ثلاث سنوات أقرب إلى المعجزات، وأؤكد مرة أخرى أننى لا أقول ذلك لخديعة النفس أو تعليلها بالأمانى – وإنما أحاول طاقتى أن أكون موضوعياً بقدر ما أستطيع فى تعرضى لدراسة ما حدث.
وأضيف إلى ذلك أننى لا أريد التقليل من خطورة ما حدث وأثره على الكفاح العربى.
بل لعلنى وأنا أقوله، أقوم بعملية تجسيد للخسارة العربية الكبرى التى وقعت بسبب ما حدث فى سوريا.
وأعود بعد هذه المقدمة إلى دراسة ما حدث فى سوريا.
إلى دراسة التجربة الأولى للوحدة العربية ذاتها، لتكون الدراسة لأسباب الفشل، بعد أن استعرضت آثار النصر – قوة حافزه جديدة، على أسس صحيحة ومتينة سعياً وراء نفس الأهداف.
وحتى وإن قدر لجيلنا أن لا يعيش يوم النصر الأعظم للقومية العربية، فذلك حق لابد لجيلنا الذى عاش التجربة أن يؤديه للأجيال التى سوف تحمل الأعلام المنتصرة لتضعها فوق الساريات العالية.
والآن: إلى السؤال الكبير.
– ماذا جرى فى سوريا؟
ردى، ولعلى لا أكون قد شردت بعيداً عن الصواب، أن ما حدث فى سوريا، فى سبتمبر سنة 1961، هو ما كان يمكن أن يجرى فى سوريا فى فبراير سنة 1958 – لو لم تحدث الوحدة، وتؤجل وقوعه ثلاث سنوات ونصف!
من هنا فإن عودة إلى الظروف السائدة فى سوريا، قبل الوحدة مباشرة فى فبراير سنة 1958 – أمر ضرورى لفهم هذا الاستمرار الطبيعى للظروف، هذا الاستمرار الذى استؤنف مرة أخرى فى سبتمبر 1961 – ثم لفهم العوامل الجديدة التى طرأت على الموقف خلال سنوات الوحدة، والتى لابد أن يكون لها تأثيرها فى اتجاه الحوادث المقبل!
ماذا كانت الظروف السائدة فى سوريا، قبل الوحدة مباشرة؟
إذا لم أكن قد نسيت بعد أيامى فى سوريا، ولقد كنت زائراً دائماً لها أثناء خمس سنوات من عمرى قضيتها كمراسل سياسى متجول فى الشرق الأوسط، من سنة 1946 إلى سنة 1951 – وبعدها حاولت جاهداً أن أحتفظ بعلاقاتى بالمنطقة ومتابعتى لأحداثها – فلقد كانت معالم الصورة كما يلى:
1- كانت سوريا تحت حكم الجيش، بوصفه جيشاً، منذ اليوم الذى وقع فيه انقلاب حسنى الزعيم فى فبراير سنة 1949.
ولم تكن هناك قوى اجتماعية وراء انقلاب حسنى الزعيم، وإنما كانت هناك مصالح مالية، فى مقدمتها شركات البترول الأمريكية التى كانت تريد فى ذلك الوقت أن تمد أنابيب البترول – التابلاين – عبر سوريا، وكانت حكومة شكرى القوتلى لم تصل بعد إلى قرار فى ذلك الشأن، وكانت صلة رجال المخابرات الأمريكية بحسنى الزعيم معروفة، وكان بين بريطانيا وأمريكا فى ذلك الوقت نزاع على مغانم البترول فى الشرق الأوسط – بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية – لم يصل بعد إلى تفاهم ودى!
ولم تكن تلك – للإنصاف – هى كل محركات انقلاب حسنى الزعيم، وإنما كان هنا أيضاً رد الفعل العاطفى لهزيمة فلسطين قبلها بشهور قليلة.
وتخبط حسنى الزعيم، ثم جعل من نفسه صورة مهزوزة لموسولينى وارتدى بذلة الماريشالية وغطى صدره بالأوسمة ودار رأسه بجنون العظمة. كل ذلك دون فكر اجتماعى أو مثل أعلى.
ولم تكد تمضى أربعة شهور، حتى كان انقلاب جديد على هذا الانقلاب.
وكان قائد الانقلاب هذه المرة هو سامى الحناوى.
وكان حلف، الملك فاروق، والملك عبدالعزيز آل سعود، هو الذى يحتضن حسنى الزعيم.
وكان انقلاب سامى الحناوى رد فعل بالتآمر البحت لهذا الوضع، فقد كانت القوة المحركة له هى الأسرة الهاشمية فى بغداد.
ومضت شهور ثم انقلاب ثالث، على الانقلاب الثانى، يقوده هذه المرة أديب الشيشكلى.
تم تعددت الانقلابات فى سوريا. بعضها كانت انقلابات ناطقة ملونة.
أقصد أنه بعضها كانت له فرقعة وبعضها صبغه الدم.
وبعضها الآخر كان انقلابات صامته تمزق الوطن السورى فى سكون، وتذبح فيه أحياناً من غير دم.
وفى ذلك كله كان الجيش هو الذى يحكم.
أحياناً كان يظهر من فوق المسرح، كما حدث أيام حسنى الزعيم وأديب الشيشكلى.
وفى أحيان أخرى كان يحرك المسرح كله من داخل الثكنات – كما تجلى بوضوح فى الفترة التى انقضت منذ الانقلاب على أديب الشيشكلى إلى يوم الوحدة.
فى ذلك الوقت كانت مجموعة الضباط التى قادت الانقلاب على أديب الشيشكلى قابعة فى قيادات الجيش، وكانت الحكومة المدنية التى تتولى الأمر فى قصر المهاجرين فى دمشق، ألعوبة فى يد هذه المجموعة من الضباط القابعين فى الثكنات.
كان الرأى فى سوريا رأيهم. والأمر أمرهم. والقدر فى أيديهم يجرونه كما يشاءون، ولم يكن على الواجهات المدنية التى تتولى الحكم بالاسم إلا أن تخضع للرأى والأمر. والقدر!
ووصلت الأمور إلى حد أنه لم يكن يجوز فى سوريا أن يرسب ابن أو ابنة لأحد الضباط فى الامتحان فى أى مدرسة وإلا فإن الأب الضابط سوف يذهب إلى ناظر المدرسة أو ناظرتها ويقرر تحويل الرسوب إلى نجاح ومسدسه معلق من حزام وسطه!
إلى هذا الحد!
وفى ذلك الوقت كانت فى سوريا مجموعة من الأحزاب:
1- حزب البعث العربى الاشتراكى: وكان هذا الحزب خليطاً مشوشاً من شخصيات قادته، خليطاً مشوشاً من أفكار تقدمية على أساس نظرى لميشيل عفلق، ومن غرام بالمناورات السياسية والألاعيب الحزبية لأكرم الحورانى ومن حيرة تائهة شاردة لا تستقر على شىء لصلاح البيطار.
ولكن الحزب برغم ذلك كله كان قوة متحركة فى اتجاه تقدمى غير واضح المعالم.
2- حزب الشعب: الذى يرأسه رشدى الكيخيا، وكان هذا الحزب يضم معظم أسر سوريا الكبيرة من ملاك الأرض، وكان قوة فعلية ولكنه كان بعيداً عن أى تأثير جماهيرى، بل كان فى طبيعته لا يؤمن بالجماهير.
3- الحزب الشيوعى: وكان هذا الحزب تحت رياسة خالد بكداش أقوى المنظمات الشيوعية فى الشرق العربى، وكان حزباً نشيطاً يستمد التزايد فى قوته من ضعف الآخرين وتفككهم.
4- الشركة الخماسية: ولم تكن الشركة الخماسية حزباً، ولكن الشركة الخماسية كانت قمة الاحتكار فى سوريا وكرأس المال بطبيعته، كان همها أن تكون هناك حكومة قوية تصد الشيوعيين فقط، وتحفظ النظام ولو بالقمع، ليستطيع رأس المال آمنا أن يحصل على ما يريد بغير حساب، ولهذا لم تكن الشركة الخماسية فى سوريا بعيدة عن السياسة، وإن لم تكن تنظيماً حزبياً بطبيعة الحال.
وكانت هناك قوى من خارج سوريا، تلعب فى سوريا وفق هواها أو وفق مصالحها.
1- بغداد كانت لها مصالح فى دمشق وكانت لها أحلام.
كانت بغداد تريد دمشق داخل حلف بغداد تأميناً لجناحها الغربى، وفتحاً للطريق أمام هذا الحلف الاستعمارى أن يبسط نفوذه على الأردن وعلى لبنان بعد سوريا!
ثم كان لبغداد فى دمشق حلم قديم هو أن يعود عرشها إلى الأسرة الهاشمية الحاكمة فى بغداد، والتى كان لها الحكم يوما فى سوريا وأن يجلس عليه الأمير عبدالإله بالذات.
2- وفى وجه مصالح بغداد وأحلامها كانت الرياض – عاصمة الحكم السعودى – تقف بحوافز المنطق القبلى الإقطاعى ضد بغداد.
وكانت الرياض تدفع فى دمشق من غير حساب.
ووصل الأمر – ومازلت أذكر الواقعة وقد نشرتها فى ذلك الحين – إلى حد أن أى ضابط جيش فى سوريا كان يستطيع لو أراد أن يحصل على سيارة من آخر طراز إذا ما غمز بنصف عين إلى سفارة المملكة السعودية فى دمشق!
3- وكانت مصر بعد ثورة سنة 1952، وبعد أن اكتشفت شخصيتها العربية، وانحازت بكل قواها إلى جانب النضال الشعبى العربى، تهتم بأمور سوريا، وفى الدرجة الأولى من اهتمامها أن لا تسقط تحت سيطرة حلف بغداد وبذلك يتحول مجرى النضال العربى كله، من محاولة الحصول على القوة الذاتية العربية المستقلة، ومن محاولة صد الخطر الإسرائيلى من المنطقة تمهيداً لاستئصاله!
4- ولم تكن الدول الكبرى كلها بمعزل عن هذا الصراع الذى يشمل الشرق الأوسط كله، والذى كانت سوريا قد تحولت إلى مركز له وميدان.
كانت بريطانيا وراء بغداد. أو وراء حلف بغداد.
وكانت أمريكا موزعة المشاعر بين مصالحها فى الرياض وبين إحساسها – من وجهة نظرها – بضرورة حلف بغداد استمراراً فى تطويق الاتحاد السوفيتى بالقواعد.
وكان الاتحاد السوفيتى، يؤيد مصر فى معركة مقاومة حلف بغداد، وفى نفس الوقت كان يساند الحزب الشيوعى السورى باعتباره نواة التقدم الشيوعية فى الشرق العربى.
وبما أن الجيش كان هو القوة المسيطرة والحاكمة، فإن كل الأحزاب العاملة فى سوريا، وكل القوى العربية والدولية المهتمة بالمعركة الدائرة فيها، اتجهت جميعها إلى العمل فى الجيش وإلى محاولة التأثير فيه.
وأصبح الجيش السورى انعكاساً طبيعياً للصراع الحزبى، والعربى، والدولى الجارى من حول سوريا وفى داخلها.
أصبح هناك ضباط فى الجيش يتجهون بمشاعرهم لحزب البعث وآخرون يتجهون لحزب الشعب وآخرون للحزب الشيوعى وآخرون للشركة الخماسية وآخرون يقلقهم هذا الصراع داخل وطنهم وعليه ويبحثون عن طريق فيه السلامة الوطنية والأمان.
وأصبح هناك ضباط على اتصال ببغداد وبالرياض، وبالقاهرة.
ووصلت الفرقة إلى حد بعيد. وإلى حد عميق.
ومن نتائج هذه الفرقة:
1- أن التوجس بين جماعات ضباط الجيش السورى المتنافرة أصبح عاملاً بالغ الخطر على مستقبل الوطن السورى كله، ووصل الأمر إلى أن الضباط الذين كانوا يتصدرون الجيش كانوا يقضون الليل فى وحداتهم ليكونوا على أهبة التحرك بها فى مواجهة أى مباغتة من جماعة أخرى.
2- أن بعد الفرقة وعمقها أدى إلى شبه شلل بين القوى المتنافرة فإن واحدة منها لم تستطع أن تحقق السيطرة التى تملك بها أن تفرض إرادتها النهائية على الآخرين، وبذلك أصبحت سوريا تمشى على سلك مشدود على حافتى هاوية وكان عليها أن تحافظ على توازنها فوقه لكى لا تضيع. وكانت نسمة هواء قوية من أى اتجاه كفيلة بأن تحدث الخلل فى التوازن. ومن ثم يكون الضياع.
وفى ذلك الوقت العصيب فى سوريا برز اسمان:
– اللواء عفيف البزرى، قائد الجيش السورى، ولم يكن هناك مجال للشك فى أنه بماضيه، وبفكره، يتصل على نحو أو آخر بالشيوعية.
– العقيد عبدالحميد السراج، مدير المكتب الثانى السورى، أى مدير المخابرات، ومع أن عبدالحميد السراج فى تقديرى شاب وطنى عربى متحمس، إلا أنه سواء بحكم طبيعة عمله، أو بحكم الميزان الدقيق للقوى فى سوريا، بحكم المشى على السلك المشدود بين حافتى هاوية، وجد نفسه فى وضع يجعله يراقب كل شىء فى سوريا. لم يكن ينام، ولم يكن يغفل، وكان يقال إنه يسمع دبيب النملة إذا دبت فى سوريا!
وأين كان الشعب السورى وسط ذلك كله؟
الفئات الطافية على السطح منه، قنعت بالسلبية طريقاً لراحة البال.
وراحت تجلس فى نادى الشرق فى دمشق، تتهامس بأخبار آخر المناورات وأحدث الإشاعات.
وراحت تتردد كل مساء على مقاهى “دمر” تشد دخان “الأرجيلة”، وتتندر بحكايات أقرب ما تكون إلى التعبير السورى المشهور “طق الحنك” أى الكلام الطائر فى الهواء، لا يقدم ولا يؤخر!
أو راحت تجرى كل عصر عبر الحدود إلى لبنان، بعضها يتوقف فى “شتورة” قرب الحدود، ليأكل الفراريج – الدجاج – المشوية ومعها تحتسى العرق، وبعده “الأرجيلة” وخلال ذلك كله يجرى الحديث مع الهوى. وبعضها يكمل الطريق إلى بيروت يسهر الليالى بعيداً عن تزمت دمشق، ويناقش السياسة فى علب الليل الصاخبة!
هذا حال الفئات الطافية على السطح فى المجتمع السورى.
والقاعدة، القاعدة الشعبية الواسعة. الجماهير السورية العربية المؤمنة.
كانت هذه الجماهير دائماً طليعة وحدة عربية.
كانت هذه الجماهير دائماً سليمة فى إخلاصها لشعاراتها.
وكان ظهور شخصية جمال عبدالناصر فى مصر تجسيداً للأمل العربى، فى أحلام هذه الجماهير، بأن يخرج يوما من بين صفوفها واحد يرفع العلم العربى، ويتصدى لكل أعداء العرب، ويقف فى وجههم صامداً قوياً لا يُقهر ولا يُنال.
فى ذلك الوقت كان جمال عبدالناصر قد بدأ يبرز على المسرح العربى مستكملاً كل يوم مقومات شخصية البطل.
وقف ضد حلف بغداد. ضد كل قوى الاستعمار فى المنطقة.
كسر احتكار السلاح لتستطيع الأمة العربية أن تملك فى يدها ما تدافع به ضد عدوها.
اعترف بالصين الشعبية لم يرهبه تهديد دالاس ولا وعيده.
أمم قناة السويس وصفع رئيس وزراء بريطانيا أنتونى إيدن على الخدين، أمام الشعوب العربية المبهورة، وأمام شعوب آسيا وأفريقيا التى حبست أنفاسها من الروع.
انتصر فى معركة السويس وحقق ملكية مصر للقناة نهائياً وإلى الأبد.
أسقط انتونى إيدن، ولأول مرة وقع رئيس وزراء دولة كبرى، هى بريطانيا بالذات، صريعاً فى معركة أمام مواطن عربى.
أسقط جى موليه رئيس وزراء فرنسا.
رفض مشروع أيزنهاور الذى كان هدفه عزل مصر عن العالم العربى كله.
ثم بدأ يتحدث عن إعادة بناء الوطن.
بدأ يتحدث عن التصنيع. عن التطوير. عن الاشتراكية.
هنا أحست الأمة العربية كلها، والشعب السورى فيها بالذات، لأنه فى قلبها، أن العرب لم يعودوا أمة لا هَّم لها غير أن تجتر أمجاد الماضى، وإنما هى قادرة على تشكيل التاريخ.
لم تعد تبكى على أطلال سد مأرب فى اليمن وتتحسر على حضارة قديمة، وإنما هى تحلم بمشروعات كبرى كالسد العالى وتتطلع إلى مستقبل عظيم.
لم تعد الأمة المقهورة. وإنما أصبحت الأمة القاهرة.
لم تعد الشعوب المغلوبة على أمرها. وإنما أصبحت الشعوب الغالبة.
لقد ظهرت شخصية البطل، التى كانت الجماهير العربية تنتظر ظهورها لتمشى وراءها.
وبدأ اتجاه الوحدة – من هذا كله – يتبلور فى سوريا. ويتطلع إلى مصر.
ومع هذا كله كانت العوامل التى شرحتها جميعاً تساهم فى بلورة هذا الاتجاه وفى تحديد معالمه.
– الفرقة فى الداخل، فى وسط الأحزاب وفى وسط الجيش. والتوجس والخوف.
– ضغط الاستعمار من الخارج ممثلاً فى حلف بغداد وفى مؤامراته المسلحة وغير المسلحة.
– تسلل الشيوعيين إلى الداخل لتحويل مجرى النضال العربى ومحاولاتهم أن يسلبوا الجماهير عزتها وشعورها الوليد بالحرية الحقيقية.
وفى مطلع سنة 1958، كانت الجماهير السورية كلها تردد بصوت واحد كالرعد هتافها التاريخى، الذى يحمل كل المشاعر الفوارة التى فجرها ظهور شخصية البطل:
– عبدالناصر يا جبار. يا محطم الاستعمار.
وبدأت أصداء هذا الهدير الشعبى الجماهيرى تصل إلى كل مكان داخل سوريا. إلى دور الأحزاب المتصارعة. إلى ثكنات الجيش الخائفة المتربصة. إلى الجالسين منهمكين فى “طق الحنك” فى نادى الشرق، وفى مقاهى دمر، وإلى المتحدثين بالسياسة فى علب الليل فى بيروت.
وبدأت الأصداء تسمع فى العواصم العربية المشتركة فى الصراع داخل سوريا وعلى سوريا. فى بغداد وعمان وفى الرياض ثم وصلت الأصداء إلى لندن. إلى باريس. إلى واشنطن. إلى تل أبيب.
وأتوقف هنا قليلاً. حتى الأسبوع القادم!
أستريح لحظة قبل أن أستأنف الحديث.
حديث التجربة. وحديث المستقبل!.
بصراحة بقلم محمد حسنين هيكل: (3) ما الذى جرى فى سوريا؟ من المسئول عن إتمام الوحدة بين مصر وسوريا؟
من حيث تركنا الحديث فى موضوع “الذى جرى فى سوريا”، نعود إليه.
ولكن قبل استئناف الحديث، لابد من ملاحظة سريعة وعابرة، أو هى تعليق للحقيقة والتاريخ، على ما أعلنته سلطات دمشق الحاكمة الآن، من أنها سوف تحاكم كل السياسيين الذين شاركوا فى صنع الوحدة بين مصر وسوريا سنة 1958.
والملاحظة الصادقة للحقيقة والتاريخ، هى أن كل السياسيين السوريين الذين تصدروا عملية إتمام الوحدة بين مصر وسوريا، أبرياء من المسئولية، لا ذنب لهم فيها، ولا مؤاخذة عليهم فى كل ما حدث.
إنهم لم يقودوا الوحدة. وإنما الحقيقة والتاريخ أنهم انقادوا لها.
إنهم لم يصنعوا ذلك التيار الشعبى السورى الذى حقق تجربة الوحدة الأولى، وإنما هذا التيار الشعبى السورى، هو الذى صنعهم.
إنهم لم يحركوا التاريخ. وإنما التاريخ حركهم.
إنهم لم يقرروا الشكل النهائى لما وقع فى فبراير سنة 1958. ولكن هذا الشكل النهائى فرض عليهم فرضاً!
إنما المسئولية كلها تتحملها الجماهير السورية، فهى وحدها التى قادت، وهى وحدها التى صنعت، وهى وحدها التى حركت، وهى وحدها التى قررت، وهى وحدها التى فرضت!
ومن ثم فإن السياسيين السوريين جميعاً، أو المشتغلين بالسياسة فى ذلك الوقت من سنة 1958، كلهم أبرياء، وكلهم لا ذنب لهم، ولا مؤاخذة عليهم.
الجماهير السورية وحدها هى المسئولة.
والجماهير السورية وحدها هى التى تدفع الحساب.
وإنى لأعلم، مما يصل إلى – مما يجرى الآن – فى سوريا أنها تدفعه. وتدفعه غالياً.
تدفعه بدم مئات القتلى – ولست أقول عدد المئات جزافاً – وإنما أقوله ويعلم الله أننى أتعمد التهوين والتباعد عن المبالغة.
وتدفعه بالمكاسب الشعبية الضائعة، أرضاً ينقض عليها الإقطاع، واحتكارات يستردها أصحاب الملايين، وامتيازات تستعيدها الطبقة المسيطرة، والقلة الحاكمة، أما الجماهير فلا يترك لها غير العرق والدم والدموع، على حد تعبير تشرشل المشهور!
وإذن فالسياسيون، أو المشتغلون بالسياسة – بحق الله – أبرياء، وحرام أن يدخل واحد منهم إلى السجن!
أما الجماهير السورية، صاحبة المسئولية الأولى والأخيرة فى كل ما حدث، فلقد دخلت السجن على أى حال، ووُقعت عليها أقصى العقوبات.
والعزاء – فى كل النكسة الأخيرة – أن الشعوب لا تبقى فى السجون طويلاً.
وإنما الشعوب، جماهير الشعوب، سوف تكون لها دائماً: الكلمة الأخيرة.
ولكن ذلك حديث آخر.
وأعود إلى ما كنت فيه.
لماذا حاولت أن أدلى بشهادتى، تبرئة لكل السياسيين السوريين الذين كانوا فى سوريا فى مطلع عام 1958؟
والرد.
– لأن تلك هى أمانة الحقيقة والتاريخ، مادمت قد عرضت نفسى لدراسة التجربة وألزمت نفسى بمواجهة كل ما حدث. كما حدث فعلاً!
ولقد رويت فى الحديث السابق كيف كان الجو فى سوريا فى مطلع سنة 1958.
رويت حكاية الجيش السورى وانقلاباته المتوالية، ثم الفرقة التى أصبحت تمزقه.
رويت حكاية الأحزاب السورية وما كان بينها جميعاً من تنافر وصراع.
رويت حكاية ضغط حلف بغداد الاستعمارى على حدود سوريا، وتسلل الحزب الشيوعى فى أعماق سوريا.
ثم انتهيت إلى حكاية الجماهير السورية التى ضاقت بذلك كله، وفى نفس الوقت شدتها إلى القاهرة، أحلامها القديمة بالوحدة، وأحلامها الجديدة المتطلعة إلى “شخصية البطل”، التى كانت فى ذلك الوقت قد استكملت ملامحها، بكل ما أحرزه جمال عبدالناصر للنضال العربى من انتصارات.
ولقد كان آخر جملة قلتها فى الحديث السابق هى:
وفى مطلع سنة 1958، كانت الجماهير السورية كلها تردد بصوت واحد كالرعد، هتافها التاريخى، الذى يحمل كل المشاعر الفوارة التى فجرها ظهور شخصية البطل:
– عبدالناصر يا جبار. يا محطم الاستعمار.
“وبدأت أصداء هذا الهدير الشعبى الجماهيرى، تصل إلى كل مكان داخل سوريا. إلى دور الأحزاب المتصارعة إلى ثكنات الجيش الخائفة المتربصة، إلى الجالسين منهمكين فى – طق الحنك – فى نادى الشرق، وفى مقاهى دمر، وإلى المتحدثين بالسياسة فى علب الليل فى بيروت.
وبدأت الأصداء تسمع فى العواصم العربية، المشتركة فى الصراع داخل سوريا وعلى سوريا، فى بغداد وعمان وفى الرياض، ثم وصلت الأصداء إلى لندن، إلى باريس، إلى واشنطن، إلى تل أبيب”.
كان هذا آخر ما توقفت عنده فى الحديث السابق. فكيف تطورت الحوادث بعدها؟
أخذ الجيش زمام المبادرة، وكان ذلك هو الطبيعى، فإن ضباط الجيش بكتله المتصارعة كانوا فى ذلك الوقت هم القوة الحقيقية وراء الواجهة المدنية، الهزيلة الضعيفة، فى سوريا تلك الأيام. ويكاد القلم يسبقنى هذه الثانية ويضيف: وهذه الأيام أيضاً!
ولكنى أرد القلم عن جموحه، لأعود به إلى تسلسل القصة، فإن الماضى وتفاصيله مفتاح أساسى للحاضر وتفاصيله.
فى ذلك الوقت، اجتمع قادة الكتل المتصارعة فى الجيش، فى شبه هدنة مؤقتة بينهم، ثم تناقشوا فى أوضاع سوريا، ثم استقر قرارهم:
“على أن لا حل ولا أمل فى سوريا، إلا بوحدة مع مصر”.
– تستجيب أولاً لنداء الجماهير.
– ثم تنتهى ثانياً لعبة الحبل المشدود على حافتى الهاوية الذى كانت تسير عليه سوريا بحكم الحالة التى تردَّت إليها أمورها.
وكانوا فى ذلك الوقت 22 ضابطاً يمثلون 22 كتلة فى الجيش السورى.
ووافقوا جميعاً على ذلك الحل برغم ما كان فى خواطر كل منهم.
كان أحدهم – مثلاً – وهو أمين النفورى يحلم بانقلاب تقوم به مجموعة الضباط “الشوام” كما يسمونهم. أى ضباط دمشق، وكانت هناك عناصر فى بغداد تحمسه وتدفعه، ولكنه لم يكن واثقاً من النجاح.
وكان أحدهم – مثلاً – وهو عفيف البزرى، يعيش بكل أحلامه مع الشيوعية، ولكن الطريق أمامه لم يكن واضحاً لعمل محدد يستطيع بعده أن يرفع الراية الحمراء فوق دمشق، هو أيضاً لم يكن واثقاً من النجاح.
وكان أحدهم – مثلاً – وهو عبدالحميد السراج، لغزاً غريباً، يكتم فى داخل نفسه أكثر مما يظهر للناس، ويريد أن يعرف كل شىء ويمسك بأصابعه كل خيط، وكان فى قلبه صراع عنيف، بين المثل الوطنى الأعلى وبين الرغبة فى السلطة والسلطان والرهبة، وكان من غير شك – يريد الوحدة. وكان فى نفس الوقت – ومن غير شك أيضاً – يريد سوريا ولكن كيف السبيل؟
هذه مجرد نماذج. لمسات خفيفة من ضوء على جوانب الصورة.
هكذا، بالخوف، وبالحيرة، وبالشك، وبالأمل، وبالطموح، اتفقت كلمتهم جميعاً – 22 ضابطاً يمثلون 22 كتلة فى الجيش السورى – على أن الوحدة هى الحل وهى المخرج.
وركبوا جميعاً طائرة جاءوا بها إلى القاهرة، إلا واحداً منهم – هو عبدالحميد السراج – تركوه وراءهم فى دمشق ليمسك بزمام الأمور فى غيبتهم ويحفظ الميزان الدقيق المشدود على سلك بين حافتى الهاوية – ريثما يعودون إليه.
وصلوا إلى القاهرة يوم 14 يناير 1958 على وجه التحديد.
وطلبوا أن يقابلوا الرئيس جمال عبدالناصر، ولكنه يومها لم يكن فى القاهرة، بل كان فى الأقصر مع ضيفه فى ذلك الوقت الدكتور أحمد سوكارنو رئيس جمهورية أندونيسيا.
ولست الآن أكتب اعتماداً على الذاكرة وحدها. وإنما أمامى من أوراقى القديمة صفحات من مذكرات أحتفظ فيها أحياناً ببعض الذى أراه وأسمعه.
فى يوم 14 يناير قابلهم المشير عبدالحكيم عامر القائد العام للقوات المسلحة، والقائد العام للقيادة المشتركة التى كانت تضم الجيش المصرى والجيش السورى فى ذلك الوقت.
وكان يعرفهم جميعاً. وكانوا يعرفونه جميعاً.
وتكلموا معه بما جاءوا من أجله.
وليلتها اتصل المشير عبدالحكيم عامر بالرئيس جمال عبدالناصر فى الأقصر، وكان رأى جمال عبدالناصر: أنه على أى حال سوف يعود فى الغد إلى القاهرة وسوف يجتمع بهم ليسمع ما عندهم.
وباتوا ليلتهم فى قصر الضيافة، فى قصر الطاهرة. أقول باتوا ولا أقول ناموا، لأنه فى تلك الليلة لم ينم منهم أحد، وإنما ظلوا هناك إلى الصباح ساهرين يتحدثون، ويتناقشون، وينتظرون الطائرة العائدة من الأقصر ليجتمعوا بعبدالناصر فى المساء، فى بيته.
وفى الساعة الثامنة مساءً خرجت بهم قافلة سيارات حملتهم من قصر الطاهرة إلى بيت الرئيس جمال عبدالناصر فى منشية البكرى.
ثم كان اجتماع، سيظل – مهما كان ومهما سوف يكون – من أهم صفحات التاريخ العربى المعاصر.
وتحدثوا جميعاً فيما جاءوا من أجله. وساقوا له المبررات.
وصفوا حالة الفرقة بينهم، وصفوا حالة “الاستنفار” – الطوارئ – الدائمة فى الثكنات لأن كلا منهم يتوجس من الآخر.
وصفوا حالة سوريا الضائعة بين أحزابها. وبين ضغط حلف بغداد عليها فى الداخل والخارج وبين تسلل الشيوعيين إلى الأعصاب الحساسة للوطن السورى.
تحدثوا عن أسلحة حلف بغداد التى يجرى تهريبها عبر الحدود وعن مخططاته للسيطرة على سوريا.
تحدثوا عن نشاط خالد بكداش وعن حى الأكراد الذى حّوله فى دمشق إلى قلعة مسلحة لا يجسر على الاقتراب منها غريب.
تحدثوا عن الشخصيات السورية السياسية المتهالكة، بعضهم يمد يده للرياض استجداء لمالها الذى لا ضابط له ولا حساب، وبعضهم ترك جيوبه لبغداد تحشوها له بما تقدر عليه بغداد من فيض الخير والرزق.
وقال جمال عبدالناصر:
– هذا كله لا يبرر قيام وحدة، تلك كلها أسباب سلبية، سوف تكون عبئاً على الوحدة أكثر ما تكون قوة دافعة لها.
قالوا:
– لكن الشعب فى سوريا كله يطلب الوحدة. إن الوحدة مطلبه الدائم. والوحدة مع مصر بالذات هى التيار الكاسح فى سوريا كلها الآن.
والناس فى سوريا يحسون أنهم يقبلون وأن مصر تصدهم!
ومجلس النواب السورى اتخذ قراراً بالوحدة مع مصر، ولكن مجلس الأمة المصرى لم يستجب. وظل أسابيع طويلة بين التردد والإحجام، ولا يجيب على الإشارة الموجهة إليه من المجلس النيابى السورى. وإن هذا وضع يجرح الشعور الشعبى فى سوريا.
وقال عبدالناصر:
– إن الوحدة ليست بالعمل السهل. لقد بدأنا الآن – بالكاد – بعد معارك عنيفة مع الاستعمار نوجه كل طاقتنا لبناء مصر، وأملى فى بناء مصر هو أن تكون قاعدة قوية، من الناحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لنضال باقى الشعوب العربية.
إن أملى أن نجعل مصر نموذجاً للعمل الوطنى. وبرغم ما فى ذلك من مشقة فإن هذا هو طريقنا الوحيد، ليس للتطوير فقط، ولكن للوحدة أيضاً.
إنى أريد أن نجعل مصر البلد النواة للتطوير العربى، ولسوف يكون لذلك كله أثره فى تدعيم الدعوة إلى الوحدة عملياً وواقعياً وإيجابياً.
وقالوا له:
– تريد أن تعمل ذلك لمصر. وتترك سوريا التى علقت آمالها على مصر وعليك. أنت بذلك تتخلى عن دعوة القومية العربية كلها من أجل مصر وحدها.
وابتسم جمال عبدالناصر.
وتطلعوا إليه جميعاً.
وقال لهم على الفور:
– إننى أريد أن أتكلم معكم بوضوح. وأنا أعرفكم جميعاً وأعرف حسن مقاصدكم ولكنى أريد أن أسألكم سؤالاً واحداً:
– “ما هى صفتكم فى الحديث معى عن هذا الأمر، وأنتم غير مسئولين؟”.
واستطرد جمال عبدالناصر:
– هل يعرف شكرى القوتلى أنكم هنا تتحدثون معى فى ذلك كله؟
قال أحدهم:
– شكرى القوتلى سوف نبعث له بأمين النفورى يحمل إليه رأى الجيش، وليس أمامه إلا أن يقبل، إنه لا يقدر أن يعارض على الإطلاق أى شىء نطلبه!
وقال جمال عبدالناصر، وأكاد أضيف، قال بالحرف الواحد، فالكلمة عندى مكتوبة، كما سمعتها فى اليوم التالى من أحد الضباط السوريين الذين حضروا الاجتماع.
قال جمال عبدالناصر:
– متأسف. لا أستطيع أن أقبل هذه الأوضاع!
أنا أعرف أنكم تمسكون فى أيديكم بزمام القوة الحقيقية فى سوريا.
ولكنى من ناحيتى لا أقبل فى مثل هذه الأمور أن أتحدث وأن أبحث إلا مع حكومة مسئولة.
وساد الصمت لحظة.
وقال أحدهم:
– هل تعطينا وقتاً نتصل بالحكومة. سوف نبعث – إذا وافقت – برسول منا بالطائرة غداً إلى الحكومة يعرض عليها الموقف ويستطلع رأيها، وسنبقى نحن هنا حتى يعود الرسول برأى الحكومة الرسمى. ولا نريد أن نمشى من هنا إلا ونحن نعرف إلى أين قرارك بالتحديد.
وفى اليوم التالى، فى الفجر، قامت طائرة تحمل أحدهم إلى دمشق، وفى العصر عادت الطائرة إلى القاهرة، فيها راكب الفجر، ورفيق آخر معه هو صلاح البيطار وزير الخارجية السورية فى ذلك الوقت ممثلاً رسمياً للحكومة.
ليلتها – 16 يناير 1958 – كان السيد عبداللطيف البغدادى رئيس مجلس الأمة فى ذلك الوقت، يحتفل بذكرى إصدار دستور 16 يناير، وكانت مأدبة عشاء فى مبنى مجلس الأمة.
وذهب الضباط الاثنان والعشرون. ومعهم وزير الخارجية صلاح البيطار إلى مأدبة العشاء فى مجلس الأمة. وكان وجودهم هناك جميعاً، ومعهم بعض أعضاء مجلس النواب السورى. وصلاح البيطار. مظاهرة فى طلب الوحدة.
واقترب صلاح البيطار من الرئيس جمال عبدالناصر الذى كان يحضر العشاء وقال له:
– لقد جئت ممثلاً للحكومة السورية.
وانتهى العشاء. وعاد الرئيس جمال عبدالناصر إلى بيته.
وذهبوا جميعاً وراءه، 22 ضابطاً يمثلون كتل الجيش السورى المختلفة. الحاكمة، وصلاح البيطار يمثل الحكومة السورية الرسمية. التى لم تكن تحكم!
وعند منتصف الليل. فى الدقيقة الأولى من يوم 17 يناير 1958. كانوا جميعاً فى بيت الرئيس جمال عبدالناصر الذى جلس أمامهم وبجواره المشير عبدالحكيم عامر.
وتكلم صلاح البيطار. وزير الخارجية.
قال:
– إن الحكومة السورية موافقة على إتمام الوحدة بين مصر وسوريا.
بل إن الحكومة ترحب بذلك، كمطلب شعبى، وكطريق لاستقرار سوريا.
وقفز الباقون جميعاً وراء كلمات صلاح البيطار، يطلبون الوحدة، ويلحون فى طلبها.
ومضت محاولة الإقناع ساعات.
وقال جمال عبدالناصر:
– إننى مستعد لقبول المبدأ ولكن على أساس ثلاثة شروط.
إننى أقبل المبدأ تحقيقاً لمطلب الشعب السورى، ولكى لا تضيع سوريا.
ولكن شروطى الثلاثة هى:
أولاً – أن يتم استفتاء شعبى على الوحدة، ليقول الشعب فى سوريا وليقول الشعب فى مصر رأيه الحر فى التجربة ويعبر عن إرادته.
ثانياً – أن يتوقف النشاط الحزبى فى سوريا توقفاً كاملاً، وأن تقوم الأحزاب السورية بحل نفسها.
ثالثاً – أن يتوقف تدخل الجيش فى السياسة تدخلاً تاماً، وأن ينصرف ضباطه إلى أعمالهم العسكرية، ليصبح الجيش أداة دفاع وقتال، وليس أداة سلطة فى الداخل وسيطرة.
وسكتوا جميعاً.
واستطرد جمال عبدالناصر:
– إننى أعلم أنكم جميعاً سوف توافقون على شرط الاستفتاء الشعبى.
ولكن باقى الشروط لها أهميتها فى تقديرى.
إن صلاح البيطار هنا، وصلاح البيطار ممثل لحزب البعث وهو من أكبر الأحزاب السورية، فهل حزب البعث على استعداد لأن يحل نفسه ويوقف نشاطه الحزبى؟
ثم، من ناحية أخرى، أنتم هنا جميعاً 22 ضابطاً تمثلون كتلاً مختلفة فى الجيش أقرب إلى الأحزاب السياسية منها إلى الوحدات العسكرية فهل تقبلون الابتعاد عن السياسة؟
إن هذا الذى أقوله لكم فعلته فى مصر. حتى مع الذين خرجوا معى ليلة 23 يوليو ليقوموا بالثورة.
لقد قلت لهم جميعاً يومها، إنهم باشتراكهم فى الثورة قاموا بعمل سياسى، وهو عمل سياسى وطنى فى تقديرى، ولكنهم بعده لم يعودوا صالحين لنظم الجيش وتقاليده ولضرورة تسلسل القيادة فيه لتبقى له كفايته المقاتلة.
إن الذين كانوا معى فى اللجنة التأسيسية لحركة الضباط الأحرار خرجوا معى من الجيش وأصبحوا وزراء سياسيين.
والذين شاركوا فى عملية الثورة طلبت منهم – اعتماداً على وطنيتهم – أن يبتعدوا عن الجيش وأن يبدءوا وجوداً جديداً فى الحياة المدنية.
فهل أنتم على استعداد لذلك؟
وقال صلاح البيطار:
– إنه لابد أن نعود فى هذا الشأن إلى قيادة حزب البعث.
وقال الضباط الاثنان والعشرون:
– نحن نفعل ما تأمرنا به.
إن أردتنا فى الجيش بقينا، وإن أردت أحداً منا فى أى منصب مدنى سياسى فلسوف يطيع الأمر.
وقال جمال عبدالناصر:
– لقد أوشك الصبح أن يطلع، فاذهبوا الآن وفكروا.
فكروا بين أنفسكم. ابحثوا الأمر كما يحلو لكم. وخذوا وقتكم فى بحثه.
وخرجوا من بيته إلى قصر الطاهرة ومعهم صلاح البيطار.
لم يناموا دقيقة واحدة فى ليلتهم الثالثة فى القاهرة وإنما جلسوا يتحدثون. ويتناقشون وأكثر من ذلك يتصايحون بالحدة والعصبية!
وكان واضحاً أن الشرطين الأخيرين لجمال عبدالناصر لمساً الأوتار الحساسة فى الحياة السياسية السورية بالطريقة التى كانت تجرى عليها.
لم يكن الاستفتاء الشعبى موضوع سؤال فقد كان التيار الشعبى واضحاً كاسحاً.
ولكن الأحزاب السورية. هل تقبل أن تحل نفسها؟
وضباط الكتل فى الجيش السورى. هل يتنازلون طواعية عن سلطانهم القوى؟
كانت هناك آراء متضاربة، متصارعة.
كان لعفيف البزرى رأى فى شرط الأحزاب، خصوصاً بالنسبة للحزب الشيوعى السورى.
وكان لبعض الضباط من ذوى الآراء الموالية لحزب البعث رأى فى نفس الشرط.
وآخرون كانت لهم آراء فى عملية ابتعاد الجيش عن السياسة.
وأرسلوا يجيئون بعبدالحميد السراج من سوريا يسألونه:
– كيف الناس؟
وقال عبدالحميد السراج:
– إن تيار الوحدة متدفق ولا يمكن إيقافه.
واجتمعوا ليلتها جميعاً، مرة أخرى ثالثة، وعبدالحميد السراج معهم، بالرئيس جمال عبدالناصر، وكان لايزال عند شروطه كلها، لم يتنازل عن واحد منها، وخرجوا من عنده قرب الفجر يركبون طائرة تعود بهم إلى دمشق.
وكانت الحقيقة الكبرى فى الطائرة معهم وهم عائدون:
– إن التيار الشعبى وأوضاع سوريا الخارجية والداخلية، وما بينهم هم أنفسهم، تجعل الوحدة أمراً محتماً مهما كانت شروط الرئيس جمال عبدالناصر.
وجاء كل الساسة من سوريا. وفى طليعتهم شكرى القوتلى.
وبين الظروف الواقعة، وبين شروط جمال عبدالناصر، لم يكن هناك مخرج ثالث سهل.
وكان الإلحاح الشعبى السورى يكاد يقتحم كل غرفة من غرف الاجتماعات.
كانت إرادة الجماهير السورية هى العامل الضاغط والموجه.
وقبِل الوحدة من السياسيين السوريين من قبلها فى ذلك الوقت وفى ذهن كل منهم:
أولاً – أن يفلت من الضغط الشعبى الذى يحاصره.
ثانياً – أن يجد لنفسه فى الأوضاع الجديدة – بعد الوحدة – مكاناً يستطيع منه أن يباشر العمل لنفسه ولأهدافه التى لم يجد لها مخرجاً فى الدقيقة الستين من الساعة الرابعة والعشرين.
وكان فيهم مَن أسعده الخلاص من المسئولية، وأذكر وأنا أكتب هذه السطور كلمة شكرى القوتلى عندما وقع بإمضائه الاتفاق الأول على الوحدة، وأذكر الكلمة بحروفها – للحقيقة والتاريخ برغم ضعفى الشديد – الذى أعترف به – أمام الرجل العجوز الطيب الذى عاش فى ظروف أقوى من طيبته.
قال شكرى القوتلى بعد أن وقع بإمضائه على اتفاق الوحدة، قال بلهجته العالية وبطريقته المشهورة:
– ها. أنت لا تعرف ماذا أخذت يا سيادة الرئيس!
أنت أخذت شعباً يعتقد كل من فيه أنه سياسى.
ويعتقد خمسون فى المائة من ناسه أنهم زعماء.
ويعتقد 25 فى المائة منهم أنهم أنبياء.
وهناك عشرة فى المائة على الأقل يعتقدون أنهم آلهة.
واستطرد شكرى القوتلى:
– أخذت ناساً فيهم من يعبدالله، وفيهم من يعبدالنار، وفيهم من يعبدالشيطان، وفيهم من يعبد”..”!
وذكر شكرى القوتلى كلمة لا أستطيع أن أضعها على الورق.
ونظر جمال عبدالناصر إلى شكرى القوتلى وقال ضاحكاً:
– لماذا لم تقل لى ذلك قبل أن أوقع الاتفاق بإمضائى؟!
ولم تكن تلك نهاية أحداث ذلك اليوم العجيب. الخالد برغم ذلك فى تاريخ الأمة العربية وفى نضالها من أجل الوحدة.
فى نفس اليوم. تلقى الرئيس جمال عبدالناصر من دمشق تقريراً خاصاً حمله رسول بالطائرة عن اتصال قام به الملك سعود مع عبدالحميد السراج، يغريه على أساسه بأن يقوم بانقلاب يمنع إجراء الاستفتاء على الوحدة، مقابل أى مبلغ يريده عبدالحميد السراج.
ولم يجد جمال عبدالناصر فى نفسه القدرة على أن يصدق.
بل حتى عندما أرسل عبدالحميد السراج من دمشق، الشيك الأول الذى قدمه له الملك سعود، الشيك رقم 85902 المسحوب على البنك العربى بالرياض، بتاريخ 20 فبراير 1958 بمبلغ مليون جنيه إسترلينى.
حتى ذلك الوقت كان جمال عبدالناصر يهز رأسه فى شك ولا يتصور أن تصل الأمور إلى هذا الحد.
وبعث جمال عبدالناصر – يريد أن يقطع الشك باليقين – رسالة إلى عبدالحميد السراج يطلب منه أن يحاول صرف المبلغ. وصُرف المبلغ فعلاً وحوِّل إلى حساب عبدالحميد السراج فى البنك العربى فى دمشق، وفوقه شيكان آخراًن أحدهما بمبلغ 700 ألف جنيه إسترلينى رقم 85903 مسحوب من البنك العربى بالرياض، والثانى بمبلغ 200 ألف جنيه إسترلينى رقمه 85904 مسحوب من البنك العربى فى الرياض كذلك.
هنا لم يبق مجال لشك، ولا لهزة رأس حائرة.
ومن أعجب العجب، أنه فى نفس الوقت الذى كان ذهب الملك سعود يتسلل داخلاً إلى دمشق كان خالد بكداش زعيم الحزب الشيوعى السورى، يتسلل من دمشق خارجاً.
وكانت الجماهير فى شوارع كل مدينة سورية وكل قرية تهتف وتغنى.
كانت تعيش يوم انتصارها.
ولكن كثيرين فى المنطقة وخارجها كانوا يعتبرون يوم الوحدة هزيمةً لهم.
ولم يستسلموا للهزيمة بالطبع فلقد كان فى أيديهم سلاح كثير يحاربون به.
إن مخازن الأسلحة فيها كثير مما يمكن استعماله. الذهب.. والرصاص. والقنابل. والإذاعات. والمؤامرات. وسموم الشكوك.
ترسانة مليئة بالأسلحة التى يمكن أن تتحرك لضرب فرحة الجماهير بيوم انتصارها.
وتحركت أسلحة. وتحفزت أسلحة أخرى!
ومضت المعركة ضد الوحدة قاسية، رهيبة، دامية، مدمرة، حاقدة.
ولقد لهثت حتى وصلت إلى هنا. وأنتظر قليلا. ولسوف أعود إلى الكلام!.
بصراحة بقلم محمد حسنين هيكل: (4) ما الذى جرى فى سوريا؟ ما أشبه الليلة بالبارحة
لا أريد أن أتهم. ولكنى أسأل. مجرد سؤال!
ما الذى حدث بعد أن أصبحت الوحدة أمراً واقعاً، فرضته إرادة الجماهير فى سوريا. ثم هرول ساسة سوريا وحكامها فى ذلك الوقت من بداية 1958، ليلحقوا بإرادة الجماهير ويتعلقوا بذيلها، حتى يحتفظوا لأنفسهم ببقايا نفوذ؟
كانت الصورة النهائية التى رسمت بها فى الأسبوع الماضى شكل الموقف فى سوريا بعد إتمام الوحدة كما يلى:
“كانت الجماهير فى شوارع كل مدينة سورية وكل قرية تهتف وتغنى.
كانت تعيش يوم انتصارها.
ولكن كثيرين فى المنطقة وخارجها، كانوا يعتبرون يوم الوحدة هزيمة لهم ولم يستسلموا للهزيمة بالطبع فقد كان فى أيديهم سلاح كثير يحاربون به.
إن مخازن الأسلحة فيها كثير مما يمكن استعماله. الذهب، والرصاص، والقنابل، والإذاعات، والمؤامرات، وسموم الشكوك.
ترسانة مليئة بالأسلحة، التى يمكن أن تتحرك لضرب فرحة الجماهير يوم انتصارها تحركت أسلحة، وتحفزت أسلحة أخرى.
ومضت المعركة ضد الوحدة قاسية، رهيبة، دامية، مدمره، حاقدة!”
كانت هذه هى الصورة يومها. فما الذى حدث بعد ذلك. وكيف تطورت الحرب ضد الوحدة؟
لقد قضيت ساعات طويلة من هذا الأسبوع فى تجربة مثيرة.
حين أردت أن أستعيد فى ذاكرتى صورة المعركة التى وجهت إلى الوحدة فى يومها الأول، وجدت نفسى أعود إلى أحداث بداية سنة 1958، وإلى صحفها، وإلى أوراقها، وإلى إذاعتها.
ولأول وهلة أحسست بشىء غريب!
إن الذى حدث، وقيل، وكتب، وأذيع، ضد الوحدة فى يومها الأول، هو نفس الذى حدث، وقيل، وكتب، وأذيع، فى يومها الأخير!
نفس الأحداث. نفس الأقوال. نفس الكتابات. ونفس الإذاعات لم يتغير شىء منذ اللحظة الأولى. حتى اللحظة الأخيرة.
الملك سعود، حضرة صاحب الجلالة الملك سعود بن عبدالعزيز، الذى دفع لعبدالحميد السراج مليونى جنيه إسترلينى فعلاً.
وعرض عليه 20 مليون جنيه إسترلينى وعداً، إذا ما قام بانقلاب يمنع قيام الوحدة. هو نفسه حضرة صاحب الجلالة الملك سعود بن عبدالعزيز الذى كانت أمواله هى القوة المحركة للانقلاب الذى تم ضد الوحدة فعلاً بعد ثلاث سنوات ونصف سنة من إتمامها. بعد ثلاث سنوات ونصف سنة من محاولته الأولى ضدها.
لقد رفض عبدالحميد السراج ذهب الملك سعود سنة 1958.
ولكن غير عبدالحميد السراج لم يجد فى نفسه القدرة الكافية على الرفض سنة 1961.
وفى سنة 1958، كان صهر الملك سعود هو رسوله إلى الضابط الذى رفض العرض بمليونى جنيه إسترلينى وكشف المؤامرة كلها.
وفى سنة 1961، كان صديق الملك سعود، ملك آخر، مازال الآن على عرش الأردن، هو رسوله إلى الضباط الذين لم يرفضوا، والذين اشتركوا فى المؤامرة.
وفى سنة 1958، حاول الملك سعود مع كل ساسة سوريا القدامى، ليوقف التيار المتدفق نحو الوحدة، وجرب معهم كل وسائل الضغط، وفى مقدمتهم السيد شكرى القوتلى، وكان السيد شكرى القوتلى يشعر دائماً بخمائل الرياض تطوق عنقه، وبينها أنه لما حدث ضده انقلاب حسنى الزعيم سنة 1949، لم يجد باباً مفتوحاً يومها غير باب الرياض، وكان الملك عبدالعزيز آل سعود يعطيه فى ذلك الوقت عشرة آلاف جنيه فى الشهر مرتباً ثابتاً له باعتباره لاجئاً سياسياً لاذ برحابه.
ولكن الرجل العجوز الطيب، شكرى القوتلى، اعتذر للملك سعود وقتها بأنه لا يملك من الأمر شيئاً.
ولما ظهرت تفاصيل محاولة الملك سعود مع عبدالحميد السراج فى ذلك الوقت كان شكرى القوتلى فى حالة ذهول، ولكنه فى ذلك الوقت حاول جهده أن تبقى التفاصيل طى الكتمان ولا تذاع.
وكان شكرى القوتلى – والشهادة الآن للحقيقة والتاريخ – منطقياً فى محاولته، بل ويومها سمعته بأذنى يقول:
– إن والده، يقصد الملك عبدالعزيز والد الملك سعود، صاحب فضل على لا أنساه. لقد فتح لى بابه يوم محنتى، وأفاض علىّ من عطائه يوم خرجت من سوريا لا أملك شيئاً.
وفى سنة 1961، كان الملك سعود، هو نفسه الذى ضغط بكل قوته على شكرى القوتلى لكى يؤيد الانقلاب ضد الوحدة، وهو نفسه الذى بعث إليه بالرسل فى زيورخ يقنعونه ويؤثرون عليه، لأن انقلاب دمشق ضد الوحدة، كان يحتاج إلى وجه شعبى يؤيده ويسنده.
وبعد ثلاثة عشر يوماً من الصمت الكامل. خرج شكرى القوتلى عن صمته.
ولست أريد أن أتعرض بعد ذلك لشكرى القوتلى، فإن بى نحوه ضعفاً لا أقدر أن أغالبه.
ولسوف يكون التاريخ على أى حال، أقوى منى، فإن التاريخ فى حكمه على الأحداث، يجردها من كل عاطفة فردية.
وفى سنة 1958، وفرح الوحدة يملأ أعطاف الأمة العربية كلها، ظل الملك سعود وحده مكتوم النفس، متوارياً عن الأنظار فى ظلام المؤامرة التى حرض عليها ولم تنجح.
وفى سنة 1961، ومأساة الوحدة تهز ضمير الأمة العربية كلها، ظل الملك سعود وحده مكتوم النفس، متوارياً عن الأنظار فى ظلام المؤامرة التى حرض عليها ونجحت.
وعندما وقع التمرد فى دمشق، أبدى معظم رؤساء الدول العربية اهتمامهم بما يجرى وقلقهم من تطوراته، ملك المغرب. الحبيب بورقيبة رئيس جمهورية تونس. الرئيس إبراهيم عبود رئيس حكومة السودان. إمام اليمن. كلهم تقريباً، وغيرهم فى العالم المتحرر أو أغلبهم، تكلموا. ما عداه.
كل الذى فعله لحظة جاءه النبأ بأن المؤامرة ضد الوحدة نجحت. أنه قام ورقص رقصة السيف السعودية المشهورة، ثم عين الذى جاءه “بالبشرى” وهو سكرتيره السيد عبدالله أبوالخير وزيراً فى الوزارة السعودية، ثم كتم أنفاسه وقمع. ساكتاً عليه عباءة من ظلام وفوق رأسه عقال من ذهب!
ما أشبه الليلة بالبارحة!
أى بعد أيام من إتمام الوحدة، أذاع راديو بغداد، الذى كان يعبر فى ذلك الوقت عن وجهه نظر الأسرة الهاشمية الحاكمة من فوق عرش العراق، الذى انهار بعد ذلك بستة شهور قوله:
“إن الوحدة بين مصر وسوريا لا تعدو أن تكون “تسلطاً” مصرياً على سوريا”.
وأذاع راديو عمان، الذى مازال حتى الآن يعبر عن بقايا الأسرة الهاشمية، قوله:
إن هذا الذى تم بين مصر وسوريا ليس وحدة، وإنما هو “ابتلاع” قامت به مصر وأذاع راديو إسرائيل، الذى هو صوت عدو العرب بلا جدال، فى نشرة أقوال الصحف فى الساعة الواحدة إلا ربعاً بعد الظهر قوله:
“إن الوحدة بين مصر وسوريا هى خطوة فى أحلام عبدالناصر بإقامة إمبراطورية عربية من المحيط إلى الخليج”.
وفى نفس اليوم، روى السيد عبدالحميد السراج، فى حديث نقلته وكالات الأنباء من دمشق، أن وسيط الملك سعود قال له فى محاولة إقناعه بالقيام بانقلاب ضد الوحدة ما نصه بالحرف:
“ما الذى سوف تجنونه من الوحدة مع مصر. إن المصريين سوف يحكمونكم”.
وفى يوم 28 سبتمبر 1961. يوم الانقلاب ضد الوحدة، لم تكن هناك غير هذه المعانى المسمومة التى رددها كل أعداء الوحدة فى لحظة ميلادها.
وفى هذا اليوم ترددت نفس المعانى القديمة بألفاظها، بحروفها. ترددت من نفس الإذاعات:
لقد كانت الوحدة “تسلطاً” مصرياً على سوريا.
لقد كانت الوحدة “ابتلاعاً” مصرياً لسوريا.
لقد كانت الوحدة “إمبراطورية” أرادها عبدالناصر لتحقيق أحلامه.
لقد كانت الوحدة “حكماً” مصرياً لسوريا.
ما أشبه الليلة بالبارحة!
بل وفى التفاصيل يظهر التطابق بين الأمس وبين اليوم.
فى يوم 10 فبراير سنة 1958، فى الساعة الحادية عشرة من المساء قال “راديو مصر الحرة” الإذاعة السرية الموجهة إلينا من فرنسا ما نصه بالحرف الواحد:
“لقد سافر السيد الشرباصى وزير الأشغال فى حكومة عبدالناصر إلى سوريا ليبحث فى إمكانية استيعاب أرض سوريا لمليون من الفلاحين المصريين، وكذلك لاتخاذ الترتيبات المعيشية لمليون مهاجر مصرى. إن الاستفتاء على الوحدة لم يتم حتى الآن، ومازالت الوحدة حبراً على ورق ومع ذلك بدأت عملية الاستغلال”.
بالحرف الواحد قيل ذلك كله من الإذاعة التى توجهها إلينا فرنسا يوم 10 فبراير 1958، والقصد منه تصوير الوحدة باعتبارها طمعاً مصرياً فى أراضى سوريا.
وبعد ثلاث سنوات ونصف سنة، وبالتحديد فى يوم 17 اكتوبر 1961، قالت إذاعة دمشق، التى تنطق بلسان السلطات الحاكمة أو المتحكمة فى سوريا الآن، ما نصه بالحرف الواحد، فى برنامج أطلقت عليه عنوان “هل تعلم” أذيع فى الساعة الثانية عشرة ظهراً ما يلى:
“إن تهجير الفلاحين المصريين إلى الجزيرة فى سوريا كان أملاً من الآمال الكبار التى كان يتطلع إليها الحكام فى العهد السابق – وقد ظل الحكام السابقون يعملون لتنفيذ هذه الخطة بإحكام وتؤدة وبخطوة وراء خطوة وبصورة غير مباشرة حتى لا يثيروا يقظة العرب السوريين.
وقد زار سورية فى منتصف العام الماضى الدكتور مصطفى الجيل رئيس قسم الأمراض فى جامعة الإسكندرية والدكتور على الحسنى أستاذ المحاصيل ورئيس قسم النبات فى الجامعة نفسها، على رأس بعثة من خبراء التربة واستصلاح الأراضى، وقامت البعثة بزيارة محافظتى الجزيرة. ودرست إمكانية استيعابهما والمشاريع الزراعية التى يمكن أن تنفذ فى هاتين المحافظتين، وعندما عادت البعثة إلى مصر قام الأستاذان المصريان برفع تقرير إلى الرئيس عبدالناصر عن جولة البعثة وضمناه دراستهما حول المهمة التى أوكلت أليهما وقد أكد الخبيران المصريان فى تقريرهما إمكانية تهجير الفلاحين المصريين إلى المنطقة.
ولم تمض فترة وجيزة على عودة البعثة حتى تدفق عشرات الخبراء المصريين من مهندسين زراعيين وخبراء فنيين فى بحوث التربة والمشاريع الزراعية والتهجير والإسكان واستصلاح الأراضى”.
هكذا تقول إذاعة دمشق فى أكتوبر 1961، نفس ما قالته إذاعة فرنسا السرية فى فبراير سنة 1958.
“تقول نفس الكلام. بألفاظ مختلفة، وبمعنى واحد هو تصوير طمع مصر فى تهجير فلاحين من أبنائها إلى سوريا.
والذى يدمى القلب ويجرحه، أن إذاعة دمشق سنة 1961 كانت تعرف أسباب الدراسة التى قام بها الأساتذة المصريون والخبراء فى منطقة الجزيرة. كانت تعرف أن الجمهورية العربية المتحدة وقت الوحدة – بعد هذه الدراسة – وقعت فى يوم 6 يوليو 1961 اتفاقاً مع ألمانيا الغربية بقرض قيمته 500 مليون مارك لبناء سد عال على الفرات.
وكان سد الفرات كله سيبنى للفلاحين السوريين.
وكان الشرباصى وزير الأشغال حين زار سوريا فى فبراير سنة 1958 يفكر فى مشاكل الفلاح السورى.
وكان الخبراء المصريون والأساتذة الذين طافوا بحوض الفرات على حد رواية إذاعة دمشق – يفكرون فى مشاكل الفلاح السورى.
ولكنها أكاذيب العدو من أول يوم إلى آخر يوم، أكاذيب العدو وخطته.
وما أشبه الليلة بالبارحة!
وفى سنة 1958، تحرك ملوك وأمراء الأسرة الهاشمية الذين ذهب معظمهم تحت التراب، ومازال واحد منهم باقياً يتمرغ فوقه – تحركوا جميعاً ليواجهوا تيار الوحدة الشعبى الكاسح.
وكانت حركتهم هى “الاتحاد الهاشمى” الذى ضم العراق والأردن فى ذلك الوقت، ثم هدمته إرادة شعب العراق بعد ستة شهور من إقامته.
فى ذلك الوقت حاولت الرجعية فى المنطقة أن تزيف شعار الوحدة وترفع علماً ملوناً جديداً. أى علم!
وفى سنة 1961، بعد الضربة التى وجهتها الرجعية إلى أول تجربة شعبية فى الوحدة العربية، لم يجد حكام دمشق إلا أن يعلنوا مشروعاً جديداً للوحدة كما يتصورونها أو كما تتصورها مصالحهم الرامية إلى المضى فى استغلال الجماهير.
وفى سنة 1958 زيفت الرجعية شعار الوحدة خوفاً من اندفاع التيار الشعبى نحوها.
وفى سنة 1961 زيفت الرجعية شعار الوحدة خوفاً من رد الفعل الشعبى بعد النكسة التى واجهتها التجربة بالمؤامرة على سوريا.
وأكثر من ذلك فيما يتعلق بالاتحاد الهاشمى، بعملية تزييف الوحدة التى جرت به استذكر موقف إسرائيل.
استذكر موقف إسرائيل وأمامى أوراق ووثائق وصحف تلك الأيام.
فى تلك الوقت – وليس ما أقوله الآن سراً يذاع لأول مرة – اتصل السيد نورى السعيد رئيس وزراء العراق وقتها، بالسير ميكل رايت السفير البريطانى فى بغداد، وطلب إليه أن تتصل الحكومة البريطانية من ناحيتها بحكومة إسرائيل، وأن تخطرها بالاتحاد المزمع عقده بين العراق والأردن تحت اسم الاتحاد الهاشمى، وذلك حتى لا تكون الخطوة مفاجأة لإسرائيل ومن ثم يكون الخطأ فى تقديرها، ثم يضايقها بعده أن تدخل وحدات من الجيش العراقى إلى الأردن.
ولم يعلن من أمر الاتحاد الهاشمى يومها شىء إلا بعد أن عاد السير ميكل رايت سفير بريطانيا فى بغداد يومها إلى مقابلة السيد نورى السعيد، وليعطيه على ما قالت الصحف البريطانية: الضوء الأخضر من إسرائيل، علامة معناها تقدم، ونحن نفهم موقفك.
وتقدم نورى السعيد بعدها. وبعدها فقط. ثم أعلن قيام الاتحاد الهاشمى!
لسوريا”.
ذلك كله مما حدث سنة 1958 معروف مشهور. ليس فيه سر ولم يبق فى تفاصيله خفاء.
ولكنى أريد أن أسال: ما الذى حدث فى سبتمبر 1961؟
لا أدعى أن لدى سراً أذيعه أو وثيقة أنشرها. ولكنى أسأل وأنتظر الحوادث والأيام لتجيب؟
ما الذى حدث؟
إن ثمة حقائق لا تقبل النقاش أو الشك:
1- لقد أعلن الملك حسين بنفسه أن جيش الأردن كان محتشداً على الحدود السورية كلها من قبل الانقلاب السورى الأخير لكى يشد أزره ويناصره.
وأسأل هنا:
– كيف استطاع الملك حسين بنفسه أن يسحب جيشه كله من أمام إسرائيل وأن يضعه على الحدود السورية. ومن الذى ضمن له أن لا تتحرك إسرائيل؟
– لا يمكن لإسرائيل إلا أن تلاحظ أن جيش الملك حسين قد سحب من أمامها، ولا يمكن لها إلا أن تلاحظ أنه قد حشد بأكمله عند خط الحدود مع سوريا. فكيف فهمت إسرائيل هذه الحركة وسكتت. ومن الذى أفهمها ومن الذى ضمن سكوتها؟
2- أن معسكر قطنة الذى تحركت منه الدبابات التى قامت بالانقلاب السورى الأخير يبعد عن حدود إسرائيل بثلاثين كم فقط.
وأسأل هنا:
– كيف اطمأن الذين قاموا بالانقلاب إلى أن إسرائيل لن تشعر بهذه الحركة أو تستغلها بعد وقوعها لصالحها ولصالح مطامعها فى سوريا وهى معروفة ظاهره!
وأضيف هنا أننى لا أتهم. وإنما أنا أسأل فقط؟
3- أن دمشق على بعد 60 كيلو متراً من إسرائيل، والخطر الإسرائيلى على سوريا لا يحتاج إلى دليل جديد، ولقد أفهم – بصرف النظر عن مبادئى الخاصة وعن رأيى – أن يقوم فى دمشق من يقول: إننا لا نريد الوحدة مع مصر!
ولكن هذا شىء واعتقال 700 ضابط مصرى فى سوريا، وإساءة معاملتهم، إلى درجة تمزق كل صبر، مسألة أخرى!
لقد أخرجتهم حكومة الانفصال من مواقعهم المواجهة للعدو. ليكن.
وقالت لهم أن لا مكان لهم فى سوريا. ليكن.
ولكن يبقى بعد ذلك – وهذه حقيقة بديهية – أن الجيش المصرى، وهؤلاء الضباط بين أفراده، هو القوة الوحيدة القادرة على مساندة الجيش السورى يوماً فى معركة ضد إسرائيل!
– وأسأل. أسال مجرد سؤال. على من تعتمد إذن حكومة دمشق إذا ما واجهتها يوماً أخطار معركة مع إسرائيل؟
وأجد فى ملفاتى القديمة صورة كاريكاتورية نشرتها جريدة نيويورك تايمز الأمريكية، المتشيعة لإسرائيل كما يعرف كل عربى، والصورة منشورة فى اليوم السادس من فبراير 1958.
الصورة كماشة لها فكان تمثل الوحدة بين مصر وسوريا.
وإسرائيل فى وسط الكماشة.
وجمال عبدالناصر يدير مفتاح الكماشة لتضيق رويداً رويداً.
وتحت الصورة عبارة تقول “الضغط الذى تتعرض له إسرائيل”.
ثم أجد فى أوراقى الجديدة، عدداً من مجلة “الجويش أوبزرفر” الصادرة فى السادس – السادس أيضاً – من أكتوبر 1961، وفى الصفحة الثالثة عشرة من هذا العدد، عبارة وردت ضمن تقرير صحفى عن الانقلاب فى سوريا تقول بالحرف الواحد:
“إن الحكومة ووزارة الخارجية – فى إسرائيل – كانتا دقيقتين فى الابتعاد عن أى تعليق على التمرد الذى حدث عبر الحدود.
لقد كان واضحاً إلى أى الجانبين تتجه مشاعرهما الطيبة، ولكن لم يكن هناك أضر بحركة المتمردين من أى مظهر صغير من العطف عليهم من جانب إسرائيل، وحتى إذاعة صوت إسرائيل طلب إليها أن تصوغ أخبارها بكلمات دقيقة”.
ومرة أخرى لست هنا لأتهم وإنما أريد أن أسأل فقط؟
وإذا كانت فى أحداث الأمس التى تكشفت قدرة إلقاء ضوء على أحداث اليوم التى لم تتكشف بعد، فإنى أقول:
– ما أشبه الليلة بالبارحة.
وإنما، هنا يقفز – للحقيقة والتاريخ – سؤال:
– لكن. لماذا إذن استطاع أعداء الوحدة، على اختلاف أسمائهم، على اختلاف أزيائهم، على اختلاف أهدافهم أن يوجهوا هذه الضربة للوحدة؟
إن الذى قالوه فى اليوم الأول من التجربة فى فبراير سنة 1958 وبعده.
هو نفس الذى قالوه فى اليوم الأخير للتجربة فى سبتمبر سنة 1961 وبعده.
هو نفس الذى قالوه بين اليومين طوال ثلاث سنوات ونصف سنة.
إن المؤامرة ضد الوحدة ظاهرة فى الأحداث، وفى الأوراق وفى الأصوات، التى نستطيع أن نعود إليها من ذكريات سنة 1958.
والمؤامرة ضد الوحدة ظاهرة فى الأحداث، وفى الأوراق، وفى الأصوات، التى نستطيع أن نصل إليها مما هو واقع الآن فى أكتوبر سنة 1961.
وأطراف المؤامرة بالأمس نعرفهم جميعاً. لقد اعترف كل واحد بنصيبه فيها ولم يقدر على المضى فى الإنكار.
وأطراف المؤامرة اليوم لا نحتاج فى كشفهم إلا أن نحرك الإبرة فى جهاز راديو، ما بين إذاعتى عمان وتل أبيب. وغيرهما ويصعب على هنا أن أضيف اسم إذاعة أخرى!
ذلك كله مفهوم.
مفهوم أن يتجمع أعداء الوحدة العربية كلهم، من أول يوم فى التجربة إلى آخر يوم، وأن يقولوا نفس الكلام، وأن يتخذوا نفس الموقف، وأن يتحركوا إلى نفس الهدف.
ولكن أين كنا نحن؟
وكيف لم نستطع اتقاء الضربة؟
ولقد كان عدونا قوياً. هذا صحيح.
ولكن الصحيح أيضاً أننا لم نحسن حماية نقاط الضعف فى خط دفاعنا – برغم قوتنا المتفوقة على قوة العدو باعتبارات الطبيعة وباتجاه التاريخ.
ولكن هذا الكلام يحتاج إلى مزيد من تفاصيل
بصراحة بقلم محمد حسنين هيكل: (5) ما الذى جرى فى سوريا؟ نقط الضعف فى تجربة الوحدة
أخطاء القاهرة فى المعركة الكبرى فى دمشق
أجل. كيف لم نستطع اتقاء الضربة التى وجهت إلى الوحدة فى دمشق؟
عند هذا السؤال الكبير وقفت فى الأسبوع الماضى وكانت آخر عبارة قلتها قبله هى:
“ذلك كله مفهوم”.
مفهوم أن يتجمع أعداء الوحدة العربية كلهم، من أول يوم فى التجربة إلى آخر يوم وأن يقولوا نفس الكلام، وأن يتخذوا نفس الموقف، وأن يتحركوا إلى نفس الهدف.
ولكن أين كنا نحن؟
وكيف لم نستطع اتقاء الضربة؟
ولقد كان عدونا قوياً. هذا صحيح.
ولكن الصحيح أيضاً أننا لم نحسن حماية نقاط الضعف فى خط دفاعنا – برغم قوتنا المتفوقة على قوة العدو باعتبارات الطبيعة وباتجاه التاريخ!.
عند هذا الحد انتهيت من الكلام فى الأسبوع الماضى.
فإذا جاز لى اليوم أن ألتقط الخيط من حيث تركته بالضبط، وأن أبادر اليوم مبتدئاً، بالإجابة على السؤال الذى وقفت عنده منتهياً فى الحديث الماضى لقلت على الفور:
“إن القوة الجديدة التى جاءت بها الوحدة إلى سوريا، لم تستطع أن تباشر ما كان يمكن أن يكون لها من تأثير. إن قوة الوحدة ظلت معزولة عن الفعل الإيجابى. بل وأكاد أقول أنها فى بعض الأحيان، من تأثير عقد وظروف، ساهمت فى عزل نفسها عن الفعل الإيجابى. أخيراً أخيراً تنبهت، ولكنها حين تنبهت كان وقت طويل، غالٍ وثمين، قد تسرب وضاع، فلما جاءت الضربة ضد الوحدة، لم تكن قواها الدفاعية فى خير حال تستطيع معه رد الخطر!”.
كيف؟
كيف. ومَن المسئول؟
كلنا شركاء فى المسئولية، وعلى كل من يتحمل فى المسئولية نصيباً، أن يرفع يده اليوم فى شجاعة وشرف، ويقول:
– ها هنا كان خطئى. وإنى أعترف به!
إن عملية النقد، والنقد الذاتى، لم تكن فى يوم من الأيام حيوية فى نضال الأمة العربية بمثل ما هى اليوم.
ولا ينبغى لأحد منا أن يتردد فى النقد، وفى النقد الذاتى مخافة أن يستغل ما يقوله فى المعركة النفسية الهائلة التى تدور ضد الأمة العربية الآن.
لا ينبغى لأحد منا أن يكتم شهادته، لأن إذاعة دمشق وحكامها اليوم سوف يستغلون كل كلمة، أو لأن إذاعة الملك حسين سوف تستعملها غداً ضدنا، أو لأن إذاعة إسرائيل سوف تنتهزها فرصة تنال بها كل ما تستطيع أن تناله من قيم فى حياتنا.
تلك كلها مسألة وقت.
إن صوت دمشق لن يظل أبدا هذا الصوت الذى نسمعه الآن.
وعمر الملك حسين، أقصد عمر نظامه كله، لن يزيد على طول قامته.
وإسرائيل جسم غريب على الأرض العربية وستلفظ الأرض العربية هذا الجسم الغريب، وتنفضه بعيداً، مهما بدا الأمر شاقاً ومهما بدا صعباً.
إنما الشىء الوحيد الباقى، بالطبيعة وبالتاريخ، هو وجود الأمة العربية ذاتها، والحركة الحرة لهذا الوجود، تأكيداً له، وتحقيقاً لآماله العريضة فى الحياة وفى السلام.
من هنا لا ينبغى أن تكون هناك حدود لعملية النقد، والنقد الذاتى، لتجربة الوحدة الأولى، فى هذه المرحلة الخطيرة من حياة الأمة العربية.
وأسأل الآن:
“لماذا لم تستطع القوة الجديدة التى جاءت بها الوحدة إلى سوريا، أن تباشر ما كان يمكن أن يكون لها من تأثير، ولماذا ظلت معزولة، ولماذا عزلت نفسها فى بعض الأحيان عن الفعل الإيجابى؟”.
أو بمعنى آخر:
“لماذا تحولت الوحدة إلى عملية سلبية؟”
والرد هو:
بعض الأسباب شرحته من قبل، فيما كان قائماً فى دمشق، من قبل الوحدة!
شرحته حين رويت قصة الذين انساقوا فى تيار الوحدة من الحاكمين فى دمشق قبل فبراير سنة 1958، وحين رويت قصة الظروف المحيطة بسوريا فى ذلك الوقت.
الأحزاب المتصارعة، كتل الجيش المتربصة ببعضها بعضاً فى المعسكرات، لدرجة أن قادتها كانوا يقضون الليالى فى الثكنات حتى يكونوا على أهبة الاستعداد لأى حركة يقوم بها أحدهم ضد الآخرين، ثم الواجهات السياسية المدنية المتهالكة التى كانت تتولى أمور الحكم بالاسم، ولا تملك من أموره بالفعل شيئاً.
هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى، ضغط حلف بغداد على سوريا، وتسلل الشيوعيين إلى مراكزها الحساسة الأمر الذى خلق – بالإضافة إلى الصراع الداخلى – ميزاناً دقيقاً للسلامة السورية كان عبدالحميد السراج يحاول الإمساك به بقدر ما يرى من وسائل العمل البوليسى حتى لا تسقط سوريا فى ظلام لا يبدو مداه.
ومن ناحية ثالثة، اتجاه الجماهير السورية إلى الوحدة مع مصر، خلاصاً من احتمالات الظلام، وتحقيقاً للحلم القديم فى الوحدة، وانجذاباً إلى شخصية البطل التى ظهرت فى مصر والتى استطاع صاحبها فى فترة قصيرة من الزمان أن يطرد الاستعمار من مصر، وأن يرغم مشروعاته الداعية إلى السيطرة على المنطقة عن طريق الأحلاف العسكرية على التقهقر، وأن يكسر احتكار السلاح، وأن يخلق كياناً دولياً مستقلاً للعرب، وأن يؤمم قناة السويس، وأن ينتزع النصر تحت ظروف العدوان المسلح، وأن يحطم الحصار الاقتصادى والسياسى على وطنه، ثم يبدأ فى التمهيد للثورة الاجتماعية، بعد نجاح الثورة السياسية، ويروح يتحدث عن الكفاية والعدل، وعن التصنيع والاشتراكية!
وكان التيار الشعبى السورى، الذى فرض الوحدة مع مصر، وساق أمامه كل الأحزاب السياسية فى سوريا، وكل الكتل المتصارعة فى الجيش، وكل الواجهات المدنية المتهالكة التى تجلس فى وقار على كراسى السلطة، وهى مسلوبة من كل سلطة!
– وبعض الأسباب شرحته من قبل، فيما كان قائماً من حول دمشق، من قبل الوحدة، وحين إتمامها.
شرحته حين رويت موقف العواصم العربية القريبة التى تحكمها الرجعية، المتعاونة مع الاستعمار بحكم ترابط المصالح بينهما على الأقل.
شرحته حين تعرضت لشيكات الملك سعود التى دفعها لعبدالحميد السراج ليقوم بانقلاب ضد الوحدة، ولكن السراج رفض.
وشرحته حين تعرضت لعملية تزييف الوحدة، بإقامة الاتحاد الهاشمى بين بغداد وعمان، ببركات دول الاستعمار الغربى المؤيدة له والتى تولت نيابة عنه استئذان إسرائيل فى إقامته.
وشرحته حين تعرضت لنظرة إسرائيل إلى قيام الوحدة، التى اتخذت صورة كماشة ذات فكين تطبق على إسرائيل من شمال ومن جنوب.
وشرحته حين تعرضت للخطر الذى أحست به دول الاستعمار الغربى صاحبة المصالح الحساسة فى المنطقة العربية وخوفها من أن يزيد المد العربى ثم يجرف أمامه المصالح والأعوان الذين يقومون على صيانة هذه المصالح.
شرحت هذا كله، شرحته، بل عددت الشعارات التى انطلقت فى الهواء تصف الوحدة بأنها “تسلط مصرى على سوريا” بأنها “ابتلاع مصرى لسوريا”، وبأنها “إمبراطورية مصرية يحلم بها عبدالناصر” وبأنها “حكم مصرى سوف يفرض على سوريا”.
ولكن يبقى – بعد هذا كله – الطرف الثالث فى معركة الوحدة.
يبقى أن أشرح دور القاهرة!
ولقد كانت القاهرة هى الطاقة الثورية التى انطلق منها شعاع الأمل فى المنطقة فكيف تحولت هذه الطاقة الثورية هى الأخرى إلى عامل سلبى فى تجربة الوحدة؟
سأحاول الآن أن أعدد الأسباب.
وأقول قبل أن أبدأ العد أننى لا أدعى أن هذه هى الأسباب كلها، ولكنى أقول: ذلك ما رأيته منها، فإن كان بعضها قد غاب عنى، فليس عن عمد أو قصد غاب، وإنما قصور الرؤية وحده عذرى. قصور الرؤية وسط الضباب!
أولاً:
كانت الظروف نفسها غير مهيأة لتجربة الوحدة الأولى.
لم تكن هناك قواعد اقتصادية واجتماعية يمكن أن تقوم عليها التجربة، وتستند فى صلابة إلى أسسها المتينة.
هناك وحدة اللغة التى تخلق وحدة الفكر.
وهناك وحدة التاريخ التى تخلق وحدة الضمير.
ولكن وحدة العقل ووحدة الضمير مقدمات لعمليات اقتصادية واجتماعية لابد منها قبل الإقدام على خلق الدولة الواحدة.
ولقد عبر جمال عبدالناصر بنفسه عن ذلك فى حديثه لقادة الجيش السورى، حين جاءوه بالطلب الأول للوحدة حين قال لهم فى بيته ليلة 15 يناير 1958، إن الوحدة تحتاج إلى خمس سنوات على الأقل من التمهيد الاقتصادى والاجتماعى ليكون لها الأساس المتين.
ثم اضطر عبدالناصر إلى تغيير رأيه أمام احتمالات الخطر التى تهدد سوريا من الداخل والخارج، وأمام الضغط الشعبى السورى.
وللتاريخ بعد ذلك أن يوازن، والمستقبل وحده سوف يحمل حكم التاريخ على سؤال هام:
– هل الأهداف التى حققتها الوحدة فى عمرها القصير كانت تساوى الإقدام عليها قبل التمهيد الأساسى لها. أم أنه كان من الخير الانتظار. مهما كان الخطر المرحلى، ومهما كان ضغط الظروف؟
– ولقد حققت الوحدة إسقاط حلف بغداد الاستعمارى.
– كذلك حققت الوحدة ضرب التسلل الشيوعى فى المنطقة.
– كذلك حققت الوحدة كشف العناصر الرجعية العربية، وأظهرت أمام العناصر التقدمية فيها احتمالات العمل الواسعة إذا ملكت القدرة الإيجابية على تحمل مسئوليته.
ولكن تلك كلها قضايا للمستقبل، وكلها لا تمنع من القول، بأنه حين قامت الوحدة سنة 1958 لم تكن الظروف مهيأة لمنحها الإيجابية الكافية.
ثانياً:
أن القومية العربية سنة 1958، فى بداية هذه السنة، كانت تخوض حرباً أشبه ما تكون بحرب العصابات ضد الخطوط الاستعمارية فى المنطقة وضد القواعد الاستعمارية على شكل معسكرات حربية، أو على شكل قصور رجعية.
كانت القومية العربية فى كل مكان كخيوط الضوء لا يمكن الإمساك بها أو تقطيعها وتمزيقها.
كانت القومية العربية كالشبح، يظهر فى كل مكان، ويختفى فى كل مكان، وكانت ضرباته تبدد أمن القابعين فى المعسكرات الحربية وتؤرق أحلام الجالسين فى القصور اللاهية الغارقة إلى ذقونها فى الذهب واللذة!
وكان إتمام الوحدة يحمل عاملاً جديداً طارئاً على الموقف لأول مرة.
بقيام الوحدة أصبحت القومية العربية تحارب من خنادق ثابتة، دفاعاً عن خطوط محددة.
بقيام الوحدة تحولت خيوط الضوء إلى منار قائم على قاعدة لا تتحرك ومن ثَمَّ أمكن أن يصبح المنار نفسه هدفاً مكشوفاً يسهل توجيه الضرب إليه وإطفاء النور المشع منه.
بقيام الوحدة أصبح الشبح الذى لا يطال جسداً يمكن التصويب عليه، والتركيز، والمطاردة.
والسؤال بعد ذلك:
– هل كان الوقت قد حان سنة 1958، لكى تتخلى القومية العربية عن مرونة حرب العصابات، وحركتها السريعة، وتربط نفسها فى الخنادق الثابتة، ولتحدد خيوط ضوئها من منار، ولتجسد وجودها المعنوى فى شكل كيان قائم من دم ولحم؟!
ثالثاً:
إن الشعب العربى فى مصر، لم يكن بعد قد وصل إلى مرحلة الاستعداد الكامل للوحدة العربية.
كانت قرون الطغيان العثمانى قد باعدت ما بين شعب مصر العربى، غرب سيناء، وما بين باقى الشعوب العربية شرقها.
ثم جاءت الحملة الفرنسية بقيادة نابليون، والحسنة الوحيدة لها أن كسرت السور الحديدى العثمانى من حول مصر فعاد لها اتصالها بتيار الحضارة العالمى الذى كان يتمركز ذلك الوقت فى أوروبا وحدها.
وتفتحت زهور كثيرة تحت أشعة الشمس الجديدة على السهول والروابى الخضر من وادى النيل.
بدأ الشعب، صانع الحضارة القديمة، وأستاذها الأول، يفتح عيونه على فكر جديد – بعد النوم الطويل وبعد الظلام الكئيب.
وفى تلك الفترة الحرجة من اليقظة، أفشت الآثار المصرية أسرارها كلها، وكشفت كنوز تاريخ عريق.
ولكن المجد الذى ظهر كانت له ضريبته على شعب مصر.
وكانت الضريبة أن مصر فى هذا الوقت الحافل بروعة اليقظة، لم تستطع أن تحول أنظارها عما هو تحت أقدامها، لتمد البصر عبر سيناء، وتكتشف مكانها العربى.
وبذل المفكرون العرب الذى لجئوا إلى مصر فى أواخر القرن الماضى هرباً من الطغيان التركى، جهوداً كبيرة لبناء جسر عبر سيناء.
وأضافت تجارب السنين معانى صالحة للتأمل وللتفكير.
ثم كان إنشاء إسرائيل بواسطة قوى الاستعمار الغربى، بقصد عزل مصر عن العالم العربى، هو الدليل الحاسم على الحقيقة التى كان يراد لها أن لا تظهر ولا تبين!
ومن سوء الحظ أن خيانات الأسرة الهاشمية، من بغداد وعمان، وطعنتها فى الظهر للجيش المصرى المقاتل فى فلسطين أحدثت هزة فى إيمان مصر العربى الجديد.
ولكن المعارك الناجحة التى خاضتها مصر والشعوب العربية كلها بعد ثورة 1952 استطاعت أن تعيد للإيمان العربى فى مصر ثباته واستقراره الوطين.
المعارك ضد الأحلاف، والمعارك ضد احتكار السلاح، والمعارك ضد التبعية الدولية، والمعارك ضد العدوان المسلح على مصر، والمعارك ضد الحصار الاقتصادى والسياسى، والمعارك ضد ألوان الحرب النفسية وترساناتها المكدسة بالأكاذيب والمفتريات!
ولكن هل كان إيمان مصر العربى، قد وصل سنة 1958 إلى حد الاستعداد للوحدة الشاملة.
كانت فورة العاطفة واضحة سنة 1958 ولقد أظهرت نفسها فى نتيجة الاستفتاء الشعبى على الوحدة، ولكن فورة العاطفة لم تستطع حتى وقتها أن تمنع مئات فى تلك الفترة أن يكتبوا إلىَّ يسألون:
– هل حقاً ستصبح “مصر” بكل مجدها هى الإقليم الجنوبى من الجمهورية العربية المتحدة؟
– هل يمكن أن نتخلى عن العلم الأخضر والهلال والنجوم الثلاث فى وسطه وقد خضنا تحت هذا العلم كل معاركنا من أجل الاستقلال؟
وأسئلة أخرى كثيرة، قريبة من هذا الاتجاه، والذين لم يكتبوا إلىَّ بالطبع كانوا أكثر عدداً من الذين كتبوا!
رابعاً:
كان هناك اختلاف واضح فى مراحل التطور الاجتماعى فى كل من مصر وسوريا فى ذلك الوقت من سنة 1958.
كانت مصر قد انتهت من مرحلة الثورة السياسية ضد الاستعمار الأجنبى، ووصلت إلى أعتاب الثورة الاجتماعية ووقفت بعد المعركة السياسية الضارية تتحسس طريقها إلى التغيير الثورى فى العلاقات الاقتصادية السائدة فى الوطن.
وكانت أبعاد الثورة الاجتماعية واضحة فى مصر.
فإن الطبقة الرأسمالية العليا كانت قد كشفت نفسها بالتعاون الظاهر مع الاستعمار ضد محاولات الشعب أن يحرر لقمة العيش فى بلده.
وكان تحرير الوطن من الاستعمار مقدمة لتحريره من الاستغلال الذى عزز مواقعه فى حماية الاستعمار.
وكانت قوة الاندفاع الثورى بعد معارك التحرير المتوالية ضد الاستعمار، معبأة متحفزة.
وكان الموقف فى سوريا يختلف.
لم تكن سوريا فى حالة تعبئة ثورية، وإنما كانت بعد الاستقلال قد دخلت فى تيه المناورات الحزبية والانقلابات العسكرية.
ولم تكن حدود تعاون الرأسمالية السورية مع قوى الاستعمار فى المنطقة واضحة كل الوضوح، وفى الغالب كان تعاون الرأسمالية السورية مع الاستعمار يجرى بالوساطة، كان يمر بقصور الملوك فى بغداد وعمان والرياض، وكانت هذه القصور هى همزة الوصل، وهى الصلة بين أصحاب المصالح فى سوريا وبين أصحاب المصالح الاستعمارية فى المنطقة كلها.
ولقد كشفت وثائق حلف بغداد السرية بعض ساسة سوريا فى تعاملهم مع الاستعمار عن طريق قصر الزهور.
وكشفت ظروف سقوط كميل شمعون فى لبنان بعضاً آخر من ساسة سوريا فى علاقتهم ببريطانيا.
وكشفت شيكات الملك سعود لعبدالحميد السراج يوم الوحدة الأول، وكشفت ملايينه التى لم تدفع بشيكات هذه المرة، وإنما وصلت إلى سوريا عن طريق الملك حسين نقداً سائلاً جاهزاً للبيع والشراء – أن هناك خطة واسعة تستهدف ضرب قوى التحرر الوطنى العربى، ولا يمكن أن يكون هذا الضرب لمصلحة غير مصلحة الاستعمار.
المهم أنه فى سنة 1958.
كانت مصر قد وصلت إلى مرحلة التأهب للثورة الاجتماعية.
أما سوريا فقد كانت هناك ظلال تنزل على الحقيقة.
ولم يكن معقولاً أن تكون هناك جمهورية واحدة، تتحرك الثورة الاجتماعية فى أحد إقليميها، ويسود الجمود الاجتماعى فى إقليمها الثانى.
وكانت هناك تهدئة متعمدة للانطلاق الثورى الاجتماعى فى مصر. انتظاراً لدراسة واضحة لأحوال الإقليم السورى وأوضاعه.
وكان هذا التفاوت بين الإقليمين يخلق شداً وجذباً فى تيارات التطوير الاجتماعى داخل الجمهورية الواحدة. ومن هنا فلقد حدث من أول يوم للوحدة، أن الرأسمالية السورية – التى رحبت بالوحدة، وفى تصورها أن الوحدة سوف تجيئها على أى حال بحكومة قوية، تصد خطر الشيوعيين الزاحف على دمشق – بدأت على الفور ترفع الشعارات القائلة بأن أوضاع سوريا تختلف. وأن سوريا بلد يعيش على التجارة. وأن ما يصلح لمصر لا يصلح لسوريا!
كانت الرأسمالية السورية فى ذلك الوقت يتجاذبها عاملان:
أولهما – ما توفره الوحدة من قيام حكومة قوية قد تكون قادرة على حماية المصالح القائمة.
وثانيهما – تخوفها من التيارات الثورية البادية فى القاهرة. مهما لاح من هدوئها الظاهرى بعد الوحدة!
خامساً:
لم تكن القاهرة – عاصمة الجمهورية التى جمعت مصر وسوريا – تعرف من حقائق الأمور فى سوريا ما يكفل لها حكماً حاسماً على الموقف.
بل إن دمشق نفسها لم تكن فيها صورة حقيقية لأحوال الوطن السورى وأوضاعه بالأرقام.
وفى غيبة الصورة الحقيقية، فإن القوة الجديدة التى جاءت بها الوحدة إلى سوريا، وجدت نفسها فى موقف المتفرج فى دمشق. أو على الأصح فى موقف المنتظر.
وكانت القوة الجديدة تنتظر الأرقام. ولم تكن الأرقام جاهزة، بل وكانت المصالح المتحكمة تحبس على الأرقام لكى لا تظهر، ولكى لا تفرض هذه الأرقام – بعد ظهورها – نفسها ومنطقها على اتجاهات الحوادث.
وضاع فى الانتظار وقت طويل.
سادساً:
كان الفاصل الجغرافى بين الإقليمين عقبة حقيقية.
طريق البر عليه إسرائيل.
وطريق الجو – مهما كان – محدود.
والبحر هو الصلة الوحيدة.
سابعاً:
تأثرت القاهرة إلى حد كبير – وهذا من أخطائها الكبرى – بدعاية الاستعمار وأعوانه، أو بمعنى أدق أصبحت حساسة من ناحية رغبتها فى ألا تفتح طريقاً للدعاية الاستعمارية.
وكان هناك عامل طبيعى يضاف إلى هذه الحساسية.
أن سكان مصر 26 مليوناً من البشر.
وسكان سوريا 4 ملايين من البشر.
ومعنى ذلك أن الترجيح دائماً سوف يكون فى يد مصر باعتبار الأغلبية المطلقة، ولم يكون تيار الوحدة قد استطاع بعد أن يتغلب على النعرات الوطنية الإقليمية، بعضها سوء النية كامن فيه، وبعضها الآخر نابع عن طيبة وعن عاطفة خالصة وإنما ساذجة!
وبتأثير العاملَين. الدعاية والعامل الطبيعى. أصبحت القوة الجديدة التى جاءت بها الوحدة إلى دمشق لا تمارس سلطة حقيقية.
إذا حكمت. فإن الخيط رفيع بين الحكم وبين تصويره على أنه “تحكم”.
إذا قررت. فإن الخيط رفيع بين القرار وبين “التسلط”.
إذا تحركت. فإن الخيط رفيع بين الحركة وبين “الابتلاع”!
ثامناً:
بتأثير عدد من هذه العوامل التى شرحتها تأخرت عملية الوحدة الحقيقية ولم يبقَ هناك إلا شكل الوحدة الخارجى.
رئيس واحد، وعلم واحد، ونشيد واحد.
ولكن فيما عدا ذلك كل شىء يختلف بين الإقليمين.
وساعد على بقاء هذا الوضع طويلا، معظم الساسة السوريين، ممن انساقوا مع تيار الوحدة الذى ألحت الجماهير فى طلبه.
كانوا جميعاً يريدون. أن تبقى مصر فى مصر، وأن تبقى سوريا فى سوريا.
وكان ظهور قوى جديدة نتيجة للوحدة، يتعارض مع نظرتهم للأمور من أول يوم فى التجربة، فإن أى قوة جديدة كانت “أخذاً” منهم و”إضعافاً” لهم.
هكذا تحت علم الوحدة مضت نفس الأوضاع القديمة التى كانت فى سوريا من قبلها.
بل أكثر من ذلك استغل معنى الوحدة ذاته فى الصراع العنيف داخل سوريا.
كان كل واحد من ساسة سوريا يريد انتهاز الوحدة فرصة يتخلص بها من خصومه، ويضرب بها أعداءه.
كان حزب البعث يريد أن يجهِز على حزب الشعب. ويذبح ذبحاً كل أقطابه وكل أنصاره ويعتبرهم على حد تعبير رئيسه أكرم الحورانى “جواسيس وخونة”.
وكان السيد شكرى القوتلى يكره خالد العظم كراهية التحريم، ويتمنى لو انشقت الأرض فابتلعت أكرم الحورانى، ويحلم برصاصة من أى اتجاه تصيب عبدالحميد السراج، فإن العظم نافسه على رياسة الجمهورية، والحورانى تآمر عليه – كذلك يقول – والسراج لم يترك له من السلطة إلا مقعداً من الحرير مطرزاً بالقصب فى قصر المهاجرين!
وكان حزب الشعب يعتبر حزب البعث مسئولا عن كل خطأ، وشريكا فى كل انقلاب، ومدبراً لكل جريمة.
وكان حزب البعث فى نفس الوقت يكره عبدالحميد السراج ويركز عليه حملة من الكراهية المريرة.
وتلك نماذج. مجرد نماذج. والصورة بالتفصيل حكايتها طويلة.
ولكن المهم أن قوى الوحدة وجدت نفسها فى سوريا بعد إتمام الوحدة، وسط معركة واسعة المدى، ضاربة الجذور فى تاريخ سوريا الحديث، بعيدة الأثر على مستقبلها الذى كان لابد له أن يتشكل على أساس جديد، معركة لا يظهر أولها ولا يظهر آخرها!
وكان الفارق مخيفاً بين الأثر الذى أحدثته الوحدة كتيار شعبى عربى فى الأحداث الكبيرة كإبراز قوة اندفاع القومية العربية، وإسقاط حلف بغداد، وضرب التسلل الشيوعى فى المنطقة – وبين المشاكل الصغيرة التى واجهتها الوحدة داخل سوريا. مشاكل صغيرة ولكنها عرقلت حركة الشعب العملاق، لولا أن استطاع فى الدقائق الأخيرة أن يخلص نفسه، وأن يفجر قوانين يوليو الاشتراكية، إيذانا بأن عهد الثورة الاجتماعية قد بدأ. فى مصر وفى سوريا معاً وفى الأمة العربية بأسرها.
ولكن تجربة المشاكل الصغيرة فى سوريا فى عهد الوحدة تقتضى وقفة أطول قبل أن نمضى إلى المرحلة التى نعيشها الآن والتى تبدو من خلالها ملامح المستقبل.
(6) ما الذى جرى فى سوريا؟
المشاكل الصغيرة فى تجربة الوحدة وكيف عطلت زحف الشعب العملاق؟
الحملة النفسية العنيفة التى قصدت إلى تحطيم قوائم تجربة الوحدة
واليوم، وقفة سريعة، أمام تجربة المشاكل الصغيرة فى سوريا بعد الوحدة.
كانت مشاكل صغيرة، ولكن الشرارة قادرة على إشعال حريق!
ولقد قلت فى ختام حديثى فى الأسبوع الماضى:
“إن قوى الوحدة وجدت نفسها فى سوريا بعد إتمام الوحدة، وسط معركة واسعة المدى، ضاربة الجذور فى تاريخ سوريا الحديث، بعيدة الأثر على مستقبلها، الذى كان لابد له أن يتشكل على أساس جديد…. معركة لا يظهر أولها ولا يظهر آخرها.
وكان الفارق مخيفاً بين الأثر الذى أحدثته الوحدة كتيّار شعبى عربى، فى الأحداث الكبيرة، كإبراز قوة اندفاع القومية العربية، وإسقاط حلف بغداد، وضرب التسلل الشيوعى فى المنطقة - وبين المشاكل الصغيرة التى واجهتها الوحدة داخل سوريا… مشاكل صغيرة، ولكنها عرقلت حركة الشعب العملاق، لولا أن استطاع فى الدقائق الأخيرة، أن يفجّر قوانين يوليو الاشتراكية، إيذانا بأن عهد الثورة الاجتماعية قد بدأ فى مصر وفى سوريا معاً، وفى الأمة العربية بأسرها”.
وقبل أن أدخل فى تجربة المشاكل الصغيرة التى سببتها الأحقاد بين ساسة سوريا القدامى قبل الوحدة، ثم أثر هذه المشاكل على سير الحوادث خلال سنوات الوحدة ذاتها، فإنى أريد أن أستأذن فى ملاحظة عابرة، يقتضينى واجب الإنصاف أن أقولها.
لقد تعرض الذين تصدروا تيار الوحدة تحت ضغط الجماهير السورية المؤمنة عند القاعدة لحملة عنيفة مركّزة ومدروسة على أحدث نظريات الحرب النفسية.
كان هدف الحملة هو تدميرهم.
وكان فى منطق الاستعمار والقوى الرجعية التى تسنده ليسندها فى البلاد العربية أنه إذا تم تدميرهم، فإن ذلك يعنى تدمير القوائم التى تقف عليها تجربة الوحدة، وإذا ما تحطمت القوائم سقطت التجربة.
واستغلت الحملة العنيفة المركّزة المدروسة على أحدث نظريات الحرب النفسية، كل الظروف المعقدة داخل سوريا، وكل الظروف المعقدة من حول سوريا.
كانت الحملة تختار هدفها..
تختار واحداً من ساسة سوريا… وتركز على نقطة ضعف فيه ثم يشتد تركيزها ويتحول إلى إصرار عنيد.
ثم تستطيع أن تجذب معها كثيرين يشتركون معها فى الحملة ربما فيهم من ينجذب عن غير وعى وعن غير قصد… أو عن غير نظرة بعيدة لعواقب الأمور، وربما فيهم من كان ينجذب لشهوة التدمير فيه، أو ليخلص من خصم قديم.
مثل هذا تعرض له صبرى العسلى، وعفيف البزرى، ووزراء حزب البعث، ثم أخيراً عبد الحميد السراج.
كانت الحملة تمسك بتلابيب أحدهم…
تمسك به من نقطة ضعف فيه.
وتدق وتدق، وتظل تدق، وتجر كثيرين إلى مشاركتها فى الدق، حتى يتحقق هدف الحملة.
ولم يتردد واحد من ساسة سوريا وقت الوحدة عن الاشتراك فى كل حملة وجهت إلى غيره بقصد هدمه وتدميره.
وأقول إنصافاً للتاريخ وللحقيقة - إن القاهرة هى الأخرى لم تستطع أن ترى صورة العملية بوضوح، وفى بعض الأحيان مشت إلى الفخ المنصوب وكأن على عينيها حجابا، يجعلها لا ترى موقع خطاها وسط الزحام والظلام.
وهكذا بدأ الذين تصدروا موكب الوحدة، يختفون من صدر الموكب واحداً بعد واحد.
وبصرف النظر عن الظروف الموضوعية التى أحاطت بهم، فلقد كان اختفاؤهم، يساعد خطة الاستعمار وحملاته العنيفة المركزة المدروسة على أحدث نظريات الحرب النفسية.
هذه هى الملاحظة العابرة.
وبعدها، أستطيع أن أنتقل إلى تجربة المشاكل الصغيرة وقت الوحدة.
وكانت المشاكل الصغيرة، نوعين:
نوع يتعلق بالسياسة العامة.
ونوع يتعلق بالبشر وبالناس.
ولست أريد أن أتلكأ طويلاً عند المشاكل الصغيرة المتعلقة بالسياسة العامة، فإن الكثير منها تعرضت له فيما سبق من مقالات عن الذى جرى فى سوريا.
ولكنى أشير هنا إشارة سريعة إلى بعضها.
- مثلاً مشكلة التصنيع وفقاً لخطة محددة:
كانت مصر كما قلت فى بداية سنة 1958 منهمكة فى تنفيذ مشروع السنوات الخمس الأول للصناعة.
وكانت سوريا غير مستعدة بعد لمرحلة التصنيع، على الأقل بسبب نقص الدراسات العملية والعلمية.
وبدأت النغمة تتردد:
- أن القاهرة تريد أن تبقى سوريا بلداً زراعياً ليكون سوقاً لمنتجاتها الصناعية لا أكثر ولا أقل.
وبدأت القاهرة الحساسة فى ذلك الوقت تتحرك فى اتجاه تصنيع سوريا.
ولكن التصنيع كما يحدث فى كل بلد، خصوصاً عند بناء القاعدة الأولى فيه يحتاج إلى قيود، ويفرض شروطاً تقسو فى بعض الأحيان، ولكن النتائج تبرر فى النهاية قسوتها.
التصنيع فى حاجة إلى استثمارات.
التصنيع فى حاجة إلى توفير كل نقد أجنبى يصرف على السلع الاستهلاكية ويحتم تحويله إلى شراء الآلات والمعدات.
والتصنيع خصوصاً فى بدايته يحدث اختناقاً ملحوظاً فى السوق فإن أموالاً كثيرة تصب فى ميدانه، ثم تمضى سنوات ثلاث أو أربع قبل أن يتم بناء المشروعات المختلفة وقبل أن يبدأ إنتاجها.
وفى مصر مثلاً فى وقت من الأوقات كانت هناك ثلاثة مشروعات فقط، تجمد فيها لمدة معينة ما يقرب من مائة مليون جنيه.
وهى كهربة خزان أسوان، ومشروع السماد فيها، ومصنع الحديد والصلب.
ثلاثة مشروعات فقط تجمدت فيها مائة مليون جنيه وكان لابد أن ننتظر سنوات طويلة قبل أن نحصل على عائد منها.
وكان لابد أن يحدث مثل ذلك فى سوريا.
ولكن عملية التصنيع ما كادت تبدأ حتى بدأت النغمة تتردد:
- إن سوريا تعيش على التجارة… ولا تقبل هذه القيود المفروضة على الاستيراد وعلى النقد.
وتحولت المشكلة… لم تعد تصنيع سوريا أو عدم تصنيعها، وإنما أصبحت مسألة حرية التجارة… إطلاقها أو تقييدها!
حكاية ‘حزب البعث’ فى تجربة الوحدة - محمد حسنين هيكل
ما الذى جرى فى سوريا ؟ - حكاية حزب البعث في تجربة الوحدة’
ما الذى جرى فى سوريا؟
مازالت للحكايات الصغيرة بقية.
مازالت للحكايات الصغيرة، فى التجربة الكبيرة، أذيال تجر نفسها، وتجر بعضها، ولو أفسحت المجال لتفاصيلها لما انتهيت!
ولكنى أصل اليوم إلى حكاية حزب البعث فى تجربة الوحدة.
ولقد رويت فى الأسبوع الماضى حكاية “صبرى العسلى”، ورويت حكاية “عفيف البزرى” وفى التسلسل الزمنى للحوادث، بترتيب نهاياتها وليس بترتيب البدايات، فإن حكاية حزب البعث قد جاء دورها.
وحكاية حزب البعث ليست حكاية سهلة، وإن دخلت هنا فى عداد الحكايات الصغيرة التى عرقلت زحف الشعب العملاق، فى تجربته الأولى لتطبيق الوحدة العربية.
حكاية حزب البعث ليست سهلة لعدة أسباب تتعدد فى نظرى، وتشتبك أحياناً وتفترق، وتقوم - بالنسبة لى - على الوقائع التى شهدتها فى بعض الظروف، وفى ظروف أخرى تقوم على الانطباعات وعلى مجرد الإحساس.
ليست سهلة حكاية حزب البعث فيما يتعلق بى على الأقل.
أولاً - أنا واحد من الناس الذين أعجبتهم، فى الماضى آراء حزب البعث، وشعاراته، خصوصاً فى فترة الفراغ الفكرى، التى امتدت بين نهاية الحرب العالمية الثانية حتى تجلت إيجابية العمل الثورى فى مصر مع مطلع سنة 1955.
ولكنى حتى فى هذه الفترة، كنت واحداً -من الناس- الذين روعتهم طريقة حزب البعث فى ممارسة نشاطه العملى فى السياسة السورية خصوصاً فى ظروف الانقلابات العسكرية المتكررة فى سوريا ابتداء من انقلاب حسنى الزعيم على شكرى القوتلى حتى جاءت تجربة الوحدة سنة 1958، بل وحتى انتهت تجربة الوحدة سنة 1961.
كان التناقض بين “فكر” البعث و”سياسة” البعث يحيرنى.
كان “فكر” البعث “يضىء” أحياناً بومضات عن الوحدة وعن الاشتراكية وعن الحرية.
ولكن “سياسة” البعث كانت دائماً غارقة فى الظلام، فى المناورات وفى الدسائس، وفى المؤامرات فى كثير من الأحيان.
ثانياً - أنا واحد من الناس الذين كان يراودهم فى وقت من الأوقات أمل، بأن حزب البعث قد يقدر يوماً أن يحول “أفكاره” إلى “نظرية” عمل، أو شبه نظرية.
ولكنى واحد من الناس الذين طال انتظارهم على غير فائدة.
لقد مضت السنون بعد السنين وأفكار حزب البعث، فى أحسن أحوالها مجرد أفكار حالمة معلقة فى الهواء، لا تقترب من الواقع المعاصر، ولا تواجه مشاكله، ولا تحاول - حتى بالتجربة والخطأ - أن تباشر تأثيراً على اتجاهات التطور العربى، فى أى بلد عربى. ولا حتى فى سوريا.
كان حزب البعث على الورق حركة تقدمية.
ولكنه على الطبيعة، وخلال اشتراكه فى الحكم قبل الوحدة وبعدها لم يترك آثاراً تقدمية تدل عليه!
ثالثاً - أنا واحد من الناس الذين قرأوا لميشيل عفلق، فيلسوف البعث، ووعوا عنه بعض ما قرأوا له، وإن اختلفوا معه فى كثير مما قال.
وكنت أرى فى صلاح البيطار من على البعد، ملامح شاب ثائر.
وكان أكرم الحورانى، لغزاً محيراً لى، لا يستقر رأيى فيه على قرار.
ولقد تصورت أنه إذا ما أتيحت لى الفرصة أن أراهم عن قرب، فلربما منحتنى الفرصة مزيداً من الفهم.
وحين التقيت بميشيل عفلق، تبدد خيالى القديم عنه، كانت أفكاره تضيع منه ومنى فى الألفاظ، وكانت الألفاظ تضيع منه ومنى على لسانه، فلقد كان يستريح نصف ساعة بين الكلمة والكلمة، وكان الاستماع إليه فى المرات التى أتيح لى أن ألتقى فيها معه، عذاباً ليس فوقه عذاب!
وأما صلاح البيطار فلقد كان وقتى يضيع معه، وأنا أرقبه ساعة بعد ساعة، وهو يقرض أضراسه ويمضغها.
وأكرم الحورانى، زادت حيرتى فيه بعد لقائى معه، عما كانت عليه قبل هذا اللقاء، فلقد كان معظم ما سمعته منه لا يزيد على قوله أن فلاناً “آدمى”، وفلاناً الآخر “رذيل”.
ثم كانت النتيجة التى خرجت بها فى النهاية أن حزب البعث ضيع أفكاره فى المناورات الحزبية، وأن “ثورية” البعث المحتملة تاهت فى سراديب السياسة السورية وفقدت قدرتها على أن تتطور، ومن ثم فقدت قدرتها على المساهمة فى تطوير الواقع العربى.
رابعاً - أنا واحد من الناس الذين اكتشفوا بالتجربة أن ثمة خطاً فاصلاً، حقيقياً وموجوداً، بين قيادات البعث، وبين قواعد البعث.
ولقد ألمحت إلى القيادات بما يتضمن رأيى.
ولكن رأيى - حتى هذه اللحظة - أنه مازالت لقواعد حزب البعث فى كثير من البلاد العربية قيمة وطنية لابد أن يحسب حسابها فى الميزان.
لقد رأيت فى عدد من البلاد العربية شباباً كثيراً مازال يؤمن بما وصل إليه من أفكار حزب البعث وآرائه.
وبقدر إعجابى بهذا الشباب… كان إشفاقى عليه.
وإنى لأشفق على هذا الشباب اليوم، أكثر من أى يوم مضى، خصوصاً بعد الموقف الذى وقفته قيادات البعث الرسمية من الانقلاب الأخير على الوحدة فى دمشق.
ويوم وقف قادة حزب البعث فى دمشق يؤيدون الانقلاب على الوحدة، ويوقعون بإمضاء أكرم الحورانى، وصلاح البيطار، على البيان الذى وقعه عدد من ساسة سوريا القدامى بمهاجمة الجمهورية العربية المتحدة، هممت لوهلة بأن أمسك قادة حزب البعث وحدهم، دون جميع الذين وقعوا. وأرد عليهم.
هممت أن أقول لهم أن جزءاً كبيراً من أسباب فشل التجربة يقع عليهم، فلم يخرج دورهم فى تجربة الوحدة عن أحد موقفين:
- موقف المناورة والإحراج الحزبى، بغية أن يكون لهم وحدهم حق الحكم فى سوريا وحدها!
- ثم موقف السلبية المطلقة - بعد المناورة والإحراج - حتى تتأزم الأمور قدر ما يمكن أن تتأزم، ثم لا يكون هناك مخرج من الأزمة غير الاستجابة لشروطهم وهى أن ينفردوا وحدهم بسوريا وحدها!
هممت بأن أفعل ذلك، ثم تراجعت!
ومن أجل شباب البعث وحده، وليس من أجل قادته، تراجعت.
هذه صورة عامة فى التمهيد للحكايات الصغيرة من دور حزب البعث فى تجربة الوحدة.
وبعدها ندخل فى التفاصيل!
وأضيف، أننى سأدخل قليلاً فى التفاصيل، وليس كثيراً، ومن أجل شباب البعث التقدمى وحده هذا القيد الذى أفرضه على نفسى، وليس من أجل الدهاة من صناع المناورات والدسائس، أبطال الألعاب “المدهشة” على الحبال من زعماء البعث وساسته!
الحكاية الأولى من حكايات البعث، بدأت مع اليوم الأول، فى حكومة الوحدة.
بطلها صلاح البيطار.
وصلاح البيطار كان وزيراً لخارجية سوريا قبل الوحدة، وكان يريد أن يكون وزير الخارجية فى الجمهورية العربية المتحدة يوم أن قامت الوحدة.
وحين عرف صلاح البيطار أن الدكتور محمود فوزى سيبقى وزيراً للخارجية بعد قيام الجمهورية العربية المتحدة، لم يعجبه الحال.
قال رأيه بصراحة.
وقيل له:
- إن الجمهورية العربية المتحدة بعد قيامها مقبلة على أدوار دولية هامة والدكتور محمود فوزى شخصية دولية لها قيمتها، وفى طاقته جهد كبير يستطيع به أن يخدم القضية العربية دولياً كخير ما تكون الخدمة، خصوصاً وأن الدكتور فوزى وراءه تجربة دولية بعيدة، وله صداقات دولية واسعة.
وقيل لصلاح البيطار:
- إنك ستكون وزيراً للدولة فى الوزارة، وستكون الشئون العربية هى اختصاصك وفى هذا المجال تستطيع أن تقوم بالكثير.
وسكت صلاح البيطار، ولكن عدم اقتناعه كان واضحاً، من الطريقة التى راح يعد بها حبات السبحة التى يمسك بها فى يده.
ثم جاءت الحكاية الثانية بعد بضعة أسابيع من تجربة الوحدة.
ذهب صلاح البيطار ومعه ميشيل عفلق إلى مقابلة الرئيس جمال عبد الناصر وكانا يحملان وجهة نظر فى الحكم.
كانت وجهة نظرهما أن الوحدة لم تقع عملاً، وإن كانت قد وقعت شكلاً.
وقال جمال عبد الناصر:
- إنه يشعر أن ذلك صحيح، فإن فى دمشق حكومة وفى القاهرة حكومة، وليس بين الحكومتين من رباط إلا وجود رئيس واحد للجمهورية. وهذا وضع لا تتحقق به الوحدة عملياً على النحو الذى يفى بآمال الشعب فى الوحدة.
وقال صلاح البيطار:
- هناك، يا سيادة الرئيس، مسألة “المشاركة”، نحن نشعر أننا لا نشترك فى الحكم على مستواه الأعلى لهذا فإن لدينا اقتراحاً بتأليف مجلس منكم ومنا.
وقال جمال عبد الناصر أنه يريد مزيداً من الشرح.
واستطرد صلاح البيطار:
- إننا نرى أن يؤلف مجلس أعلى للدولة، ولو حتى بصفة غير رسمية، على أن يوكل إليه -تحت إشرافكم - أمر البت فى كل القضايا الرئيسية الهامة، ويكون هذا المجلس من ستة، ثلاثة منا وثلاثة منكم.
واستطرد صلاح البيطار:
- ثلاثة منا، هم أكرم الحورانى وميشيل عفلق وأنا، وثلاثة منكم وليكونوا المشير عبد الحكيم عامر والسيد عبد اللطيف البغدادى والسيد زكريا محيى الدين.
وقال جمال عبد الناصر:
- إن لى ملاحظات على هذا الرأى:
أولاً - إن معنى كلمة “منا” و”منكم” أنكم شىء وأننا شىء آخر مختلف وهذه لأول وهلة فى إحساسى انفصالية أكثر منها وحدة.
ثانياً - أن الثلاثة الذين اخترتموهم “منكم” كلهم من حزب البعث، ومعنى ذلك أننى أفرق بين “بعثى” وبين “سورى”، وحين صوت شعب سوريا على الوحدة، وقرر انتخابى رئيساً للجمهورية، كان الشعب السورى كله، هو الذى صوت وهو الذى قرر، فكيف أضع الآن فارقاً أميز به البعثيين على غيرهم من السوريين، ثم ماذا أقول للذين يشتركون معنا فى الحكم الآن من الوزراء السوريين.
وقال ميشيل عفلق:
- الواقع أن كثيرين من هؤلاء الوزراء يجب أن يخرجوا… عبد الحميد السراج مثلاً يجب أن يخرج.. وأمين النافورى كذلك.. لا نقول بخروجهم الآن ولكن نجعل ذلك فى حسابنا للمستقبل.
وقال جمال عبد الناصر:
- لا أتصور مثل هذا الرأى، لا أتصور أن يجلس معى الآن فى مجلس الوزراء وزير يشاركنى فى تحمل المسئولية، وأنا أعلم فى ذهنى أننى سوف أخرجه من الوزارة بعد شهور، كيف يمكن أن نعمل بهذا الشكل؟
واستطرد جمال عبد الناصر:
- ومن ناحية أخرى، من ناحية الاقتراح ذاته، فلست أتصور أنه من واجبنا أن نضع وصاية داخلية على الدولة.
وإنما الذى أتصوره واجبنا هو أن نقوى الدولة ونحقق توحيدها، وأن تكون هناك للجمهورية الواحدة، حكومة واحدة، ولقد كان فكرى أن أبحث هذا الأمر: نؤلف حكومة مركزية قوية للجمهورية العربية، ثم تكون هناك المجالس التنفيذية للإقليمين وفى داخل الحكومة المركزية يجرى بحث السياسة العليا للجمهورية ويتم رسمها بطريقة مفتوحة نشارك فيها جميعاً.
وانتهت المناقشة ولكن وجهة نظر حزب البعث تجلت من خلالها.
وجهة نظره أن يكون هو - حزب البعث - مقابل مجلس الثورة السابق فى مصر- ثم من ممثلى الاثنين معاً يقوم مجلس أعلى للدولة.
ثم جاءت الحكاية الثالثة، فى الأيام التالية مباشرة لثورة العراق… بعد أيام قليلة من ثورة العراق، سافر السيد ميشيل عفلق إلى بغداد وكانت فى بغداد حركة نشيطة للبعث العربى، وبدأ ميشيل عفلق ينادى فى بغداد بانضمام العراق إلى الجمهورية العربية المتحدة.
وفى الظروف العادية كان ذلك أمراً يمكن أن يمر بسهولة ويسر، ولكنه فى الظروف غير العادية التى صاحبت ثورة العراق، كان أمراً يقدر على خلق مشاكل لا أول ولا آخر لها.
فلقد استغل الحزب الشيوعى فى العراق نداء ميشيل عفلق بالوحدة، ورفع فى مقابله شعار الاتحاد.
ثم بدأت الفرقة والصراع فى العراق بين الوحدة والاتحاد.
واستغل اللواء عبد الكريم قاسم هذا الصراع ليضرب الوحدة والاتحاد معاً، بعضهما ببعض!
فى ذلك الوقت كان الرئيس جمال عبد الناصر قد وصل إلى دمشق عائداً من موسكو بعد لقائه الشهير مع خروشوف فى أعقاب ثورة العراق.
فى ذلك الوقت كان بين قادة البعث من يرى أن يطير عبد الناصر إلى بغداد وأن يتم على الفور دخول العراق إلى الجمهورية العربية المتحدة.
وكان جمال عبد الناصر يرى فى الأمر رأياً آخر.
كان يرى أولاً أن شعب العراق هو الذى صنع ثورة 14 يوليو ولابد لهذا الشعب نفسه أن يمارس حريته قبل أن يقرر مصيره بالوحدة أو الاتحاد.
وكان يرى ثانياً أن الاندفاع العاطفى سوف يخلق حساسية شديدة لدى قادة الثورة فى العراق خصوصاً وأن المعلومات بدأت تجىء مفصلة عن عقد اللواء عبد الكريم قاسم الذى صدره رفاقه فى الثورة لقيادتها الرسمية.
وكان يرى ثالثاً أن من الضرورى قبل أى شىء دعم التجربة الحالية للوحدة بين مصر وسوريا وإنجاحها وجعلها نموذجاً صحيحاً لفاعلية الوحدة عمقاً بدلاً من مجرد الاندفاع سطحياً فى فورة العاطفة خصوصاً فى الجو الدولى الملبد بالغيوم والعواصف وقتها، وعلى ضوء ما كان عبد الناصر يعرفه وحده من أن الاتحاد السوفيتى ليس مستعداً لمساندة القومية العربية فى صراعها مع الاستعمار إذا ما وصل هذا الصراع إلى نقطة الخطر.
وفى ذلك الوقت، قال الرئيس جمال عبد الناصر، للعقيد عبد السلام عارف الذى رأس وفداً يمثل ثورة العراق ليزور دمشق، قال له أمام الوزراء العراقيين الذين رافقوه فى رحلته، ما يلى:
- إننى أريدك أن تنقل إلى اللواء عبد الكريم قاسم وإلى جميع رفاقك فى قيادة ثورة العراق، أننا على استعداد لأن نتعاون معكم إلى غير ما حد، ودون ما قيد أو شرط فى جميع النواحى السياسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية.
وفيما يتعلق بما يطرح الآن من مناقشات حول موضوع الوحدة، فإن رأيى هو:
- أن شعب العراق فى حاجة إلى الشعور بحريته بعد الكبت الطويل قبل أن يمارس هذه الحرية فى تقرير مصيره ولا ينبغى أن يفرض عليه الآن شىء قبل أن تتاح له فرصة التثبت مما يريد.
- أن شعب العراق فى حاجة إلى الوحدة الوطنية داخل العراق، أكثر مما هو فى حاجة إلى الوحدة أو الاتحاد معنا.
وبعدها عندما عاد ميشيل عفلق، وكانت زيارته لبغداد قد انتهت بمشاكل وحساسيات لم يكن هناك مبرر لها، لم يقل له أحد:
- إن الذى قلته هناك قد حسب على الجمهورية العربية المتحدة، وهو الآن يستغل ضدها.
لم تكن هناك رغبة فى وضع قيد على رأيه.
لقد أكل هو الحصرم فى بغداد.
وضرست الجمهورية العربية المتحدة كلها… فى دمشق وفى القاهرة.
ثم تعاقبت حكايات كثيرة… رابعة وخامسة وسادسة.
- تواترت الأخبار من دمشق، بأن وزراء البعث لا يضعون غير البعثيين فى وزاراتهم.
أن بطاقة حزب البعث أصبحت جواز المرور إلى التعيين فى وظائف الدولة، كما أصبحت وسيلة الترقى إلى المناصب الكبرى فيها.
وقيل لحزب البعث فى رقة، فى منتهى الرقة:
- تذكروا أنكم لم تعودوا حزبيين بعد حل الأحزاب!
إننا نسلم أن جزءاً من الحملة عليكم مفتعل لإحراجكم.
ولكن ثمة شىء من الصحة فيما يقال عن التحزب للبعثيين، وكل الذى تفعله الحملة هو أنها تضع منظاراً مكبراً تحاول به تجسيد الخطأ وتعطيه شكلاً يزيد كثيراً عن حقيقته!
- ثم بدأ الكلام عن نشاط بعثى فى داخل الجيش الأول.
ثم وصل الأمر إلى حد أن السيد أكرم الحورانى حاول أن يتدخل صراحة فى تنقلات الجيش.
ثم أبدى رأيه مرة بضرورة عزل الفريق جمال فيصل قائد الجيش الأول واقترح تعيين السيد مصطفى حمدون وزير الإصلاح الزراعى فى ذلك الوقت قائداً للجيش الأول.
وكان الرأى الذى قيل له:
- لا ينبغى أن نجعل الحزبية تعود إلى الجيش.
إن الجيش الأول فى حاجة إلى جهد كبير فى التدريب، وينبغى أن نوفر له الجو الملائم، الذى يحقق له تكريس جهده كله إلى مسئوليته، وإلى احتمالاتها المقبلة.
ثم كان فى أعقاب هذا كله أن بدأ البعث نفسه يشكو مما يلاقيه فى سوريا وركب صلاح البيطار طائرة ذات يوم إلى القاهرة ليقول للرئيس جمال عبد الناصر:
- إن حزب البعث يلاقى عنتاً واضطهاداً فى سوريا من عبد الحميد السراج.
وقال الرئيس جمال عبد الناصر:
- إننى لا أرضى بأن يتعرض حزب البعث لأى عنت واضطهاد…
وبدأ صلاح البيطار يتحدث عما سمعه فى سوريا مما يلاقيه أعضاء الحزب أو المنتمون إليه.
وخرج صلاح البيطار، وبعث الرئيس عبد الناصر بإشارة إلى دمشق يطلب من عبد الحميد السراج ركوب أول طائرة إلى القاهرة.
وتحدث الرئيس مع عبد الحميد السراج فيما سمعه من صلاح البيطار.
وقال عبد الحميد السراج: إنه يتمنى لو أنه سمع وقائع محددة تثبت عليه مسئولية ما يوجه إليه.
وقال الرئيس:
إننى أرى أن مواجهة الأمور صراحة هى السبيل الوحيد.
ثم رفع سماعة تليفون من فوق مكتبه وطلب إخطار السيد صلاح البيطار أن يتوجه فوراً من حيث يكون إلى مكتب الرئيس.
وبعد ربع ساعة جاء صلاح البيطار ليجد عبد الحميد السراج جالساً ينتظره…
وقال الرئيس:
- صلاح… لقد رأيت أن لا ندور حول المسائل لكى لا نتوه فيها، لقد قلت لى أمس أن عبد الحميد السراج يتبع سياسة العنت والاضطهاد ضد البعث وأنا أريده أن يسمع منك كل ما سمعته أنا بالأمس حتى تظهر الحقيقة، فإنى أخشى أن يكون هناك من يسعى لتسوئ العلاقات بينكما… لذلك أريدك أن تتكلم مع عبد الحميد بكل ما عندك… بكل تفاصيله.
وبدأ صلاح البيطار يرسم صورة جو عام.
وعبد الحميد السراج يلح فى طلب وقائع محددة!
وانتهت الجلسة دون نتيجة حاسمة وإن بدا واضحاً أن عناصر كثيرة تحاول إثارة زوابع لا ضرورة لها داخل سوريا خصوصاً بين الذين يتصدرون الحكم من السوريين.
ثم جاءت حكاية انتخابات الاتحاد القومى… انتخابات القاعدة الشعبية فى ذلك الوقت.
وقام خلاف فى وجهات النظر.
كان حزب البعث يرى أن يمارس وزير الداخلية حق شطب أسماء من يجرى الاعتراض عليهم من المرشحين.
وكان الرأى الآخر هو أن الشطب لا ضرورة له فى انتخابات القاعدة الشعبية خصوصاً وأن تطبيقه عملياً سوف يكون مسألة صعبة.
كان عدد المرشحين فى مصر 120 ألفاً.
وكان عددهم فى سوريا عشرة آلاف.
فكيف يمكن أن يجرى الشطب وعلى أى قاعدة وعلى أى أساس.
فى ذلك الوقت قال الرئيس جمال عبد الناصر للسيد أكرم الحورانى:
- لقد جربنا الشطب فى انتخابات مجلس الأمة سنة 1957، ولقد أحسست وقتها أن ثمة شعوراً عاماً بأن الشطب يؤثر - فى تصور الناس - على سلامة عملية الانتخابات.
ومن ناحية أخرى فإن ممارسة حق “الشطب” فى انتخابات القاعدة الشعبية من أجل خلق تنظيم سياسى معناه أننا نصنع المعارضة قبل أن نصنع التنظيم السياسى.
ثم كيف يمكن أن تجرى التحريات عن كل هذا العدد من المرشحين لكى يكون الشطب على أساس وقاعدة؟
وزارة الداخلية مثلاً؟ كيف تستطيع؟
أنت مثلاً..؟ هل تعرف كل هؤلاء الناس المتقدمين للترشيح فى سوريا؟
إذن، ماذا سيكون الحل؟
سوف تسمع كلام بعض الناس ممن تعرفهم فى الآخرين ممن لا تعرفهم وكل واحد سوف يصور لك غيره على هواه.
ثم كان موقف حزب البعث بعد ذلك من انتخابات القاعدة الشعبية غاية فى العجب.
تجلى أن الحزب مختلف مع غيره ومختلف مع بعضه أيضاً.
فريق قرر دخول الانتخابات على أساس عدم الشطب، وفريق قرر أن لا يدخل من غير شطب لمنافسيه، ثم بدأ قسم من الفريق الذى قرر الدخول ينسحب فى اللحظات الأخيرة للانتخابات بحجة أن عبد الحميد السراج وزير الداخلية وقتها يتدخل ضده!
ثم جاءت الحكاية الحاسمة التى خرج فيها وزراء البعث من الوزارة.
بدأت الحكاية مع الظروف التى كان السيد مصطفى حمدون وزير الإصلاح الزراعى- وأحد وزراء حزب البعث وواحد من أحسنهم للحقيقة والتاريخ - يمارس بها تنفيذ قانون الإصلاح الزراعى.
فى بعض الظروف كان يبدو أن مصطفى حمدون ينفذ القانون بطريقة عنيفة، تجعل من السهل تصوير تصرفه وكأنه من وحى شهوة للانتقام.
ثم جاءت واقعة محددة بالذات متعلقة بأرض واحد من كبار الملاك من أسرة الجابرى فى حلب وهو رشاد الجابرى فيما أتذكر.
وكان قانون الإصلاح الزراعى يعطى مالك الأرض حق اختيار نصيبه الباقى له بعد تطبيق القانون، ولكن مصطفى حمدون رفض أن يترك لرشاد الجابرى هذا الحق وصمم على أن يختار له هو قطعة الأرض التى يحتفظ بها.
ويومها سُئل مصطفى حمدون:
- لماذا تقف هذا الموقف مع أن نص القانون صريح؟
وقال مصطفى حمدون:
- إن رشاد الجابرى أحد عملاء حلف بغداد!
وقيل لمصطفى حمدون:
- ولكن تلك مسألة، وهذه مسألة مختلفة…
إذا كان القانون يعطيه حقاً فلا يجب أن نمنعه عنه، وإذا كان فى تصرفاته ما يمس وطنيته فليس هناك ما يمنع من محاكمته، ولكن المسألتين يجب أن تظل كل منهما فى معزل عن الأخرى.
فى ذلك الوقت كان المشير عبد الحكيم عامر فى دمشق…
وفى ذلك الوقت كان الحل الذى وجدء لمواجهة الأزمة هو تأليف لجنة خماسية تتولى تطبيق قانون الإصلاح الزراعى تحت إشراف مصطفى حمدون.
ولكن مصطفى حمدون قدم استقالته وبعث المشير عبد الحكيم عامر باستقالة حمدون إلى القاهرة، ومعها خطاب شخصى منه إلى رئيس الجمهورية يرجوه فيه أن لا يقبل استقالة حمدون باعتباره شاباً وطنياً مخلصاً.
وفجأة تقدم السيد عبد الغنى قنوت وزير الشئون البلدية والقروية - وأحد وزراء حزب البعث - باستقالة ثانية.
وتلقى المشير عبد الحكيم عامر رسالة من القاهرة تطلب إليه إخطار الوزيرين المستقيلين، مصطفى حمدون وعبد الغنى قنوت بالسفر إلى القاهرة، لمقابلة رئيس الجمهورية ظهر الغد.
وكان اليوم، يوم 23 ديسمبر 1959… ذكرى عيد النصر الثالث فى بورسعيد.
وعاد جمال عبد الناصر من بورسعيد بالقطار ومعه على مائدة العشاء فى القطار يومها السيد أكرم الحورانى والسيد صلاح البيطار.
وكان كل شىء يبدو هادئاً وطبيعياً.
ووصل القطار إلى القاهرة. ثم يبدو أن أكرم الحورانى وصلاح البيطار سمعا بما حدث فى دمشق، أو كانا يعلمان به ويخفيان ما يعلمان، وإذا كل منهما فى الصباح يكتب استقالته من الوزارة ويسارع بكل وسيلة على عجل ليصل بها إلى رئيس الجمهورية قبل موعده عند الظهر مع مصطفى حمدون وعبد الغنى قنوت.
وكان وصول الاستقالتين مفاجأة غير متوقعة.
ولكن دلالتها كانت خطيرة بما تضعه من شوائب على روح الثقة وعلى توفر الإخلاص لدى الذى يواجهون المسئولية الواحدة.
وفى ذلك الوقت وصل إلى دار الرئيس كل من السيدين مصطفى حمدون وعبد الغنى قنوت…
وقال لهما الرئيس عبد الناصر:
لقد أردت أن أقابلكما وفى ذهنى أن أقول لكما أننى أرفض الاستقالة، وأن كلاً منكما مجند فى خدمة الجمهورية ولكن الموقف تغير الآن.
لقد تلقيت استقالتين من أكرم الحورانى وصلاح البيطار.
ولقد جعلنى ذلك أحس أن الأمور تجرى بالمنطق الحزبى فى وزارة ائتلافية.
وأنا أعتبر هذا الوضع إخلالاً بما اتفقنا عليه جميعاً من مقتضيات المرحلة الحاضرة، فلسنا هنا نمثل أحزاباً… ولسنا وزارة ائتلافية لمجموعة متضاربة المصالح من الأحزاب.
لهذا فلسوف أقابلكم مرة ثانية بعد أن أرى أكرم الحورانى وصلاح البيطار.
ودعى السيد أكرم الحورانى لمقابلة رئيس الجمهورية، وقال له الرئيس:
- لقد كنت معى بالأمس وكنا نتناول العشاء معاً، وكان الحديث بيننا متصلاً، ثم أفاجأ اليوم باستقالة تقدمها لى… كيف يمكن أن أفسر هذا؟
وظل أكرم الحورانى صامتاً ثم جاء دور صلاح البيطار، ولم يكن صامتاً كأكرم الحورانى، وإنما ركز المشكلة كلها فى قوله:
- إن عبد الحميد السراج هناك وحده فى سوريا… ونحن هنا بعيدون فى مصر!
وعاد مصطفى حمدون وعبد الغنى قنوت إلى مقابلة ثانية مع رئيس الجمهورية.
وروى لهما الرئيس تفاصيل مقابلته مع أكرم الحورانى وصلاح البيطار وكيف أنه قرر قبول استقالات وزراء حزب البعث.
ثم قال جمال عبد الناصر:
- لم أكن أريد أن تصل الأمور إلى هذا الحد، ولكن ما حدث والطريقة التى حدث بها أقنعتنى أن أساس الثقة لم يعد قائماً.
وانتقل الحديث بعد ذلك إلى كلام عن الذكريات وعن الآمال، وعن أيام مضت وأيام ستجىء.
وخرج مصطفى حمدون وعبد الغنى قنوت وفى عينى كل منهما دموع طيبة صادقة ومخلصة.
ولقد اختصرت الحكايات طويلاً - كما قلت - ولم أدخل إلى تفاصيل التفاصيل.
من أجل قواعد حزب البعث أولاً وليس من أجل زعاماته.
ثم لكى لا يطول الحديث إلى غير ما نهاية. وأنسى فى الماضى القريب نفسى.. ولا أمد البصر إلى المستقبل وهو أهم.
ومع ذلك فمازالت بين الحكايات، واحدة باقية هى حكاية عبد الحميد السراج.
محمد حسنين هيكل: حكاية عبد الحميد السراج
بصراحة بقلم محمد حسنين عيكل : (8) ماذا جرى فى سوريا؟ حكاية عبدالحميد السراج
ولقد وصلت الآن إلى حكاية عبدالحميد السراج فى تجربة الوحدة.
وصلت إلى الحكاية على طريق الشوك.
والشوك على طريق هذه الحكاية بالذات أسبابه كثيرة.
– سبب منها، شخصى بحت، أعترف به فى مقدمة هذا الحديث، مع تسليمى الكامل، بأن مثل هذا السبب ليس عنصراً له أهميته حين التصدى لمحاولة تحليل الظروف فى حدث كبير من أحداث التاريخ.
هذا السبب هو أننى أحب عبدالحميد السراج – ومازلت – برغم أخطائه التى لا أغمض عينى عنها – أشعر أنه شاب عربى قومى مخلص.
وسبب منها، أن حكاية عبدالحميد السراج نزل عليها ستار من الظلام الكثيف عقب الانقلاب على الوحدة فى سوريا، ولست أعرف خلال هذا الظلام الكثيف، أو بمعنى أدق لست أرى – أين يقف عبدالحميد السراج الآن، وما هو رأيه فيما حدث؟ كل ما أعرفه أن عبدالحميد السراج معتقل، وأن صاحب الجلالة الملك سعود – بالذات – يطالب برأسه لكى يحمل إليه – حيث يكون – على طبق من ذهب!
– وسبب منها – ثالث وأخير – هو أن القراء الذين يتابعون هذه السلسلة من المقالات باهتمام – كرماً منهم وحسن ظن – لم يتركونى حتى أنتهى من كتابة حكاية عبدالحميد السراج، وإنما سبقونى إليها بمجرد أن أشرت فى الأسبوع الماضى إلى أن دور عبدالحميد السراج قد جاء فى تجربة الوحدة.
ما كادت هذه الإشارة تظهر فى ختام مقال الأسبوع الماضى، حتى وجدت سيلاً من الخطابات يقتحم مكتبى.
وكان واضحاً من هذا السيل أن هناك تيارين يتنازعان الرأى العام فيما يتعلق بعبدالحميد السراج.
تيار عبّر عن نفسه بعبارة فى أحد الخطابات التى تلقيتها تقول:
“لا تقل بالله كلمة تسئ إلى عبدالحميد السراج، لقد عمل من أجل الوحدة ما لم يعمله غيره، بل لقد جرب الذين قاموا بالانقلاب على الوحدة فى دمشق أن يجروه إلى التعاون معهم، ولكنه رفض، فى حين أن الذين كانوا يناصبونه العداء، هرولوا إلى الخضوع للانقلاب ووضع توقيعاتهم بالخط الكبير على بيانات رسمية بتأييده وبالسمع والطاعة له”.
وتيار آخر عبّر عن نفسه بعبارة مختلفة فى خطاب آخر مما تلقيته من خطابات. جاء فيها:
“ربما دفعتك محنة عبدالحميد السراج الحالية ووجوده فى سجن المزة إلى الدفاع عنه. إن الشعب العربى فى سوريا ممكن أن يغفر كل شىء إلا الدفاع عن السراج فهو المسئول الأول عن هذه النكسة، يكفى أنه وهو، يزعم السيطرة على كل شىء فى سوريا، لم يعرف هذا الانقلاب الذى يدبر منذ سنوات ضد الوحدة، أما إذا كان يعرف، ولم يفعل شيئاً فالمصيبة أدهى!”
طريق الشوك إذن طريقى إلى حكاية عبدالحميد السراج.
من عاطفتى الخاصة له.
من الغموض الذى يحيط به، ويحيط بمصيره.
من موقف الرأى العام نحوه، وبروز تيارين فيه يتصارعان معاً ولا يلتقيان أبداً.
ولكن الذى يسهل الأمور علىّ إلى حد بعيد هو اقتناعى الكامل، بأننى هنا لا أكتب تاريخاً، فإن الشرط الأساسى لكتابة التاريخ بصدق وأمانة، هو أن تكون حوادثه قد ابتعدت طويلاً مع السنين، وهدأت فيها حرارة العواطف مهما كان اتجاهها، وتجردت الوقائع كلها من أى أثر للانفعال.
وحكاية عبدالحميد السراج، مازالت حية.
ولست أدعى لنفسى التجرد، وكل ما أتمنى أن أدعيه لنفسى لو استطعت، هو أن أكون صادقاً مع نفسى فى رواية الحوادث بقدر ما أراه بالفعل منها، وليس هذا تجرداً، فإن كل إنسان يحكمه تكوينه الفكرى فى نظرته إلى الحوادث، مهما طلب الصدق وألح فى طلبه، وأنا واحد من الذين يقولون بأنه لا شىء يمكن أن يوجد فى فراغ، حتى الحقيقة ذاتها، ومعنى ذلك أن الحقيقة فى تصورى، كالهواء الذى يملأ غرفة مكتبى، تحدده جدران الحائط وزواياه وارتفاعاته.
ولكنى أكاد أستطرد إلى بحث فلسفى، يبعد بى عن حكاية عبدالحميد السراج!
وإذن أعود إلى وقائعها!
من أين تبدأ حكاية عبدالحميد السراج؟
والرد على هذا السؤال:
– إنها تبدأ من قبل الوحدة بكثير، بل إن دراسة هذه الحكاية فى بدايتها من قبل الوحدة، أكثر ضرورة لمتابعة استمرار هذه الحكاية – طبيعياً – بعد الوحدة.
لمسات الضوء فى صورة عبدالحميد السراج لمعت قبل الوحدة.
ولمسات الظل فى صورة عبدالحميد السراج لفها الغموض من قبل الوحدة.
ولمسات الضوء فى صورة عبدالحميد السراج، فى رأيى ثلاث:
1- كان عبدالحميد السراج فى الفترة الحرجة، من سنة 1954 إلى سنة 1958 أيام ضغط حلف بغداد على سوريا، وأيام محاولة الحزب الشيوعى للسيطرة على سوريا، واحداً من مجموعة الشباب الوطنى فى الجيش السورى، الذين قدروا على حماية استقلال سوريا، وصمدوا لمختلف أنواع المؤامرات، سواء منها التآمر بالإغراء أو التآمر بالإرهاب، أى التآمر بسلاح المال أو التآمر بسلاح القتل، كان عبدالحميد السراج واحداً من هذه المجموعة من الشباب الوطنى. بل كان بحكم عمله فى رئاسة المكتب الثانى – المخابرات – أظهر أفراد هذه المجموعة فإن منصبه يعرضه ويفرض عليه بدوره أن يتعرض، لمواجهة هذه المؤامرات، بكشفها وتحطيمها.
2- كان عبدالحميد السراج، فى اليوم الأول من شهر نوفمبر 1956، هو الذى أخذ على عاتقه عملية نسف أنابيب البترول القادمة من العراق عبر سوريا إلى البحر.
وكان نسف أنابيب البترول، وتوقف تدفقه من العراق عبر سوريا إلى البحر، خصوصاً بعد إغلاق قناة السويس بحكم العمليات العسكرية الهائلة التى دارت خلال معارك العدوان الثلاثى على مصر فى تلك الفترة، عاملاً هاماً من عوامل النصر الذى أحرزته قوى القومية العربية ضد قوى الاستعمار وأدواته التى أرادت فى ذلك الوقت توجيه الضربة الساحقة إلى قاعدة التحرر العربى فى مصر سنة 1956.
ولقد ثارت عليه بسبب ذلك ثائرة الوزارة القائمة بالحكم فى سوريا وقتها واتهمته بتعريض سلامة سوريا للخطر.
ولكن ما حدث. كان قد حدث فعلاً. ولم تصل ثورة الوزارة إلى نتيجة، بحكم الأمر الواقع. وبحكم العجز أيضاً!
3- كان عبدالحميد السراج هو بطل قصة ملايين الملك سعود الشهيرة التى أرادت أن تتآمر على الوحدة فى يومها الأول.
وصحيح أن وسطاء الملك سعود حاولوا الاتصال بمجموعة الضباط الوطنيين فى الجيش السورى فى ذلك الوقت كلهم، وصحيح أن هؤلاء جميعاً حولوا الموضوع بأكمله إلى عبدالحميد السراج بوصفه رئيس المكتب الثانى ليتولى تسجيل المؤامرة وكشفها ولكن عبدالحميد السراج، تلقى باسمه مليوناً وسبعمائة وخمسين ألف جنيه إسترلينى، ولم يستطع هذا المبلغ الطائل الذى تتحطم أمامه مقاومة كثيرين، أن يكون بالنسبة لعبدالحميد السراج، إلا دليلاً فى قضية. لا أكثر ولا أقل.
لم يفكر عبدالحميد السراج لحظة فى قيمة شيكات الملك سعود كأموال.
وإنما كان فكره فيها طول الوقت أنها مجرد وثائق تدين الملك وتثبت عليه التآمر وتكشف الرجعية العربية أمام الرأى العام العربى.
هذه لمسات الضوء فى الصورة، وفيها دون جدال ومضات باهرة ثم أنتقل إلى لمسات الظل!
لمسات الظل ثلاث أيضاً!
1- القوة، فى تقديرى هى لمسة الظل الأولى فى شخصية عبدالحميد السراج وأعنى بالقوة هنا. تجميعها والإمساك بها ولَمّ خيوطها جميعاً فى قبضة يد واحدة.
كان عبدالحميد السراج – ولقد أكون مخطئاً – يحب القوة، وحب القوة يحمل فى طياته الرغبة فى الانفراد بها، فإن الذى يحب القوة يعتقد أن توزيعها على الأيدى الكثيرة ينتقص من إحساسه بها فى يده.
من هنا، لم يكن عبدالحميد السراج، وسط الكتل المتصارعة فى الجيش السورى قبل الوحدة يمثل كتلة أو يقود مجموعة، كان بعيداً عن كل الكتل والمجموعات، وكان فى نفس الوقت على اتصال بها جميعاً، وإن كان سنده الرئيسى هو كتلة الضباط الوطنيين فى الجيش.
وحين صدرت سنة 1957 حركة تنقلات فى الجيش – صدرت بتحريض الملك سعود وضغطه على شكرى القوتلى وبمساندة أمين النفورى الذى كان رئيس الشعبة الأولى فى الجيش وقتها – وتضمنت هذه الحركة نقل عبدالحميد السراج من منصب رئيس المكتب الثانى – أى المخابرات – كانت كتلة الضباط الوطنيين هى التى هددت بإجراء انقلاب إذا لم يبق عبدالحميد السراج فى مكانه. وبقى.
وليست القوة ظلاً، ولكن الظل يلحق بها إذا كانت القوة غاية ولم تكن وسيلة.
القوة مطلب للثائر لأنها أداة تغيير ثورى والسلطة طاقة دافعة تستطيع أن تفرض الفكرة المثالية على التجربة وتمنحها فرصة الحياة.
وليست القوة غاية فى حد ذاتها وليست السلطة رغبة شخصية وإلا أصبحت مقدمة ضاعت منها نتيجتها وإلا خطوة تعلقت فى الهواء دون مقصد أو هدف!
2- وتقودنى هذه النقطة إلى لمسة الظل الثانية فى عبدالحميد السراج.
هذه اللمسة هى أن عبدالحميد السراج لم يكن بطبيعته، أو بحكم ما أحاط به من ظروف، ثورياً اجتماعياً.
من هنا فإن القوة فى يده وصلت إلى طريق مسدود.
لقد جمع فى يده من السلطات قبل الوحدة، ما لم يتجمع فى يد فرد.
فى درج مكتبه كل المفاتيح، وأصابعه على كل الأزرار.
ولكن ماذا بعد ذلك؟
لم تكن القوة فى يده إلا صراعاً على القمة، من أجل مزيد من السلطة، ولكن القوة لم تواصل سيرها من يده لتنزل إلى الجماهير السورية لتكون أداة مؤثرة وقوة دافعة لنضال الشعب وإن كنت هنا لا أقلل من قيمة الدور الذى لعبته القوة التى ركزها عبدالحميد السراج فى يده فى حماية الاستقلال السورى قبل الوحدة.
3- من هذه النقطة أيضا جاءت لمسة الظل الثالثة فى شخصية عبدالحميد السراج، وتلك هى إيمانه بالوسائل البوليسية.
كان يريد أن يعرف كل شىء عن كل الناس، لا تفوته حركة، ولا تفلت سمعه همسة.
وفى الدعايات التى توجه ضد الجمهورية العربية الآن، ما يقال من أن عبدالحميد السراج كان يراقب جميع تليفونات خصومه، ولكن الذى لم يقله أحد – وإن كان حقيقة – هو ما تبين من أن عبدالحميد السراج كان يضع تليفونات زملائه فى الوزارة أنفسهم تحت الرقابة!
ونتيجة لهذا فإن جهاز البوليس تحت إشرافه توغل واستشرى.
هنا أيضاً لم يعد جهاز البوليس وسيلة تحمى المجتمع وتخدم القانون.
وإنما فى بعض الأحيان فلت جهاز البوليس فأصبح فوق المجتمع وفوق القانون وكانت هذه بالذات. أعقد المشاكل فى سوريا.
ولقد كنت أسمع كثيراً عن جهاز عبدالحميد السراج البوليسى ولم أكن أصدق.
حتى جربته بنفسى. ورأيته بعينى وجهاً لوجه.
فى ليلة من ليالى أكتوبر سنة 1959، كنت فى دمشق، وكان المشير عبدالحكيم عامر قد وصل إليها منذ أيام فى مهمة رسمية.
فى تلك الليلة، قابلت فى فندق أمية الجديد، الصحفى الأمريكى المشهور هارى إيليس، وكان قد جاء من بيروت بناء على موعد مع المشير عبدالحكيم عامر حدده المكتب الصحفى لسفارة الجمهورية العربية المتحدة فى بيروت.
وقال لى هارى إيليس:
– لقد عدت الآن فوراً من موعد مع المشير عبدالحكيم عامر.
وجلست مع هارى إيليس فى بهو فندق أمية نتحدث معاً فى قصص وذكريات وتجارب واجهناها معاً أيام كنا مراسلين حربيين فى كوريا قبل ما يقرب من عشر سنوات.
وتركت هارى إيليس وصعدت إلى غرفتى فى الفندق لأنام.
ولم تمضِ إلا بضع دقائق حتى سمعت طرقة على الباب، وفتحت وإذا شاب يقدم لى نفسه باعتباره من المكتب الثانى. ودهشت.
وقال الشاب فى رقة وأدب شديدين:
– سيدى. ألم تكن الآن مع هذا الصحفى الأمريكى. “إيليس”؟
قلت له: نعم!
قال: عرفنا أنه قابل المشير الليلة.
قلت: هكذا سمعت منه!
قال: ألم يقل لك ماذا سمع من المشير؟
وتحولت دهشتى إلى ذهول، وقلت له:
– هل تسمح لى أن أسألك. لماذا تريد أن تعرف؟
قال ببساطة:
– لأكتبه فى التقرير!
قلت:
– تقرير. لمَن سوف تكتب التقرير؟
قال:
– لوزير الداخلية.
قلت:
– لا أظن أن وزير الداخلية – السيد عبدالحميد السراج – يحتاج إلى تقرير فى هذا الأمر، إن حديث إيليس دار مع المشير، ويستطيع وزير الداخلية أن يسأل فيه المشير رأساً.
قال الشاب بحزم:
– سيدى. ظننتك تستطيع مساعدتى بدل أن أسأل الرجل الأجنبى نفسه.
وأحسست بقلق، لقد تصورت ما يمكن أن يحدث لو ذهب هذا الضابط الشاب من المكتب الثانى إلى هارى إيليس وسأله عن حديثه مع المشير عبدالحكيم عامر.
ما الذى يمكن أن يفهمه هارى إيليس من هذا الوضع؟
أغلب الظن أنه كصحفى مجرب وقديم، سوف يفهم منه الكثير.
وقررت على الفور أن لا أترك الأمر.
سكتّ لحظة ثم قلت لضابط المكتب الثانى الشاب:
– اسمع. ما رأيك لو انتظرت إلى الصباح وأنا أعطيك كل ما سمعته من هارى إيليس عما دار بينه وبين المشير.
قال الضابط الشاب:
– ألا تستطيع أن تفعل ذلك الآن؟
قلت:
– نحن الآن فى الواحدة من الصباح، ولقد كنت على وشك أن أنام كما ترى، والمسألة كلها بضع ساعات.
قال الضابط الشاب:
– فى الصباح الباكر. حتى أكتب تقريرى قبل أن تفتح الدوائر الحكومية.
قلت: فى السابعة صباحاً سوف أكون تحت أمرك.
وأقفلت الباب وأنا أفكر كيف أتصرف فى الأمر بهدوء، كان همى كله أن لا تبدو الجمهورية العربية المتحدة أمام صحفى أجنبى غريب فى صورة تثير فضوله، ومن يدرى ماذا يمكن أن تثيره بعد الفضول! ثم وصلت إلى حل، ورفعت سماعة التليفون وطلبت هارى إيليس وكان ينزل فى نفس الفندق قلت له:
– هارى. يبدو أن صحفياً آخر حصل على حديث من المشير. وفى رأيى أن لا تنتظر للغد حتى تبرق بحديثك معه ويسبقك الصحفى الآخر.
إنك لن تجد مكتب البرق مفتوحاً فى دمشق الآن، لهذا فإنى أقترح عليك أن تركب سيارتك فوراً إلى بيروت وتبرق بحديثك مع المشير قبل الفجر وتسبق به غيرك!
واعتبرها الصديق الطيب جميلاً أسديته إليه تطوعاً ووفاء.
وظللت بعدها أشعر بوخز الضمير. ولكن المهم أن هارى إيليس خرج من دمشق ووصل إلى بيروت قبل الصباح.
ودق جرس التليفون بجوار سريرى فى الساعة السابعة صباحاً.
وكان المتحدث هو ضابط المكتب الثانى الشاب يذكرنى بموعده معى.
وقلت له:
– متأسف. هل تتركنى لأنام.
قال:
– ولو. أما وعدتنى أن تحكى لى ما قاله لك إيليس من حديث المشير معه.
قلت له ببساطة:
– لم يقل لى شيئاً فى هذا الموضوع.
قال بحدة:
– شو هَا الحَكِى.
قلت بهدوء:
– هذا ما حدث!
وأقفل التليفون غاضباً، ولكن الصمت فى الحجرة بعد بضع دقائق تمزق وتبدد من طرقات عنيفة على الباب، وقمت لأفتح، وكان هو بنفسه ضابط المكتب الثانى الشاب. جاء ثائراً غاضباً بعد أن عرف أن هارى إيليس نفسه غادر الفندق فى الفجر وانطلق على طريق بيروت!
ولقد أطلت فى هذه الحكاية عن عمد. فهى فى رأيى ترسم صورة عشتها بنفسى ورأيتها.
وهذه أول مرة أسمح لنفسى أن أرويها، وإن كانت قد أثارت فى عديد من المناسبات أسئلة كثيرة فى خاطرى.
مثلاً. هل يعرف عبدالحميد السراج بما كان يفعله ضابطه الشاب؟
مثلاً. هل يمكن أن تصل الأمور إلى هذا المدى بغير علمه؟
مثلاً. إذا كان هذا يمكن أن يحدث معى- وأنا صحفى – يملك أن يكتب وأن يتكلم، فما الذى يمكن أن يحدث مع غيرى ممن لا يملك وسيلة للكتابة أو للكلام؟
ومثلاً. وهذا هو الأهم. إننى أجىء إلى دمشق زائراً ثلاث مرات أو أربعاً فى السنة. فما الذى يحدث للذين يعيشون فيها طول السنة؟
ولست أريد أن أقسو على عبدالحميد السراج، فلقد يكون فيما جرى، لغيرى ولى، كثير لا يعلمه. ولكن المشكلة أن الأجهزة البوليسية إذا تركت من غير حدود تقف عندها فإنها تكتسب طبيعة سرطانية، قاسية ومدمرة!
كانت هذه لمسات الضوء ولمسات الظل فى صورة عبدالحميد السراج قبل الوحدة.
وفى عهد الوحدة كبر عبدالحميد السراج.
لم يعد رئيس المكتب الثانى. وإنما وصل حتى أصبح نائباً لرئيس الجمهورية.
وكانت لمسات الضوء فيه من قبل الوحدة نقطة انطلاقة إلى مكانته البارزة فى النظام الجديد.
كان ديدبان الحراسة ضد المؤامرات فى الفترة الحرجة.
كان منظم عملية نسف خط أنابيب البترول.
كان ممثل دور البطل فى الدراما العنيفة التى ظهر فيها الملك سعود فى دور قوى الشر الرجعية التى حاولت بالمال وبالغواية أن تفسد وأن تحطم.
ومن هذه الانطلاقة أصبح لعبدالحميد السراج وضع خاص فى تجربة الوحدة.
وكانت لهذا الوضع الخاص احتمالاته. وأخطاره.
أولاً – أصبح عبدالحميد السراج بالنسبة لكل الذين يكرهون الوحدة هدفاً يسهل التركيز عليه.
إن ظروف الحوادث نفسها وضعته موضع البطل فى مواجهة قوى الشر.
ولما بدأت قوى الشر تضرب انتقاماً لنفسها كان محتماً أن تكون بعض ضرباتها موجهة له.
هكذا أخذته الرياض، وعمان، وبغداد تحت الحكم الهاشمى – وبعده لسوء الحظ – هدفاً مكشوفاً لحملاتها وأخذته قوى الاستعمار أيضاً وراء هؤلاء، وفى ذيل الجميع بطبيعة منطق الحوادث. أخذته أيضاً إسرائيل.
ثانياً – أصبح عبدالحميد السراج بالنسبة لعدد كبير من ساسة سوريا القدامى، حتى أولئك الذين انساقوا منهم فى صدر تيار الوحدة – خطراً داهماً، بحكم ما يعرفه عنهم. وقد كان عبدالحميد السراج يعرف عنهم الكثير ويبقيه تحت يده، ومن هنا فإنى لا أتصور أن حكومة الانقلاب فى دمشق سوف تحاكم عبدالحميد السراج. فلو أعطيت له فرصة للمحاكمة وتكلم لاستطاع وهو فى قفص الاتهام أن يضع الحبل حول رءوس الذين يدعون عليه بالاتهام ولَتمكن منهم قبل أن يتمكنوا منه.
وطوال سنين الوحدة. كان عبدالحميد السراج هدفاً لحملات الكراهية المنظمة والهمس المسموم.
ثالثاً: زاد على ذلك كله، وضع آخر، يختلف فى طبيعته.
ذلك هو علاقة عبدالحميد السراج بغيره من كتلة الضباط الوطنيين فى الجيش. هؤلاء الذين كانوا يسندونه فيما مضى، ثم وجدوه فجأة يكبر عليهم ويتقدمهم فى الشوط بكثير.
هنا مشكلة إنسانية بحتة، سمعت واحداً من الضباط الوطنيين يعبر عنها مرة فى صدق وطيبة بقوله:
– لقد كانت لعبدالحميد فى حمل الجمل قشة، ولكنه بالقشة أخذ الجمل بما حمل!
ولقد كان يمكن أن يتحسن الموقف لو أن لمسات الظل فى شخصية عبدالحميد السراج توارت أمام لمسات الضوء، وخبت بعد انطلاقة عبدالحميد السراج الكبرى بعد الوحدة إلى آفاق النجوم!
لكن لمسات الظل، حتى فى آفاق النجوم، بقيت فى مكانها.
– القوة. حب القوة.
– القوة كغاية. وليست كوسيلة لتغيير ثورى.
– الفكرة البوليسية.
ومن القوة، من حب القوة، كانت المشاكل التى تعرض لها عبدالحميد السراج، وعرض لها الجمهورية العربية المتحدة كلها، لكى تكون كلمته فى النهاية هى الكلمة فى سوريا.
وكان عبدالحميد السراج، قبل إقامة الحكومة الموحدة للجمهورية العربية المتحدة، فى شهر يوليو الماضى، من أكثر المتحمسين لتوحيد الحكومة وإلغاء المجالس التنفيذية.
ولكن الواضح اليوم أنه كان يتصور وقتها، أن طبيعة الظروف سوف تتركه نائباً لرئيس الجمهورية فى دمشق.
وفى الظروف السائدة فى سوريا أيامها كان ذلك أمراً يصعب قبوله.
ولربما كانت من هنا حساسية عبدالحميد السراج بعد أن عرف أن منصبه يقتضيه العمل فى القاهرة.
كذلك من هنا المشكلة التى ثارت بينه وبين المشير عبدالحكيم عامر الذى كلف بالسفر إلى دمشق والبقاء فيها فترة توحيد الحكومة. وفترة تطبيق الإجراءات الاشتراكية الثورية. قوانين يوليو سنة 1961.
ولو كانت القوة فى تصور عبدالحميد السراج وسيلة فى يد الثائر لدفع التغيير الثورى – وليست غاية فى حد ذاتها – لاختلف تصرفه فى المشكلة التى أثارها بسبب مهمة المشير عبدالحكيم عامر فى دمشق.
فى تلك الفترة الحساسة، فى أعقاب صدور القوانين الاشتراكية، وبدء تنفيذها، عاد عبدالحميد السراج فجأة من القاهرة إلى دمشق، يجمع أوراقه من مكتبه فى وزارة الداخلية.
ويقول: إنه لا يريد أن يعمل.
ثم ترك بعض ضباطه المقربين إليه دورهم كحراس للأمن وراحوا يتصلون ببعض العناصر لكى تثير الشغب وتحرك القلاقل ليكون الضغط الذى يبقى بعده – عبدالحميد السراج – وحده فى سوريا.
وكان بعض هؤلاء الضباط فى علاقاتهم بالناس قد تركوا أثراً، رؤى معه ضرورة ابتعادهم عن دمشق، وفوتح عبدالحميد السراج فى ذلك من قبلها، وطلب إليه أن ينتدبهم معه للعمل فى القاهرة، وقبل، ولكنهم فجأة تلكئوا فى القدوم إلى القاهرة وانساقوا فى نشاطهم العصبى بحماقة لا يبررها أى قدر من افتراض حسن النية!
ثم جاء ضياع أعصاب عبدالحميد السراج، هذا الضياع الذى حمله على الاستقالة. جاء بذلك القرار الذى أصدره المشير عبدالحكيم عامر بتاريخ 18 سبتمبر 1961 والذى نص فيه على ما يلى:
“يمنع توقيف – اعتقال – أى شخص إلا بمذكرة من النيابة العامة. أى أنه لا يجوز لأية سلطة من سلطات الأمن توقيف أى مواطن إلا إذا كان هذا التوقيف عن طريق السلطة القضائية. أى النيابة العامة”.
وفى نفس اليوم أصدر المشير عبدالحكيم عامر قراراً بتعيين مدير جديد للأمن العام بدلا من العقيد مروان السباعى.
وكان العقيد مروان السباعى مشرفاً على ما كانوا يسمونه بالمكاتب الخاصة، وكانت هذه المكاتب الخاصة التابعة لوزارة الداخلية تعطى نفسها سلطة اعتقال أى مواطن والتصرف معه كما تشاء بحجة دواعى الأمن.
ومع أن إنهاء الجو البوليسى كان رغبة شعبية فى سوريا، ومع أن بعض الذين كانوا يعملون فى البوليس فى خدمة الأمن بدءوا فجأة يعملون ضد الأمن بالتحريض على الإثارة وتحريك القلاقل حتى فى أوساط العمال وفى داخل الاتحاد القومى ذاته.
مع ذلك كله، فإن عبدالحميد السراج اعتبر القرار الذى صدر بمنع اعتقال أى مواطن عن غير طريق السلطة القضائية، وبتغيير مدير الأمن العام، اعتبره على حد قوله “شرشحة” له.
ومن ثم أصبح الموقف فى دمشق بالغ الدقة.
وصدر أمر من القاهرة بأن يركب المشير عبدالحكيم عامر، ومعه السيد عبدالحميد السراج طائرة واحدة ويجيئان معاً إليها لمقابلة رئيس الجمهورية.
واجتمع الرئيس جمال عبدالناصر بكل منهما فى القاهرة، ثم اجتمع بهما معاً، ثم توالت اجتماعاته مع عبدالحميد السراج يحاول إقناعه بمنطق العقل أن لا ينساق وراء غضبه.
وكان فى المشكلة جانبها العاطفى، وهو أن جمال عبدالناصر يحب عبدالحميد السراج كشاب عربى وطنى مخلص، ولكنه بالتأكيد يحب شعب سوريا أكثر منه.
كان يحبه وهو يرى الضوء فى شخصيته ويرى الظل.
وكان أمله أن يتمكن الضوء يوماً من الغلبة على الظلال كلها وتبديدها!
وفعل جمال عبدالناصر مع عبدالحميد السراج ما لم يفعله مع غيره قابله خمس مرات، استغرقت ما يقرب من عشرين ساعة، حاول فيها أن يجعله يرى الحقيقة كما هى.
كان بين ما قاله جمال عبدالناصر:
– إننى لا أستطيع أن أفهم تصرفاتك وتصرفات رجالك فى دمشق.
لقد قابلتكم جميعاً – أنت وعدد من الوزراء السوريين – فى الإسكندرية فى شهر يوليو الماضى وتحدثت إليكم عن نيتى فى توجيه حكومة الجمهورية العربية المتحدة.
بل ويومها تحدثت إليكم بصراحة ليس بعدها صراحة.
قلت لكم يومها إننى لا أستطيع أن أترك الأحوال فى الإقليم السورى تمضى كما كانت تمضى.
لقد كانت لكل منكم فى الإقليم جماعته ومعنى هذه الجماعات المتفرقة أن يتمزق الوطن الواحد.
قلت لكم إنكم، وأنتم دعاة الوحدة وأنصارها، قد سببتم لى من المتاعب ما لم يسببه أعداء الوحدة وخصومها وإنه لولا إيمانى بالجماهير السورية نفسها، ولولا ثقتى فيها، لكنت طلبت من شكرى القوتلى أن يتسلم رياسة الجمهورية فى سوريا ويعفينى منها، ولكنى فى سبيل الجماهير السورية وحدها أتحمل ما أتحمله.
ولقد اخترتك نائباً لرئيس الجمهورية وأعطيتك أوسع الاختصاصات وطلبت منك قبل سفرى إلى بلجراد لحضور مؤتمر الدول غير المنحازة أن تتحمل مسئوليتك الكبيرة على مستوى الجمهورية كلها، ولكنى فوجئت بما فعلته بعد ذلك فى دمشق، ثم بالذى فعله بعض رجالك واتضح لى أن كل الذى تريده هو أن تبقى حاكماً لسوريا.
وأنا أريدك مسئولاً فى الجمهورية العربية المتحدة كلها.
ثم من ناحية أخرى أنت تعرف رأيى فى كثير من إجراءات البوليس فى دمشق، ولقد قلت لك إنها فى كثير من الأحيان تضر بسمعة الجمهورية أكثر مما تخدم أمنها.
وأنا أُقدّر حسن نيتك فيما تفعله وأفهم أن الإخلاص للجمهورية هو الذى يدفعك إليه ولكن الأمور لا تحتاج الوصول إلى هذا المدى الذى يصل إليه بعض رجالك فى بعض الأحيان.
ولم تستطع لمسات الضوء أن تقهر لمسات الظل.
واستقال عبدالحميد السراج.
وهو الآن فى سجن المزة فى دمشق، وبالرغم من كل شىء، فإنى أشعر أن جزءاً من عواطفى معه وأسال نفسى:
– ترى ماذا سيكون من أثر المحنة عليه؟
وفى مناى أن يكون الضوء فى شخصيته قد انتصر على الظلال، وصهرها وأذابها.
لا من أجل شىء، ولكن من أجله هو كشاب عربى وطنى مخلص تحمل فى التاريخ المعاصر للأمة العربية كثيراً من المسئوليات، ولعب يوماً من الأيام دور البطل أمام قوى الشر الرجعية، وارتفع مرة من المرات إلى آفاق النجوم
محمد حسنين هيكل- بصراحة .. صحيفة الأهرام 07-05-1962لا أعرف من الذى أشار على حكومة دمشق بأن تصدر بلاغها الذى أعلنت فيه عن فرار عبد الحميد السراج من السجن، على النحو الذى صدر به.
لكننى أعرف أن الذى أشار لم يكن مخلصاً فيما أشار به، وهو فى أغلب الظن واحد من ثلاثة أحمق، أو جاهل، أو حاقد!
أحمق – لأنه نسى أن عبد الحميد السراج لا ينبغى أن يوصف فى أى بلاغ يصدر عنه مهما كان سببـه، بأنه “السجين عبد الحميد السراج”.
إن عبد الحميد السراج وضع فى سجن المزة فى أعقاب الانقلاب الانفصالى الرجعى، بعد أن حاول بعض قادة هذا الانقلاب أن يضموه إلى صفوفهم، وان يقنعوه أو يرغموه بأى وسيلة من الوسائل على أن يساير قفزتهم بسوريا إلى الظلام، لكنه رفض، ورضى بدخول السجن، الذى أصبح رهينة فى يد الرجعية التى تسلمت مقاليد الأمور فى سوريا بعد أن خدعت المتآمرين ودفعت للمرتشين من صناع انقلاب الانفصال.
ولقد كان عبد الحميد السراج فى سجن المزة أقوى من كل سجانيه، بدليل انهم برغم كراهيتهم له، لم يستطعوا تقديمه للمحاكمة، ولقد كان أول الأسباب أنه كان يعرفهم واحداً واحداً، وإذا ما أتيحت له فرصة محاكمة علنية، فلسوف يخرج هو من قفص الاتهام ليدخل إليه كل الذين أرادوا أن يلفوا الحبل من حول عنقه.
ولقد أبقوه رهينة وهم يعرفون ما يفعلون، ثم جاء انقلاب على الانقلاب ومع ذلك بقى عبد الحميد السراج فى سجن المزة بأمر الذين لا يعرفون ما يفعلون.
جاهل – لأنه نسى أن عبد الحميد السراج كان يوماً من الأيام ولسنوات طويلة واحداً من أبرز مجموعة من شباب سوريا الوطنى، تصدوا وحدهم لكل مؤامرات الاستعمار والرجعية على سوريا العربية.
واجهوا وحدهم مؤامرات حلف بغداد ودوله الكبرى.
واجهوا وحدهم مطامع الأسرة الهاشمية فى سوريا.
واجهوا وحدهم تواطؤ الرجعية السورية مع الاستعمار ومع أدواته الهاشمية.
واجهوا وحدهم محاولة الحزب الشيوعى السورى أن يحكم سوريا بالمذابح الجماعية وبحمامات الدم.
واجهوا وحدهم هذا كله، بإرهابه، بسلاحه، بماله، وتصدوا للدفاع عن سوريا وحفظوا سلامتها فى أحلك الليالى ظلاماً وأحفلها بالخطر.
ولقد دفع عبد الحميد السراج ثمن سلامة سوريا بسهره، وبأعصابه، وبكل طاقة فيه تقدر على العمـل.
بل دفع عبد الحميد السراج فى ذلك السبيل ما هو أغلى من السهر والأعصاب والعمل.
لقد وجهت إليه من جانب الاستعمار والرجعية، حملة من أعنف حملات الكراهية ضمن الحرب النفسية الشاملة التى جرت فى الشرق العربى.
حاقد – لأنه نسى فى غمرة حقده انه وضع حكومة سوريا فى نفس الموضع الذى كان فيه من قبل عدو سوريا.
إن المكافأة التى أعلنتها حكومة سوريا لمن يدل على مكان عبد الحميد السراج وقدرها 20 ألف ليرة ليست أول ثمن يعرض لشراء عبد الحميد السراج.
قبل هذه المرة بأربع سنوات دفع الملك سعود ليشترى عبد الحميد السراج ودفع 20 مليون ليرة، أكثر ألف مرة مما تعرضه حكومة سوريا، ولكن الملك سعود بملايينه العشرين لم يستطع أن يشترى عبد الحميد السراج من نفسه، لم يستطع ان يشترى روحه، بل تقدم عبد الحميد السراج، بشجاعة وشرف وكشف صفقة الشيطان!
ومن عجب انه بين الذين يتصدون للأمور فى دمشق اليوم بعض الذين مدوا أيديهم لليرات الملك سعود وباعوا له سوريا أو حاولوا بيعها.
وبعد فليس هدفى اليوم ان أدافع عن عبد الحميد السراج.
لقد تعرضت مرة بالتفصيل، لحسناته ولأخطائه.
لكن الذى حدث لعبد الحميد السراج خلال الشهور السبعة الأخيرة لا يرضاه أحد.
لقد وضعه فى السجن أعداء سوريا.
وجربوا معه أساليب الغواية والإرهاب فلم ينجحوا.
وطلب الملك سعود رأسه على طبق من ذهب، وكانت الرجعية الحاكمة فى سوريا تتمنى لو أجابت الطلب، لكنها ترددت عن غير عفة وتمنعت لأسباب أخرى غير هواجس الضمير.
ثم مضوا يحاولون إذلاله إلى حد أن معاشه توقف عن أسرته، واحتاجت إلى حد أنها عجزت عن دفع فاتورة النور واشتراك التليفون فى بيتها، فإذا بالتيار الكهربائى يقطع، وإذا بالتليفون يخلع من بيت عبد الحميد السراج.
ولقد يسألنى سائل:
– هل كنت تريد أن تسكت حكومة سوريا عن هرب عبد الحميد السراج؟
وأقول: لقد كان ضرورياً لها أن تتكلم!
ولكنها لو سألت المشورة مخلصة قبل الكلام لنصحها بغير ما تورطت فيه.
لقد كانت الحكومة تستطيع بدلا عن الحديث المهين عن “السجين الهارب” وبدلا من “التحريض الرخيص” عليه بعشرين ألف ليرة ان تصدر بلاغاً تقول فيه مثلاً:
“إن السيد عبد الحميد السراج قد هرب من سجن المزة.
والحكومة تطلب إليه أن يسلم نفسه، على وعد منها بأنها سوف تبت فى أمر سجنه بأسرع مما يمكن، وسوف تعامله كما ينبغى أن يعامل وطنى شريف حاول أن يخدم سوريا بقدر ما مكنته الظروف والوسائل.
وإذا كانت الحكومة قد تأخرت حتى الآن فى ذلك فلم يكن السبب إلا أنها فى غمرة مشاغلها ومسئولياتها نسيت.
شىء من هذا القبيل كان أولى بحكومة سوريا وأليق.
وأنا أعلم انه ليس من حقى أن أشير على حكومة سوريا بما ينبغى لها أن تفعله ولا تفعله.
ولكن حقى وحق كل مواطن عربى غيرى – أن يقول لحكومة سوريا أنها – كما يبدو من تصرفها – لم تحسن اختيار مستشاريها فلم تسمع منهم إلا الحماقة أو الجهل أو الحقد فى حق شاب عربى، انطلقت ضده أعنف حملة كراهية منظمة دبرها أعداء سوريا، أعداؤه هو أيضاً بسبب سوريا.
ثم أقول بغير تردد.
– قلبى الآن مع عبد الحميد السراج فى مخبئه حيث يكون.
ليست حكومة سوريا وحدها هى التى تطارده!
وإنما غيرها، اكبر منها وأقوى – يطلبون الآن دمه، وهم على استعداد لأن يدفعوا ما هو أكثر من العشرين ألف ليرة التى عرضتها حكومة سوريا.
إنى واثق هذه اللحظات إن الملك سعود، وغيره وغيره، يريدون أن يسبقوا حكومة سوريا فى العثور على عبد الحميد السراج وتصفية حسابهم معه إلى الأبد.
ثم أقول:
– يا رب… لا تمكنهم منه!
ما هى طبيعة المعركة الآن فى سوريا؟
حسين يقاتل بذهب سعود ، وسعود يقاتل بدم حسين!
لم تنتهِ القصة بعد فى سوريا!
ومازالت أمام جماهير الشعب هناك - والجيش بجانبها - ومعهما كل القوى المتحررة فى العالم العربى- معركة عنيفة وقاسية، ضد خطط الرجعية العربية المتحالفة مع الاستعمار وأدواته فى المنطقة، ابتداءً من شاه إيران عند الحافة الشرقية للعالم العربى إلى دافيد بن جوريون، عند الغرب على شاطئ البحر الأبيض.
إن الملك حسين سوف يقاتل إلى آخر قطعة ذهب فى خزائن الملك سعود، كما أن الملك سعود سيحارب إلى آخر قطرة من دم الملك حسين.. حتى تعود الرجعية إلى سوريا..
…..
ووراء الملكين - الذى يقاتل بذهب زميله، والذى يحارب بدم صاحبه - تقف قوى كثيرة تختلف مصالحها على الأمد البعيد، ولكنها تلتقى فى خططها هذه اللحظة ويلائم مطامعها جميعاً أن تتملك الرجعية فى دمشق وتتحكم!
….
وراء الملكين صديق لهما ثالث يريد وهو جالس على شرفة قصر المرمر فى طهران أن يرى العالم العربى أمامه على امتداد البصر وقد تحول إلى خرائب وأطلال، ويتصور أن هذه هى الطريقة الوحيدة حتى يستطيع أن ينعم بالحياة كما يشاء وأن ينام ملء جفنيه سعيداً راضياً لا تؤرقه فى الليالى العاصفة أشباح مصدق.
….
وراء الملكين تركيا، لا تريد خلف ظهرها سوريا قوية، متحررة، متحدة مع عالم عربى قوى ومتحرر، يمتد من المحيط إلى الخليج وتصبح تركيا قياساً له دولة صغيرة معزولة، وهى التى كانت دومـاً، وهى التى كان خليفتها العثمانى آنذاك صاحب السمع والطاعة فيه!
….
وراء الملكين بقايا الرجعية العربية، محتكرة الأرض فى سوريا، تاجرة الطائفية فى لبنان، مهربة المخدرات فى الأردن، جلادة العبيد فى شبة الجزيرة العربية!
….
وراء الملكين، سواء كانا يعرفان أو يجهلان، إسرائيل التى تعلم أن تقدمها مرتبط بتأخر الأمة العربية، وقوتها مستمدة من الضعف العربى، وحياتها فى أن يموت جميع العرب!
….
ثم وراء هؤلاء جميعاً، بما فيه الملكان، والشاه، وجورسيل، والكزبرى، وشمعون، والشريف ناصر خال الملك حسين، والشيخ سالم بن عيد ناظر الخاصة فى بلاط الملك سعود، ودافيد بن جوريون - وراء هؤلاء جميعاً تقف القوى الاستعمارية التى تريد الأرض العربية منطقة نفوذ لها، وتريد الثروة العربية نهباً لقرصنتها، وتريد الإنسان العربى مجرد خادم لمطامعها الاقتصادية والسياسية، ولعبة فى الحرب الباردة، ووقوداً لها إذا تحولت إلى حرب ساخنة!
هؤلاء جميعاً لن يسكتوا عن سوريا.
لقد فاجأتهم العاصفة التى هبت على سوريا خلال الأيام الماضية، والتى أسقطت الرجعية فى نفس اللحظة التى تصوروا فيها أنهم مكنوا لها من رقاب الشعب السورى وسلطوها على مستقبله.
كانوا يظنون أنهم أرغموا تيار التقدم فى العالم العربى على التحول من المد إلى الجزر، فإذا التيار الذى تخيلوه ينحسر، يرتد ويجرف أمامه كل ما أقاموه على الشاطئ السورى من حصون وقلاع فتتهاوى جميعاً فى ثانية وكأنها لعب من الرمال تلهى بها الأطفال فى يوم صيف!
ولن يسكتوا.
وإنما لمعركة جديدة يتأهبون اليوم فى سوريا، وهم على استعداد للمضى فيها إلى آخر المدى، قتالاً وجنوناً!
ويكفى هنا أن أقول أن الأمر وصل بالرجعية العربية يوم تحرجت الأمور فى سوريا، إلى حد أن الملك حسين جمع بعض ضباط سلاح الطيران الأردنى وقال لهم ما يكاد نصه أن يكون:
“إن الأمور قد تدعونا إلى التدخل العسكرى فى سوريا، وقد يقع عليكم عبء العمليات الأولى هناك، ولكنى أطمئنكم إلى أن قوى كبيرة سوف تساعدنا فى العملية وتمدنا بما يكفل لنا أن نحقق الأهداف!”
وكان هذا كله معروفاً فى الرياض ذات اللحظة، وذهب بعض الذين مازالت فيهم بقية من حسن نية الملك سعود يقولون له:
- إذا تدخل الأردن عسكرياً ضد سوريا فمن الذى يضمن أن لا تتدخل تركيا أو إسرائيل؟
وقال الملك:
وماذا نفعل مادام السوريون يركبون رؤوسهم؟!
ورد الحصيف الذكى-!- الشيخ يوسف ياسين وكان يحضر المناقشة:
- إذا وقع هذا فالأمر يمكن ترتيبه فى الأمم المتحدة، والحل الوحيد هو أن تصدر الأمم المتحدة قراراً بفرض الوصاية على سوريا باعتبار أن شعبها لم يثبت جدارته فى حكم نفسه.
وهز الملك سعود رأسه ولم يقل شيئاً.
وليس صدفة أنه فى اليوم التالى، صدرت إحدى الصحف الناطقة بلسان كميل شمعون فى بيروت تتحدث عن وصاية على سوريا.
كذلك كان فى أنقرة همس يتردد بحكاية الوصاية على سوريا.
وإلى هذا الحد مشوا، وإلى آخر المدى سوف يذهبون - كما قلت - قتالاً وجنوناً!
من هنا فإن الشعب فى سوريا والجيش يستحقان اليوم تأييد الأمة العربية كلها، وبغير قيد أو شرط.
إن قوتهما هى التى أسقطت الرجعية فى سوريا، وحرمتها الفرصة التى كانت قد أتيحت لها فى أعقاب مؤامرة الانفصال لتثبيت أقدامها فى دمشق.
ومعنى ذلك أن حرب الانتقام الرهيبة سوف يتجه الآن إليها: الشعب السورى وجيشه!
ومما يضاعف من خطورة المعركة وصعوبتها أن هناك عناصر فى دمشق ذاتها تساعد بإدراكها أو بضعف إدراكها على إنجاح حرب الانتقام الرهيبة ضد الشعب السورى وجيشه.
ولقد يقال لى:
“ولماذا الحديث عن هذه العناصر داخل دمشق نفسها فى هذه اللحظة الحرجة بسبب الأخطار الداهمة من خارج دمشق؟”.
وأقول:
“ليس أولى بالصراحة من اللحظة الحرجة… فهى اللحظة الحاسمة”.
بصراحة بقلم محمد حسنين هيكل: نقطة اللاعودة مع قيادة البعث السورى
عقدة حرب البعث، وكيف يمكن حلها، وهل كان فى طاقة القاهرة دواء أو شفاء؟!
لا أظن أن الجمهورية العربية المتحدة، بقى لديها جهد تبذله مع قيادة حزب البعث الحالية فى سوريا، علّها تعي وتفهم، وتبحث – جادة وحذرة – عن العقل الذي قذفت به من فوق الجرف المعلق على حافة الهاوية إلى الأعماق المظلمة تحتها!
لقد بذلت الجمهورية العربية المتحدة، كل جهد إنساني محتمل، ولم يطل ترددها أمام أى خطوة تقوم بها، إذا ظنت، أو توهمت – خلافاً مع منطق التجربة – أنه قد يكون وراءها دواء يشفى قيادة البعث السوري من عقدتها.
لكن العقدة استعصت، والشفاء عَزَّ مناله!
وعقدة قيادة حزب البعث السوري – عقدتان فى الواقع، وإن اتصلتا:
العقدة الأولى: أن قيادة حزب البعث السوري، تحسب نفسها قيادة شعبية، وليس ذلك صحيحاً باستقراء التاريخ. فإن قيادة البعث السوري تعيش فى عزلة كاملة عن الجماهير فى سوريا، وخلال ما يزيد عن عشرين سنة من العمل الحزبي المنظم لم يستطع الحزب أن يمد تأثيره وراء ألف سوري على أكثر تقدير.
– ثلثهم تائه فى غيبيات الأستاذ ميشيل عفلق أمين سر الحزب العام.
– والثلث الآخر هائم وراء أحلام وصول الحزب يوما إلى الحكم.
– والثلث الباقي خرج من التيه، ونفض يده من الأحلام الهائمة وتكشَّف أمامه السراب، لكن الحرج يستبد به فلا هو قادر على البقاء، ولا هو قادر على التخلي!
ومن دليل عزلة حزب البعث السوري، عن الجماهير فى سوريا، أنه لم يستطع مرة واحدة، خلال أكثر من عشرين سنة أن يقترب من الحكم عن طريق العمل الشعبي، وإنما اقترب وابتعد فى أعقاب مواكب الانقلابات العسكرية، الساخنة والباردة التى شهدتها سوريا!
المرة الوحيدة التى اقترب فيها حزب البعث السوري من الحكم بشبه عمل شعبي، كانت مسايرته لإصرار الجماهير السورية على الوحدة مع مصر سنة 1958 ومجاراته لتيارها الظاهر المكتسح يومها، وحتى يومها لم تقدر قيادة حزب البعث السوري على الصبر طويلا بقرب العمل الشعبي، فهجرته إلى العزلة قليلاً، وبعدها راحت تتسرب مع التيارات التحتية الخفية للانفصال حتى وقع، وكان الحزب أول مؤيديه بشهادة إمضاء الأستاذ صلاح البيطار على عريضة الانفصال جنباً إلى جنب مع مأمون الكزبرى!
والعقدة الثانية: أن قيادة حزب البعث السوري، تحسب نفسها قيادة ثورية، وليس ذلك أيضاً – للمرة الثانية – باستقراء التاريخ – صحيحاً، فخلال عشرين سنة من العمل السياسي اشترك حزب البعث السوري أكثر من ست مرات أو سبع فى سلطة الحكم فى سوريا، لكنه فى كل مرة كما دخل إلى الحكم خرج، لم يترك هناك أثراً ثورياً حتى ولا خدشة ظفر تشير يوما إلى أنه حاول، ولو مجرد المحاولة، أن يفتح للتقدم طريقاً، أو حتى شقاً يلوح منه شعاع ضوء!
لا شيء على الإطلاق إلا عبارات مصكوكة، لها رنين، تصغي فيها قيادة حزب البعث السوري إلى أصدائها الذاتية، ثم يستبد بها الطرب والعجب، فتستعيد سماعها استزادة وهكذا.
تكرار بالصوت لأسطورة “نرسيس” بالصورة!
وكان بطل الأسطورة الإغريقي “نرسيس” من فرط إعجابه بحسن صورته، يطيل النظر إليها فى الماء ولا يرفع بصره عنها، وكذلك يفعل الأستاذ ميشيل عفلق بعباراته ذات الرنين، استعاضة بتموجات الصوت عن انعكاسات الصورة، لأن الأستاذ ميشيل عفلق لا يستطيع ادعاء حُسن “نرسيس”!
ولا يكفى ذلك كله دليلاً على الثورية!
وحتى خلال تجربة الوحدة سنة 1958، لم تكن قيادة حزب البعث السوري تفكر فى غير السلطة والمشاركة مناصفة فيها -!- وبغير غاية اجتماعية من السلطة، وليس ذلك مفهوم الثوار، فإن السلطة للثائر ليست فرصة التحكم وإنما هى فرصة التغيير، ومع ذلك، فإنه – حتى التغييرات الثورية الاجتماعية البعيدة المدى، التى تمت فى عهد الوحدة – تمت بعيداً عن حزب البعث، وتمت وحزب البعث بعيد عن السلطة، يتظاهر بأنه لا يعترض على المزيد من الحرية الاجتماعية، لكنه يطالب إلى جوارها بمزيد من الحرية السياسية، هو الذي يفرض هذه الساعات على سوريا حكما من الإرهاب المسلح لم يسبق له فى دمشق مثيل!
تلك عقدة قيادة حزب البعث السوري، وليته كان لدى الجمهورية العربية المتحدة، دواء لها أو شفاء.
لا تملك الجمهورية العربية المتحدة، أن تقطع حزب البعث إقطاعاً، سيطرة على أقدار سوريا التى يملكها الشعب السوري وحده، كذلك لا تملك الجمهورية العربية المتحدة أن تمنح حزب البعث ثورية ليست فيه، وليست الثورية وساما يتدلَّى على صدر، ولا هى لقب يسبق الاسم ويتقدمه، ولا هى مجرد شعار يرن صداه!
وأقول مخلصاً:
ليته كان لدى قيادة البعث السوري من القوة الذاتية الشعبية ما يمكّنها مما تريد.
وليته كان لديها بعد ذلك من العقائد ما يبرر لها احتكار السلطة فى سبيل أن تطرحه للممارسة!
ليته كان ذلك أو شيئاً منه. إذن لانفكت عقدة البعث السوري طبيعياً، ووجدت الدواء والشفاء لنفسها من غير حاجة إلى جهد أحد، لكنه ليس بالتمني وحده تتحقق الأحلام!
وهنا تفسير كل ما حدث فى سوريا خلال الأسابيع الأخيرة:
– قيادة حزب البعث السوري، ليست لديها القوة الذاتية الشعبية، وإذن تتسلق كالنباتات التى لا سِيقان لها على سند قوى.
على دعوة الوحدة العربية تتسلق وتلف فروعها، فإذا لم تتمكن، فعلى أبراج الدبابات والمدافع تتسلق وتلف الفروع.
لقد جاءت إلى القاهرة بعد 8 مارس تريد من قاعدة دعوة الوحدة، توقيعاً على بياض يفوضها بأقدار سوريا، فلما لم تستطع، استدارت إلى قيادة الجيش السوري تطلب التفويض واستطاعت أن تحصل عليه بعد انقلاب عسكري بارد وقع تسللا ضد ثورة 8 مارس.
– وقيادة حزب البعث السوري، ليست لديها العقائد التى تضعها للممارسة الثورية إذا ما توصلت إلى احتكار السلطة، ولسوف تصل فى النهاية إلى حائط مسدود، وتتحول القوة فى يدها إلى أداة عقيمة، لا تُسقط قديماً، ولا تأتى بجديد، وبعدها، وأقولها من الآن: لا شيء سوف يبقى أمام قيادة حزب البعث السوري، إلا مزيداً من الديكتاتورية العسكرية وإلا مزيداً من محاولة توريط بعث العراق معها فى معركة لا ضرورة لها ولا أمل فيها، إلا عاصفة دعائية تبدأ بالدفاع عن النفس ثم تنتهي بهجوم عنيف ضد القاهرة تستعمل فيه نفس الأسلحة والأساليب المعروفة لكنها هذه المرة موجهة بأسلوب عقائدي!
ثم تجيء النهاية على شكل انقلاب رجعى كامل أو ثورة شعبية شاملة. وفى الحالتين ضياع للسلطة من يد قيادة حزب البعث السوري، وضياع لقيادة حزب البعث السوري نفسها، وربما للبعث كله.
ومع ذلك فليس فى وسع منصف أن ينكر، كم بذلت القاهرة من جهد فى سبيل أن لا تصل الأمور بالبعث إلى هذه النتيجة أو احتمالاتها، حتى أثبتت الظروف أن كل أمل خلاف منطق التجربة، ليس إلا وهما يجب العدول عنه مهما كان الثمن، ومن سوء الحظ أن هذه النقطة تماما هى النتيجة التى انتهت إليها تجربة جديدة مع قيادة حزب البعث السوري، أضيفت إلى نتيجة تجربة سابقة ومن حصيلتهما معاً أقول الآن بصراحة:
– “لا أظن أن الجمهورية العربية المتحدة، بعد اليوم، تستطيع أن تتعاون مع قيادة حزب البعث السوري. ولا حتى أن تتعايش معها سلميا”.
وضد شعورها الداخلى رضيت القاهرة بتجربة ثانية مع قيادة البعث السوري، وكانت تجربتها الأولى تكفى، لكن الشعور بالمسئولية التاريخية، والرغبة فى تجنيب النضال العربي مصادمات لا ضرورة لها، والحرص على عناصر فى حركة البعث، لا ذنب لها، وربما هى لا تدرى بما تقوم به القيادة. كل ذلك غلب الشعور الداخلى وفرض تجربة ثانية، وكان كل ما اشترطته القاهرة، هو تصفية الحساب القديم، بمجرد المصارحة، وبلا حساب أو عقاب!
ومن عجب أن القاهرة، كان لديها قبل التجربة الثانية مباشرة، دليل جديد على أن قيادة البعث السوري ما زالت على حالها القديم الذي عرفته والذي لا يغرى مهما كان التفاؤل بفرصة ثانية.
ولقد كان الدليل من اليمن. قبل أسابيع من ثورة 8 مارس فى سوريا.
عقب ثورة اليمن، جلس الأستاذ ميشيل عفلق فى بيروت، فى نوبة من نوبات الفلسفة التى يعانيها ويعانى منها غيره بعده -!- يقول:
– “إن ثورة اليمن بظروفها أخطر من ثورة مصر سنة 1952 وأبعد أثراً”.
ولم يكن أحد ليعترض على هذه الفلسفة ولا حتى فى القاهرة، وهى تعتبر نفسها مهد الثورة العربية الأم وليس هناك غير الأم تتمنى لأولادها أن يكونوا جميعاً أفضل منها وأقوى صحة وأبقى عمراً.
لكن ما حدث بعد ذلك كان هو موضوع الاعتراض على الفيلسوف.
بينما هو جالس فى بيروت، كانت الرجعية تحشد الجيوش حول حدود اليمن، وتحاول شق طريقها إلى ضرب الثورة فى صنعاء.
وبعد ذلك بقليل كانت الجمهورية العربية المتحدة تشق طول البحر الأحمر بقوات مسلحة متجهة إلى اليمن، تشارك فى الدفاع عن ثورته، وتقفل الحدود أمام الرجعية المقتحمة أو المتسللة.
وبعد ذلك بقليل، وبينما شباب من مصر يسيل دمه شجاعة واستبسالا على سفوح جبال اليمن الوعرة وعلى القمم، كان الأستاذ ميشيل عفلق يُسيل قطرات حبر على ورق يكتب به منشورات يوزعها حزب البعث فى اليمن يقول فيها: إن وجود القوات المصرية فى اليمن، هو استعمار مصري يستهدف السيطرة الناصرية على اليمن!.
ولقد عثر ضباط وجنود مصريون، وهم يقاتلون فى اليمن على هذا المنشور، ورد فعله فى نفوسهم لا يحتاج منى إلى وصف مستفيض.
ولقد أحدث المنشور صدمة فى القاهرة، وحين جاء الأستاذ ميشيل عفلق بعد ذلك إليها أثناء محاولة تصفية حساب التجربة السابقة، لم تفت الفرصة لسؤال فيه عتاب، ولم ينكر الفيلسوف معرفته بالمنشور ولا صدوره عن البعث، وإن كانت حجته أن الذى وزعه هو جناح آخر من البعث. منحرف!
وحتى عملية تصفية الحساب القديم نفسها، كان لابد لها أن تنبه إلى عدم جدوى التجربة الجديدة، فلقد كانت الإيضاحات التى قدمت خلالها واهية، تعيد إلى اللسان إحساس المرارة الذي كاد يُنسى.
لكنها العوامل التى غلبت الشعور الداخلى مرة أخرى، المسئولية التاريخية، وتجنب مصادمات لا ضرورة لها، والحرص على عناصر فى حركة البعث، يضاف إلى ذلك اعتبارات أخرى جرى التعلُّل بها.
ربما هذه الإيضاحات الواهية أثر من آثار الشعور بالذنب ورهبة من موقف المصارحة!
ربما تعلمت قيادة البعث السوري من محنة الانفصال بأكثر مما تعلمت من شركة الوحـدة!
ومع أنى ما زلت أرد نفسي حتى الآن عن الخوض فى تفاصيل عملية المصارحة، وإن كنت واثقاً أن أوانها سوف يجيء على أى حال – فإن مشاهد صغيرة قد تكفى لإظهار نوع من الإيضاحات التى قدمها الشعب خلال عملية تصفية الحساب، والتي كان لابد لها أن تضاف على الحساب. لا أن تصفيه!
– فى مشهد من المشاهد مثلاً، قال الرئيس جمال عبدالناصر للسيد صلاح البيطار:
– هل حدث فى يوم من الأيام أنك جئتنى برأي مؤيد أو معارض فى شأن من شئون الدولة؟
ومع ذلك فقد فوجئت ذات صباح، كنا فى المساء الذي سبقه، نتعشى معاً فى القطار العائد بنا من احتفال النصر فى بورسعيد، باستقالتك أنت وأكرم الحورانى. هل كان بوسعي أن أفسر ذلك إلا بأنه عملية غدر؟!
ولم أكن قد سمعت اعتراضاً منكم قبلها إلا رغبتكم فى المشاركة، وقلت لكم وقتها إن من بينكم نائباً لرئيس الجمهورية وعدداً كبيراً من الوزراء المركزيين والتنفيذيين. والوزارة تجتمع باستمرار وفى إطارها المشاركة الطبيعية، لكنكم طلبتم إقامة لجنة تجتمع فى السر من ثلاثة من المصريين وثلاثة من البعثيين تتولى توجيه السياسة العليا فى الجمهورية العربية، ورفضت أنا ذلك وكان لابد أن أرفض، فمعناه أنني أنقل السلطة إلى لجنة غير دستورية بدلا من الهيئة الكاملة للوزارة، كذلك فمعناه من ناحية أخرى أن الوحدة تصبح شركة بين مصر وحزب البعث فى سوريا وليست تلك إرادة الشعب السوري.
ألم يحدث ذلك؟
وقال صلاح البيطار:
– حدث، ولكن اقتراح المشاركة على هذا النحو لم يكن منى وإنما كان من الأستاذ ميشيـل.
واستطرد عبدالناصر:
– ومع ذلك فكيف يمكنني أن أدخل فى مشاركة على هذا النحو مع جماعة فقدت ثقتي فى استقامتهم الأخلاقية. لقد كنت أجلس مع نصفهم، فلا يكون لهم حديث غير السب فى نصفهم الآخر.
وقال صلاح البيطار:
– سيادة الرئيس. أنا لم أقم بسبّ أحد!
قال عبدالناصر:
– أَمَا كنت تسُب فى أكرم الحورانى صديقك فى الحزب وصديقك فى الاستقالة بعد ذلك؟
قال صلاح البيطار:
– لقد قلت عنه أمام سيادتك، إنه منحرف، ومخرب، ومتآمر لا يبغى غير التسلط، وهذا رأيي، وليس سباً.
ولم يملك جمال عبدالناصر نفسه، ولا ملك غيره من الجالسين معه أنفسهم من الضحك!
– وفى مشهد آخر مع السيد ميشيل عفلق أمين سر الحزب وفيلسوفه تساءل الرئيس جمال عبدالناصر:
– ألم تكن أنت وراء استقالة وزراء البعث من وزارة الوحدة. ألم تتصل أيضاً بغيرهم من الوزراء غير البعثيين ليستقيلوا وتبدو استقالتهم وكأنها انسحاب سوري من الوحدة. أكثر من ذلك لدى الدليل على أنك اتصلت ببعض الوزراء المصريين ليستقيلوا هم أيضاً.
لماذا أردت أن تفعل ذلك وأي خلاف كان بيننا؟
هل طلبت يوماً أن تقابلني فامتنعت عن لقائك لأسمع ما عندك. هل كتبت إلى مرة برأي أو بمشورة؟
حين رفضت اقتراحك بالمشاركة فلقد كنت ارفض وصاية بعثية على الجمهورية. أو كنت أرفض تسلطاً حزبياً على سوريا وكنت أعلم أن ذلك هدفكم ولم يكن فى مسئوليتي أمام الشعب السوري ما يسمح لى بأن أترك لكم هذا.
فهل من أجل هذا يستقيل وزراء الحـزب، وتضغطـون على غيرهم من السوريين والمصريين؟”.
وكان الإيضاح الذي قدمه الأستاذ ميشيل عفلق:
– لم نكن نريد استقالة وزراء الحزب وحدهم – بعد رفض المشاركة – وإلا بدت العملية بعثية، وكذلك لم نكن نريد استقالة السوريين كلهم وإلا بدت العملية انفصالية، وكنا نريد معهم بعض المصريين لتكون الأزمة فى إطار الوحدة!
واستطرد جمال عبدالناصر:
– وهل لهذا السبب أيضاً اتصلتم بالملحق العسكري المصري فى بِرْن تغرونه بالعمل معكم؟ هل أردتم أيضاً – بعد الأزمة السياسية فى إطار الوحدة انقلاباً عسكرياً فى إطار الوحدة؟!
ومع ذلك رضيت القاهرة بفتح صفحة جديدة مع قيادة حزب البعث السوري، بعد مرحلة أولى من المباحثات جرت فيها محاولة تصفية الحساب القديم.
– وقبل أن تبدأ المرحلة الفعلية والتجربة الجديدة الثانية، فوجئت القاهرة بأن جريدة حزب البعث فى دمشق – فى معرض دفاعها عن مواقف الحزب تجاه جو ثوري عارم يجتاح سوريا – ولا يمكّن الحزب من التسلط والسيطرة على سوريا – نفس هدفه القديم – تجاوزت حدودها مع الجمهورية العربية المتحدة.
وكان رد فعل واضح من القاهرة. لقي صداه فى دمشق، وعادت قيادة حزب البعث السوري إلى صوابها قبل أن يفوت الأوان.
– عادت إلى صوابها فيما يتعلق بالقاهرة، لكنها ظلت على موقفها من رغبة التسلط والسيطرة على سوريا، وإن أدركت أنها لا تستطيع الوقفة الصريحة، ولا تملك إلا المناورة المتسللة.
– وكان التأخير فى تأليف الجبهة الوطنية فى سوريا.
– ثم حان موعد المفاوضات الثلاثية. وحديثها هى الأخرى أطول الحديث وأعجبه.
– ثم انتهت المفاوضات بإعلان بيان القاهرة.
– ثم عاد الوفد السوري إلى دمشق استعداداً للتنفيذ.
– ثم إذا هو تنفيذ شيء آخر غير إعلان الوحدة.
وجرى انقلاب بارد فى الجيش السوري، بتسريح كل مَن وجدت فيه قيادة حزب البعث السوري رغبة أو قدرة على منع سيطرتها على سوريا.
إن قيادة حزب البعث فى سوريا، استغلت مع الأسف، بعض انقلابي 8 مارس ضد بعض ثوريّى 8 مارس، وانتهت بتحويل الثورة إلى انقلاب ظناً منها أنها على هذا النحو تستطيع أن تروضه.
ثم بدأ التسلط السياسي بعد أن تمت عملية التسلق، واضطرت كل الفئات الوحدوية أن تستقيل من الوزارة السورية.
– ثم فتحت فوهات المدافع وأبواب السجون فى سوريا، تقذف الظلام واللهب فى نفس الوقت!
وأنا أعبُر على التطورات سريعاً لأصل منها إلى نتيجة أخيرة:
– بذلك كله، وصلت العلاقات بين الجمهورية العربية المتحدة، وقيادة البعث السوري إلى نقطة اللا عودة، وافترق الطريق.
وبعدها. ندرس النتائج والاحتمالات
وحدنا فى المعركة3 أسباب لصعوبة المعركة التى نواجهها الآن اليهودى التائة بين بيروت وبغداد ودمشق فى طائرة تشيكية! كلمة واحدة تصل بنا إلى النصر فى مرحلة الاشتراكية لا أظن أننا واجهنا من قبل معركة تماثل قسوتها وضراوتها هذه المعركة التى نواجهها اليوم. إن هذه المعركة التى نخوضها الآن وتخوضها معنا القوى الوطنية لحركة القومية العربية، هى أعنف وأخطر معاركنا. أعنف وأخطر من حرب السويس، لعدة أسباب: أولاً: أن حرب السويس كانت قضية واضحة المعالم، لشعب صغير يتقدم فى إصرار نحو الحرية، بينما اثنتان من دول الاستعمار الكبرى تحاولان بالنار والدم والحديد وقف تقدمه، ومن هذا الوضوح كان سهلاً أن تتجسد القضية ببساطة أمام الرأى العام العالمى، وكان سهلاً بالتالى على قوته المعنوية الهائلة أن تحدد موقفها من الصراع وأن تلقى بثقلها كله مع مصر سنة 1956. ولكن “السويس” الاجتماعية التى نخوضها اليوم، قضية معقدة ومتشابكة، ثم هى فى مظهرها الخارجى تبدو مشكلة محلية… بل تكاد تبدو فى بعض الأحيان - وهماً وخداعاً - قضية عائلية. ومن ثم فإنها لا تثير ولا تحرك، ولا تهز المشاعر وتلهبها… على الأقل إلى الحد الذى يتساوى مع خطورة المعركة الفعلية. ثانياً: أن العدوان فى السويس كشف نفسه بالغزو المسلح، كشف نفسه بالأساطيل وبالطائرات وبالدبابات والمدافع، تحاول أن تقتحم شاطئنا فى بورسعيد. كشف العدوان نفسه أيامها وبالتالى كان سهلاً إثبات الجريمة عليه، والإمساك بيده المخضبة بالدماء لكى تراها الدنيا وترى فيها جريمته، أما هذه المرة فإن العدوان غيّر خطته. إنه هذه المرة لا يقتحم… وإنما يتسلل. وهو هذه المرة لا يجىء ومن حوله هدير آلات الحرب ودويها.. وإنما هو مقبل فى صمت، كأنه على حد التعبير اليابانى، “جيش الأشباح”، نشعر به دون أن نراه، ونحس أثر ضرباته ولا نستطيع الإمساك به! ثالثاً: أنه فى “حرب السويس” كانت إحدى القوى الكبرى وأعنى بها الاتحاد السوفيتى - تقف سياسياً إلى جانبنا - وذلك أمر لا يستهان به خصوصاً فى ظروف الخطر. ولكن الاتحاد السوفيتى له فى هذه المعركة موقفه، وله فى هذا الموقف منطقه. وليس من حقنا أن نلومه فى ذلك، وإلا كنا نحمل أصدقاءنا أكثر مما يطيقون، فليس لنا أن ننسى - على أى حال - أن الاتحاد السوفيتى دولة كبرى، لها مصالح الدول الكبرى ولها خططها الاستراتيجية الواسعة، وقد تتفق مصالحها وخططها معنا يوماً فى معركة من معاركنا، ولكنها فى معركة ثانية قد تختلف. وعلينا أن نكبر على أنفسنا إلى القدر الكافى الذى نستطيع معه أن نرى الحقائق المجردة فى ظروف أصدقائنا، بلا عتاب وبلا أسف! لقد وقف الاتحاد السوفيتى معنا سنة 1956 لأن معركتنا كانت ضد الاستعمار الغربى وحده. ثم اختلف الاتحاد السوفيتى معنا سنة 1959 لما تصدينا لمحاولة السيطرة الشيوعية على العراق، ودخل جمال عبد الناصر لهذا السبب، فى صدام علنى مع نيكيتا خروشوف. وليس من شىء يعيد إلى أذهاننا مدى النجاح الذى حققته القومية العربية فى تصديها للشيوعية، خيراً من صورة اليهودى التائه التى بدا عليها خالد بكداش زعيم الحزب الشيوعى السورى عندما حاول العودة منذ أسابيع إلى دمشق. جرب النزول فى دمشق، التى حارب فيها القومية العربية، ولم يستطع النزول. وجرب النزول فى بغداد، التى كانت صدى صوته سنة 1959، ولم يستطع النزول. وجرب النزول فى بيروت، التى مازال حزبه يستعملها قاعدة له، ولم يستطع النزول. يهودى تائه جديد، تائه يركب طائرة تشيكية كبيرة، قامت به من براج، ولم تجد مكاناً فى الشرق الأوسط يقبله، فعادت به مرة ثانية إلى براج! فى المجال الدولى إذن هذه المعركة أعنف وأخطر معاركنا. وملخص الأسباب الثلاثة التى ذكرتها الآن دولياً يصل بنا إلى حصيلة أخيرة هى أننا نواجه هذه المعركة وحدنا، ونخوضها وحدنا، وعلينا أن ننتصر فيها وحدنا. وفى المجال العربى، بعد المجال الدولى، نجد أن الصورة قريبة. وأكاد أقول متكررة. المعركة الجديدة فى المجال العربى أعنف وأخطر معاركنا. أعنف وأخطر من معركة السويس. فى معركة السويس كانت هناك شبه جبهة وطنية، فى مواجهة العدوان الاستعمارى الخارجى. وهذه من طبيعة الأمور فى تلك المرحلة من النضال الوطنى ضد الاستعمار! - فى سنة 1956 كانت بعض العناصر الرجعية فى المنطقة تقف بالقرب منا فى المعركة، ولقد كانت مصالحها بالفعل مترابطة مع مصالح الاستعمار، ولكنها - ولو حتى بحكم الشعور العاطفى وحده - لم تقف بعيداً عنا بكثير. ومن ناحية أخرى - مع الشعور العاطفى - فلقد كانت تريد تأمين مصالحها إذا ما كان النصر فى المعركة للقوى الوطنية للشعوب. كانت تقف معنا ولو حتى بالكلام، وكانت تتجاوز ذلك أحياناً إلى التبرع ببعض مالها لضحايا بورسعيد. وقفت معنا سنة 1956، لكى تكون لها بعد ذلك بيننا كلمة مسموعة، لها وزنها ولها تأثيرها. - وكذلك تقريباً فى سنة 1956 - كان موقف العناصر الشيوعية فى المنطقة - وقفت معنا بقوة - وللحق أقولها - فى معركتنا ضد الاستعمار. وكانت فى ذلك تصدر عن عداء للاستعمار لاشك فيه، ولكنها كانت تريد بعد ذلك أن تحصل على اعترافنا الفعلى بها، وأن تأخذ من موقفها المعادى للاستعمار فى السويس، نقطة ارتكاز لنشاط يمتد بعد السويس ويتغلغل. هى الأخرى وقفت معنا سنة 1956، لكى تكون لها بعد ذلك بيننا كلمة مسموعة، لها وزنها ولها تأثيرها. بعض العناصر الرجعية وقفت معنا وأقول “بعض” لأن بعضها الآخر والرجعية الهاشمية فى بغداد على رأسه، وقفت ضدنا من أول لحظة. والعناصر الشيوعية وقفت معنا، وأضيف كلها، فإن الحرب ضد الاستعمار ووقوف الاتحاد الشيوعى سياسياً بجانبنا لم يدع لأى من هذه العناصر فرصة للتردد أو للانتظار! كلاهما، كلاهما وقف معنا، ولكن لغاية ذاتية فى النهاية يريدها ويسعى إلى تأمينها. الرجعية كانت فى النهاية تريد أن تجمد اندفاعنا الثورى الاجتماعى. والشيوعية كانت فى النهاية تريد أن تحول هذا الاندفاع إلى غير وجهته الوطنية الصميمة! ولكن التجارب بعد سنة 1956 لم تحقق لكل منهما غايته! وكانت سنة 1958، سنة حاسمة، فى بدايتها ونهايتها. فى بداية سنة 1958 - دخلت القوى الوطنية فى حركة القومية العربية، إلى تجربة الوحدة بين مصر وسوريا، دون أن تقيم وزناً للمعارضة الرجعية ضد إتمام الوحدة، وحين وصلت الرجعية إلى حد التآمر على الانقلاب وعلى القتل، لم تتردد القوى الوطنية فى أن تكشف للرأى العام العربى خطط الرجعية مدعمة بالوثائق والمستندات وبينها - بالطبع - شيكات الملك سعود التى حاول بها أن يغرى عبد الحميد السراج! وفيما تلا ذلك من السنين، لم تفرط القوى الوطنية فى ثوريتها، ولم تجمدها من أجل خاطر الرجعية ومصالحها، لقد تعطلت بعض الوقت - هذا صحيح - ولكنها استطاعت فى يوليو 1961 أن تفجر ثورة اشتراكية حقيقية وأصيلة. وضيعت الرجعية صوابها، وكشفت نفسها، ورفعت أعلام الخيانة سافرة صريحة، بدورها فى انقلاب دمشق، وبما حدث لشعب سوريا بعده. وشهدت نهاية سنة 1958 - مقدمات الصدام المفتوح بين القوى الوطنية فى المنطقة وبين العناصر الشيوعية فيها. وقفت الأحزاب الشيوعية العربية فى العراق، وقفة عنيدة أخيرة، حتى لا يصيبها فى العراق، مثل ما أصابها من قبل فى مصر وسوريا، وتحرم من حق العمل السياسى.
|
 مجلة الوعي العربي
مجلة الوعي العربي