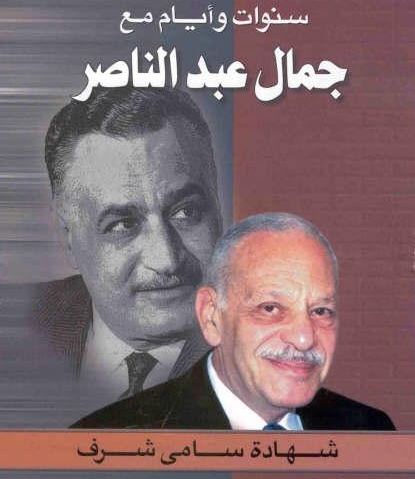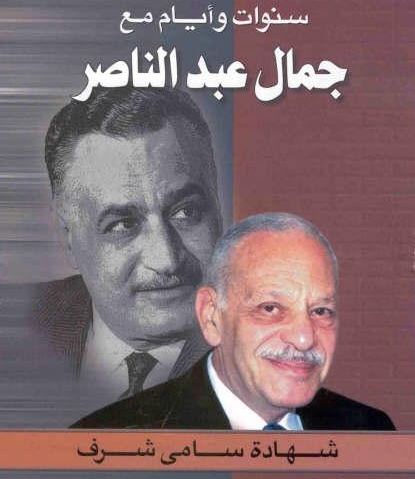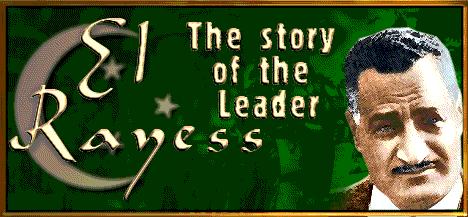|
كتاب ـ ناصر محارباً ـ الحلقة (الأخيرة)
ما الذي كان عبدالناصر يعتزم القيام به قبيل رحيله؟
تأليف :لورا جيمس
ها هي الدائرة قد اكتملت، ووصلت رحلتنا مع لورا جيمس مؤلفة هذا الكتاب إلى ختامها، حيث تركز على بعدين محددين، أولهما إلى أين كانت ستمضي مسيرة معادلة المقاومة ـ الرد ـ التحرير التي صاغها عبدالناصر وأعطاها البقية الباقية من عمره على أرض الواقع لو سار التطبيق على نحو ما خطط له؟
وثانيهما إلى أي حد أثرت الصورة الراسخة في ذهن صانع القرار المصري حول الولايات المتحدة في تطور الأحداث في الشرق الأوسط حتى رحيل عبدالناصر عن دنيا الناس الفانية في 29 سبتمبر 1970؟ وعلى هامش هذين البعدين سيطرح جانب خلافي بطبيعته هو ما يتعلق بالتراث الناصري الذي ترى المؤلفة أن بعض جوانبه لا يزال يكتنفها الغموض على حين لا يتردد الكثير من المراقبين في تأكيد أن أصداءه تزداد ارتفاعاً، وأبرز الأدلة على ذلك ما واكب حرب الصيف الماضي التي بدا واضحاً بجلاء من خلالها أن الطبيعة العدوانية لإسرائيل ليست أداة حركة بقدر ما هي سمة وجود. هكذا فإننا قد نتفق، أو قد نختلف مع المؤلفة، في تقويمها للتراث الناصري، وقد نتوقف عند دلالة العنوان الذي اختارته للفصل الأخير من كتابها، وهو «خاتمة: التراث الغامض»، لكن ذلك لن يمنعنا في كل الأحوال من الاهتمام بهذا الفصل من كتابها الذي تكرس فيه مجموعة بالغة الأهمية من الأسئلة وعلامات الاستفهام وأيضاً محاولات الإجابة حول السيناريو الذي كان يمكن أن يمضي الجهد العربي المبذول للتحرير لو أن عبدالناصر لم يرحل في ذلك التوقيت الحرج والدقيق بلا انتهاء.
وفي السطر الأول والثاني من هذا الفصل سيصافح عيوننا السؤال الذي ربما كان الأكثر أهمية بالتأكيد في مجموعة الأسئلة التي أشرنا إليها حالا.هذا السؤال هو على نحو ما صاغته المؤلفة: ما الذي كان الرئيس عبدالناصر ينويه حقاً عشية وفاته في سبتمبر 1970 فيما يتعلق بالاحتلال الإسرائيلي لسيناء؟ - لم أجد ما توقعته: من منظور المؤلفة، فإن السؤال الذي طرحته في صدر خاتمة كتابها يكمن في صميم تراث عبدالناصر، حيث يذهب المتحمسون له إلى تأكيد ان قبوله لمبادرة روجرز لم يكن إلا خطوة تكتيكية، حيث علق الآمال على ان تتيح له الوقت الضروري للقيام بالترتيبات النهائية الضرورية لوضع خطته لتحرير سيناء بالقوة موضع التطبيق. هذا هو ما يجمع عليه المتحمسون للتراث الناصري، غير أنهم يختلفون في التفاصيل، فالبعض، وفي مقدمتهم محمد حسنين هيكل ـ يرون أن الخطة «جرانيت 1» تؤكد ذلك على نحو لا يحتمل اللبس، والبعض الآخر يؤكد أن ذلك يتجلى في «العملية 200» على نحو ما قال أحمد حمروش في مقابلة أجرتها المؤلفة معه خصيصاً لهذا الكتاب.
ويذهب فريق ثالث إلى أن الخطة التي اعتمدها عبدالناصر هي نفسها على وجه التقريب التي نفذها خلفه أنور السادات في حرب أكتوبر، وهي الرؤية التي قال بها حسين الشافعي، غير ان فريقا رابعاً يبادر إلى الاعتراض فوراً على مقولات الفريق الثالث. مشيرا إلى ان خطة عبدالناصر كانت أفضل بكثير من تلك التي نفذها السادات، وعلى رأس هذا الفريق الأخير يأتي سامي شرف وزير شؤون الرئاسة، الذي يؤكد أن الخطة الناصرية كانت في جوهرها عملية عربية متكاملة ومنسقة بين مصر وسوريا والأردن ولبنان، وما كانت مصر لتقوم في اطارها بإقامة رأس جسر إلى سيناء عبر القناة لتحسين وضعها التفاوضي على نحو ما فعل السادات، وإنما كانت ستشمل انتزاع مصر للممرات الجبلية واستعادة سيناء بكاملها بقوة السلاح. غير ان هذه المجموعات كلها تتفق على بعد واحد، لا يمكن إلا أن يلفت النظر حقاً، وهو المتعلق بالتوقيت، فقد أجرى عبدالناصر مناورات وفاته، حسب تأكيد عبدالمجيد فريد، ويؤكد سامي شرف بدوره ان الخطط كانت جاهزة تماماً لهجوم من مرحلتين لتحرير سيناء حتى قبل قبول مبادرة روجرز ووقف اطلاق النار في يوليو، وكل ما كانت الحاجة ماسة إليه هي تلك الفرصة لنشر أنظمة الدفاع الجوي الصاروخية، وعندئذ كان الهجوم المصري سيبدأ في أكتوبر 1970 أو ابريل ـ مايو 1971 بحسب الاعتبارات المتعلقة بالطقس وحركة المد والتفضيلات العربية الأخرى.
ويؤكد وزير الإعلام محمد فايق أنه كانت هناك خطة جاهزة وكان يفترض أن موعد تنفيذها هو ربيع 1971. فقد كان هذا التوقيت حاسماً ومن المهم أن تنشب الحرب قبل نهاية 1971، لأنه في عام 1972 ستكون الولايات المتحدة قد سلحت إسرائيل بطائرات أكثر تقدما، وستكون الفرصة قد ضاعت، وبالتالي كان لابد من أن تشن مصر عملياتها القتالية عبر القناة في 1970 أو في 1971 على أبعد تقدير، وهو ما أبلغ عبدالناصر به العقيد الليبي معمر القذافي في فبراير 1970.
هذه الخطة وضعها على الرف أنور السادات، بعد وفاة عبدالناصر في 26 سبتمبر 1970، ففي اليوم التالي لرحيل الزعيم العربي عقد السادات اجتماعاً بمشاركة رموز القيادة، وبينهم هيكل وفوزي ورياض وهويدي وشرف، جرت فيه مناقشة ما إذا كان يتعين على مصر مد إيقاف النار. وفي ضوء الأوضاع الداخلية وتأكيد الفريق فوزي ان القوات المسلحة ستهاجم الآن إذا أعطيت أوامر مكتوبة بذلك، إلا أنها ستكون في وضع أفضل في غضون شهرين، وهذا ما تم الاتفاق عليه أي التأجيل.
بحلول نوفمبر من العام نفسه، كان الرئيس المصري الجديد قد رفض كلية فكرة استعادة سيناء بالقوة. وسيقتضي الأمر شهوراً عديدة من التردد السوفييتي والصلف الإسرائيلي واللامبالاة الأميركية قبل ان يتخلى السادات عن الأمل في حل سياسي بصورة خالصة. وتقول المؤلفة أصبح تراث عبدالناصر موضوعاً لخلاف عميق في مصر في مرحلة السادات، ونحن بالطبع نعرف ان الأمر أكثر تعقيداً بكثير مما تصوره المؤلفة هنا.
ويلفت نظرنا هنا رأي اللواء طلعت مسلم الذي تشدد عليه المؤلفة والذي يذهب الى أن «الخطة 200» كانت خطة دفاعية، وانه قبل وفاة عبدالناصر لم تكن هناك خطط «جدية» على الإطلاق، وإنما كانت هناك خطط يتعين التفكير فيها، ومن ثم يخلص إلى رأي خطير هو أن شن هجوم مصري في أواخر 1970 كان من شأنه أن يكون مستحيلاً من الناحية اللوجستية،
وتقفز لورا جيمس من هذا كله إلى استنتاجها الخاص في صفحة 169 من الكتاب، فتشير إلى أن الاحتمال الغالب هو أن الخطط التي يشير إليها المتحمسون لعبدالناصر لا تعدو أن تكون سيناريوهات طوارئ غامضة، كانت ستؤجل مجدداً مع اقتراب موعد التنفيذ الحرج، وهي عملية تشير إلى أنها تكررت على امتداد الصراع، وأنه من المحتمل أن عبدالناصر كان سيقبل ما تصفه بـ «عرض سلام معقول» بعد أن أصبح يعتقد أن مصر لم تعد في وضع متدن، حيث أبلغ الولايات المتحدة في 9 سبتمبر بأنه لا يزال مهتماً بالسلام.
المدهش أن المؤلفة تعود إلى مناقضة نفسها، على الفور تقريباً، حيث تشير في السطور التالية مباشرة من صفحة 169 إلى أن هناك أدلة قوية تؤكد أن عبدالناصر لم يكن يتوقع أن يتلقى عرضاً بالسلام ينتمي إلى هذا النوع، وذلك في ضوء الصور المرتسمة في ذهنه عن الولايات المتحدة وإسرائيل، وأنه كان يعتقد أن الحرب ستكون ضرورية في نهاية المطاف، وبالتالي فإن قبوله لوقف إطلاق النار بمقتضى مبادرة روجرز لم يكن إلا خطوة تكتيكية في مواجهة مستمرة، ولم يتوقع أن تكون تلك هي خطوته الأخيرة.
لكنها كانت كذلك بالفعل، ففي نهاية الأسبوع الذي ربما كان أكثر عناء وإرهاقا في حياته، قال عبدالناصر على فراش الموت «لم أجد ما توقعته» من دون أن يكون هناك من يفسر بصورة دقيقة ما الذي كان يقصده قبل صمته النهائي.
أصل .. وصورة تتطوع لورا جيمس بتفسير لكلمات عبدالناصر الأخيرة من عندها،
حيث تشير إلى أن الزعيم العربي الذي كان طوال عمره مولعاً بمتابعة الأخبار السياسية في نشرات الأخبار التي تبث من مختلف إذاعات العالم ربما كان يشير إلى أنه لم يجد ما كان يتوقعه من أخبار فيما سمعه عبر المذياع القريب من فراشه.
وهي تبادر ضمنا إلى وصف محاولة التفسير هذه التي تبرعت بها بالسطحية والبعد عما هو محتمل، حيث تشير إلى أن من المحتمل بصورة أكبر أن عبد الناصر ربما كان يشير إلى أنه لم يجد ما يتوقعه في رحلته السياسية بكاملها من ضابط أركان مولع بالصمت والتدخين والإصغاء للآخرين أكثر من الحديث والكشف عما يفكر فيه إلى رئيس لأكبر بلد عربي وهو يمر بأكثر منعطفات تاريخه خطورة.
لكنها تخرج من هذا السياق لتشير إلى أن عبدالناصر ربما كان قد وقع في فخ تصوراته المعادية عن الآخرين.
تقتطف المؤلفة هنا مقدمة أوسكار وايلد الشهيرة «الإنسان لا يمكنه أن يكون حذراً أكثر مما ينبغي في اختيار أعدائه». وتحاول تطبيقها على عبدالناصر.
مشيرة إلى أن الرجل الذي كان البعض يشيرون إليه في وقت ما من الخمسينات بلقب «الكولونيل جيمي» بسبب موقفه المتحمس للأميركيين لم يستطع الإفلات من الإطار الذي أوجده هو نفسه للولايات المتحدة، والذي تحولت في إطاره إلى العدو الأول لمصر، وأصبحت مقترنة بالصورة السلبية الخالصة لكل من بريطانيا وإسرائيل.
وعلى الرغم من اننا لسنا ندري من أين أتت المؤلفة بهذا اللقب العجيب، «الكولونيل جيمي»، ولا بالزعم بأن عبدالناصر كان في أي وقت من الأوقات متحمساً للأميركيين، فإن من المهم أن نتابع تحليلها لتأثير الصورة المرتسمة لدى عبدالناصر عن أميركا في تطور أحداث المنطقة، فهذا الموضوع كما سبق أن أشرنا يشكل خطاً ناظماً في الأطروحة السياسية التي شكل الكتاب الإطار النهائي لها.
وتشير المؤلفة إلى أن صورة عبدالناصر عن الولايات المتحدة تطورت عبر الحروب وأدامت هذه الحروب بدورها، وهي الصورة التي تعرضت لتحول كبير في السنوات الأربع الممتدة بين الثورة المصرية وأزمة السويس، حيث تردت العلاقات «الوثيقة» بين الضباط الأحرار ومندوبي الولايات المتحدة وممثليها سريعاً .
وكان السبب الرئيسي لهذا التردي هو صعوبة بقاء واشنطن حليفة لمصر ولأعداء مصر في آن، وبصفة خاصة بريطانيا وإسرائيل. والنزاعات الحادة التي شكلت محطات في رحلة التردي هذه تطورت حول قضايا مثل الجلاء البريطاني عن منطقة السويس، إمداد مصر بالسلاح، مفاوضات السلام المحتملة مع إسرائيل، وقد شكل هذا كله السياق لانتقال عبدالناصر إلى تأميم قناة السويس في 1956.
تلفت لورا جيمس هنا نظرنا إلى أنه خلافاً للاعتقاد الشائع فإن «التأميم لم يكن الرد المصري المباشر على سحب دالاس لعرض تمويل سد أسوان العالمي، حيث كانت الحكومة المصرية تدرس هذه الخطوة منذ عامين كاملين، غير أن التوقيت الذي اختاره عبدالناصر لإعلان التأميم ربما كان راجعاً وفي الوقت نفسه كان رداً على صياغة بيان دالاس.
حيث كان رداً على الإهانة المتصورة من جانب دالاس للاقتصاد المصري ووصفه بأنه عاجز عن تحمل عبء بناء السد وأيضاً جاء ردا على الإشارة إلى أن السد لا يأخذ بعين الاعتبار مصالح السودان، وأكثر من ذلك جاء رداً على ما تم تصوره على أنه دعوة من دالاس إلى الشعب المصري للإطاحة بالنظام.
وتشير المؤلفة كذلك إلى أن عبدالناصر كان يعتقد أن أميركا وبريطانيا معاديتان لمصر، ولكنه في الوقت نفسه اعتقد أن الرأي العام سيمنعهما من الهجوم عليها، وكان مقتنعاً بأن بريطانيا سترفض التعاون مع إسرائيل، لكنه لم يتوقف للحظة للتفكير في سيناريو يتضمن قيام إسرائيل بشن هجوم منفرد على مصر.
وفي ضوء هذا التحليل من جانب المؤلفة، فإنها تشير إلى أنه ما من شيء حدث في صيف وخريف 1956 غير من وجهات نظر عبدالناصر، فظل يحاول استقطاب التعاطف الدولي وإحداث انقسام بين الولايات المتحدة وحلفائها، وعلى الرغم من الأدلة الواضحة على العدوانية الانجلو فرنسية والتخطيط العسكري المنسق، فقد واصل الاعتقاد بأن احتمال نشوب الحرب يقل.
وأنها قد يمكن تجنبها في نهاية المطاف، وفضلا عن ذلك فقد نظر إلى الخطر الذي تشكله إسرائيل على أنه خطر محدود، ولذا فإن فالقاهرة أخطأت كلية في فهم الهجوم الإسرائيلي عليها عندما بدأ في 29 أكتوبر 1956، حيث كان التفسير الأولي المصري هو أن الهجوم الإسرائيلي مجرد توغل حدودي محدود،
وحتى حينما أصبح نطاقه الحقيقي واضحاً فإن احتمال تواطؤ القوى الغربية مع إسرائيل لم يدر بخلد القاهرة، إلا بعد صدور الإنذار الانجلو ـ فرنسي، وذلك على الرغم من أن القاهرة تلقت تحذيرات من مصادر عديدة، من بينها السفارة المصرية في باريس وهي التحذيرات التي تم تجاهلها وتنحيتها جانباً على أنها غير محتملة الحدوث.
وتمضي المؤلفة بالتحليل نفسه إلى حرب يونيو 1967، فتشير إلى أن هذه الحرب غالباً ما تقدم على أنها نموذج للمضي الدولي إلى حافة الهاوية، غير أن هذا التفسير ليس كافياً، فقد كان حشد عبدالناصر للقوات المصرية في سيناء يعزى إلى التقارير السوفييتية عن تجمعات للقوات الإسرائيلية قبالة سوريا،
والصورة المرتسمة عن إسرائيل العدوانية دفعت القاهرة إلى التشديد على التهديدات الإسرائيلية الموجهة إلى سوريا، وعلى الرغم من الجهود المستميتة التي بذلها الإعلام المصري لتأكيد أن الطائرات الأميركية والبريطانية قد ساعدت في الهجوم الإسرائيلي، للحافظ على الصورة القائمة، إلا أن هزيمة 1967 أسفرت في النهاية عن النظر إلى إسرائيل على أنها أقوى عسكرياً مما كان معتقداً وأكثر استقلالاً عن الدعم الأميركي.
وتساعد هذه المفاهيم المتغيرة في تفسير موقف عبدالناصر خلال حرب الاستنزاف. وعلى الرغم من أن الاستنزاف كان إستراتيجية منطقية لإبقاء الضغط على عدو أقوى ولضمان مشاركة القوى الكبرى، إلا أنه لم يستطع حل مشكلات مصر الأساسية، وقد كان عبدالناصر عملياً فيما يتعلق بالفرص المحدودة المتاحة لمصر عسكرياً، ولكنه كان متشككاً بعمق في احتمالات التوصل إلى حل سياسي، ويرجع هذا في أحد جوانبه إلى الضوابط الداخلية والإقليمية. ولكنه حسبما تشير المؤلفة فوت بعض الفرص المحتملة للتوصل إلى حل وسط ممكن كان بالوسع التوصل إليه من دون تكاليف داخلية مفرطة.
ومن منظور المؤلفة أيضاً فإن تشاؤم القاهرة الأساسي قام على أساس صورة لإسرائيل كقوة توسعية متصلفة تدعمها الولايات المتحدة، ونظراً إلى المؤسسة الأميركية المعادية عاجزة وغير راغبة معاً في الضغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي العربية المحتلة.
وتعرب المؤلفة عن اعتقادها بأنه حتى قبول عبدالناصر لمبادرة روجرز في يوليو 1970 لم يكن يقوم على أساس أي تغيير جذري في الصورة المرتسمة لديه عن الولايات المتحدة، التي كان لا يزال ينظر إليها على أنها منحازة تماماً إلى إسرائيل، وإنما كان هذا القبول خطوة تكتيكية لتحسين فرص مصر في أي مواجهة مستقبلية، وهو الأمر الذي ظل احتمالاً بعيداً في وقت رحيله عن عالمنا.
الرجل والتراث
ما الذي يبقى من تراث عبدالناصر؟ ربما لم يكن هناك سؤال في الفكر السياسي العربي الحديث أكثر إثارة للجدل من هذا السؤال الذي ثارت حوله ـ ولا تزال ـ عاصفة من الجدل لها أول وليست لها نهاية.
يكفي أن نتذكر كيف أن الشارع العربي، بتلقائية مذهلة ووعي أصيل، عاد ليرفع صور عبدالناصر في المظاهرات التي احتشد الناس فيها مع اندلاع حرب الصيف الماضي. وبروز الطبيعة العدوانية والوحشية للكيان الإسرائيلي الذي لم يتردد في قصف المدنيين العزل والأبرياء في الجنوب اللبناني حينما وجد مؤسسته العسكرية عاجزة ومحبطة في مواجهة المقاومة.
ولا يحتاج المرء إلى كثير من التأمل لكي يدرك أن أصداء الناصرية تزداد ارتفاعاً كلما تعمق بحث الإنسان العربي عن المقومات الحقيقية والأصيلة لهويته في مواجهة ظروف صعبة تزداد كل يوم تعقيدا. هذا هو، على وجه الدقة ما تشير لورا جيمس في ختام كتابها إلى جانب منه، فهي تعرب عن اعتقادها بأنه كلما تم التعمق بصورة أكبر في تأمل الهوية العربية من حيث علاقتها بالديمقراطية الغربية من ناحية وبالإسلام السياسي من ناحية أخرى طور تراث ناصر صداه المعاصر المذهل بالنسبة للكثيرين.
وهي تلفت نظرنا إلى أن الكثيرين في صحافة الشرق والغرب لم يترددوا في الإشارة إلى العناصر المتوازية في كل من التدخل الانجلوـ فرنسي في حرب السويس منذ نصف قرن مضى والحضور الراهن لقوى الائتلاف في العراق. وعلى الرغم من أن هذا التشبيه أو القياس يبدو، من منظور المؤلفة، معيباً في العديد من الجوانب،
حيث أن الوضع العالمي للولايات المتحدة اليوم مختلف تماماً عن وضع بريطانيا في أعقاب الحرب العالمية الثانية، إلا أن هناك جانباً يبدو شديد الواقعية والصدق، حيث أن الإمكانية الكبيرة لتحول قضية العراق الدقيقة والحساسة إلى نقطة تجمع للتضامن والتوحد على امتداد المنطقة على المستوى الجماهيري تغدو أكثر وضوحاً مع مطلع كل شمس يوم جديد.
وتبدو فكرة كون البلاد العربية كياناً موحداً على الصعيد الروحي، إن لم يكن بالمعايير السياسية، وكأنها تشهد عملية احياء هائلة. وهو تيار لم يتنبأ به قط أولئك الباحثون الذين اعتقدوا أن هزيمة 1967 التي أعقبتها وفاة عبدالناصر بعد ثلاث سنوات قد عرقلت العروبة كأيديولوجية إلى الأبد.
والمقارنة، كما تراها المؤلفة، بعيدة عن الدفة، ذلك أن «صوت العرب» كان الأداة الصريحة المعبرة عن نفوذ الدولة المصرية، وبالمقابل فإن قنوات مثل «الجزيرة» فهي على الرغم من اتهامها من قبل البعض بأن لها أجندتها السياسية الخاصة، إلا أنها تعتز بدقتها في ما يتعلق بتغطية الحقائق وبانتقادها المرير للفساد العربي.
غير أن الفارق الأكثر أهمية هو، كما تشدد المؤلفة، ذلك الذي يرتبط بدور الإسلام في الحياة العامة، فالقومية العربية كما دعا إليها عبدالناصر هي نزعة علمانية بصفة عامة، وصرامة مع «الإخوان المسلمون» أشهر من أن يشار إليه، ووصل إلى حد الخطر الكامل للجماعة في عام 1954. وبهذا المعنى فإن تأثير عبدالناصر على القيادات الإسلامية قد يكون متمثلاً في الإسراع ببلورتها، وربما دفعها في اتجاه التشدد، وهو ما عجلت به هزيمة 1967.
وخلافاً لما قد نتصوره، فإن المؤلفة تشير في الفقرة الأخيرة من الكتاب إلى أن الهويتين الإسلامية والعربية تقودان إلى التحالف في مواجهة تحديات ما بعد الحرب الباردة، حيث لم تعد العروبة تمثل البديل العلماني للإسلام السياسي، وإنما هي إحياء لقدرة الهوية العربية، وترتبط بالتشديد على مكوناتها الإسلامية.
ويظل تراث عبدالناصر جلياً للعيان في هذه الأرض المشتركة بين قوى التضامن العربي والإسلامي، وهذه الأرض ليست إلا التشكك العميق في الغرب. أو هذا هو على الأقل ما تراه لورا جيمس مؤلفة هذا الكتاب، بينما يرى الكثيرون أن هذا التراث أوسع نطاقاً وأكثر عمقاً وأن الأرض الحقيقية التي ستثمر فيها بذوره هي.. المستقبل.
عرض ومناقشة: كامل يوسف حسين |