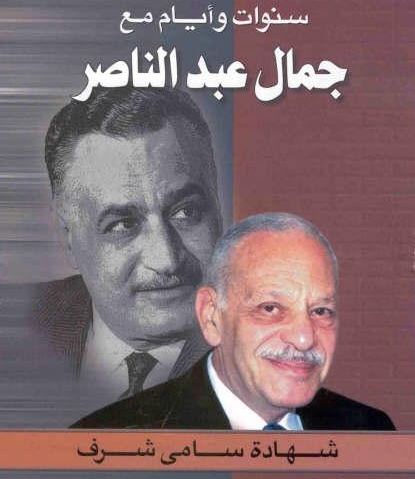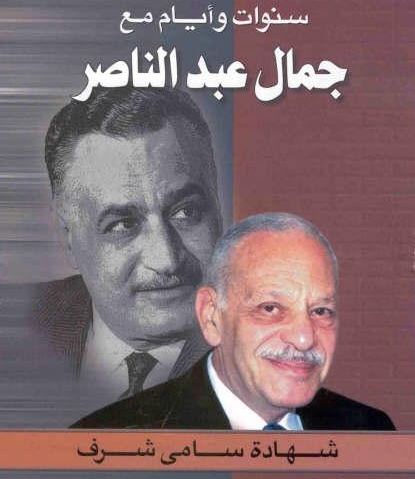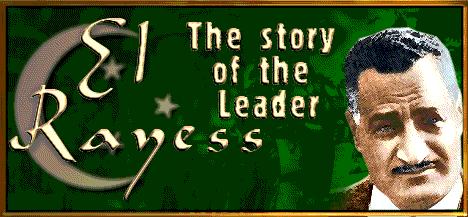| كتاب ـ ناصر محارباً ـ الحلقة (5)
كتاب ـ ناصر محارباً ـ الحلقة (5)
عبدالناصر يسعى وراء ثلاثة أهداف عبر حرب الاستنزاف
تأليف :لورا جيمس
من بين الحروب العربية جميعها، ربما كانت حرب الاستنزاف هي الحرب الأكثر جدارة بالدراسة والتحليل والتوقف عندها للخروج بالدروس المكتسبة، وهي في الوقت نفسه الحرب التي قدر لها عملياً، أن تبقى في الظل، وألا يلقى الضوء على أسرارها والتضحيات التي قدمها المقاتلون المصريون في غمارها، ويكاد ينحصر الاهتمام بها في إطار الدراسات المتخصصة في الاكاديميات العسكرية، ومن هنا تأتي الأهمية البالغة للفصل الذي تعقده لورا جيمس عن هذه الحرب في كتابها، وهو الفصل التاسع الذي يحمل العنوان الدال «لا بديل للمعركة: حرب الاستنزاف».
لكن ما هي بالضبط حرب الاستنزاف؟ متى بدأت؟ متى انتهت؟ ما هو موقعها في اطار الاستراتيجية الكلية التي وضعها الزعيم العربي جمال عبدالناصر لتحرير الأرض المحتلة؟ هل حققت الأهداف المنشودة منها؟ ما هي هذه الأهداف بالضبط؟ ما هي الصلة التي تربط هذه الحرب بحرب أكتوبر؟ على أي نحو يمكننا أن نفسر قبول عبدالناصر لمبادرة روجرز؟ هل كانت وقفة التقاط أنفاس تمهيداً للحرب؟ أم كانت مؤشراً لطريق آخر ربما كان عبدالناصر قد بدأ يتأمل إمكانية السير فيه؟ ربما كان السبيل الأكثر يسراً إلى فض تشابكات هذه الغابة من علامات الاستفهام هو أن نستعيد ذلك التقسيم الثلاثي الذي كان عبدالناصر والفريق محمد فوزي مولعين به، وهو المقاومة ثم الرد فالتحرير. لقد أعلن عبدالناصر نفسه في سبتمبر 1968 أن مرحلة المقاومة قد اكتملت، وقدم مبررات الاقتناع باكتمال هذه المرحلة وضرورة الانتقال منها إلى مرحلة الرد، كمقدمة منطقية إلى الانتقال إلى مرحلة التحرير.
كان في مقدمة هذه المبررات أن القوات المسلحة المصرية قد أعيد بناؤها من الناحية العملية، وأصبح 150 ألف جندي مصري معظمهم من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة تحت السلاح في مواجهة القوات الإسرائيلية عبر قناة السويس، وغدا بالإمكان الآن بدء مرحلة الرد أو الردع. الواقع أن هذا المفهوم على الأرض كان أكثر حيوية ونشاطاً مما يبدو لأول وهلة، حيث بدأ الاشتباك الفعلي مع العدو، لتعقيد حركته بعد أن كان جنوده يسبحون في مياه قناة السويس دون أن تتصدى لهم حتى طلقات القناصة، ولإيقاع الخسائر في صفوفه ولتدمير أسلحته ومعداته، وتلك كلها عمليات تعرف جماعياً في المصطلح العسكري باسم العمليات الدفاعية الوقائية. - أهداف حرب الاستنزاف: بدأت المرحلة الجديدة في الثامن من سبتمبر 1968، عندما فتحت القوات المسلحة نيرانها، منتهكة بذلك وقت إطلاق النار المفروض برعاية الأمم المتحدة، ومستهلة تراشقات هائلة بنيران المدفعية على امتداد قناة السويس أسفرت عن خسائر إسرائيلية كبيرة نسبياً.
على امتداد ذلك الشهر وقعت تراشقات أصغر في نطاقها، وبدأت صحف القاهرة في استخدام هذا التعبير، «حرب الاستنزاف»، وأجرى الفريق محمد فوزي سلسلة من المناورات التي استهدفت إعداد الجيش للحرب، فقد كانت الخطوة التالية هي ـ بوضوح لا يحتمل اللبس ـ خطوة «التحرير». وصل احتدام الموقف على القناة إلى حد منع ناصر من اتمام زيارته التي كانت مقررة إلى موسكو، وبدأت صحته في التراجع بحكم الجهد الهائل الذي يبذله، الأمر الذي حدا بالأطباء السوفييت إلى نصحه بقضاء بعض الوقت في منتجع صحي. من المهم أن نلاحظ هنا أن القاهرة كانت حريصة على التشديد دبلوماسياً على رغبتها المخلصة في إنهاء حالة الحرب، والدبلوماسيون الغربيون الذين تلقوا هذه الرسالة كانوا هم أنفسهم الذين تابعوا بذهول القصف المدفعي المصري الهائل في 26 أكتوبر 1968 والذي تزامن مع عملية قامت بها القوات الخاصة في ذلك الوقت المعقل الأثير عندها، ممر متلا العتيد.
من المهم بالدرجة نفسها ان نلاحظ ان هذا التحرك يستند إلى بعدين:
* البعد الأول يتمثل في أنه كان من الضروري أن تبادر القاهرة بالتصعيد لأسباب داخلية، فقد كان الجيش الذي أعيد بناؤه يرغب في ان يبرهن على معدنه الحديدي، وفي الوقت نفسه أشارت مظاهرات الطلاب الحاشدة إلى حتمية رفع معنويات المدنيين، أو الجبهة الداخلية، وفقاً للتعبير الذي درجت صحف القاهرة على استخدامه في تلك الفترة.
البعد الثاني، يبدو بوضوح، من خلال ما بدا جليا من أن الخيار، الدبلوماسي لم يكن واعداً بحال، وراحت، احتمالاته تتقلص بصورة متزايدة إلى حد أن القاهرة، فقدت عملياً إيمانها بجدوى، اعتماده أو اللجوء، إليه أصلاً. لابد لنا أن نلاحظ أيضا، ما درجت إسرائيل، على اتباعه دائما في تعاملها مع العرب،، فكل، قوة عربية لابد أن تواجه بقوة إسرائيلية أعنف إلى حد البطش، تطبيقاً لمفهوم الردع،، وهو ما نجد أن العقلية الإسرائيلية تتبعه منذ التكوينات الأولى لمجموعات الهاجاناه حتى اليوم.
وفي تطبيق مباشر للفكر الإسرائيلي، في هذا الجانب بادرت، إسرائيل، في ليل الحادي والثلاثين من أكتوبر إلى القيام، بعملية توغل في العمق عبر قواتها الخاصة في صورة غارة على محطة التحويل، وكوبري نجع حمادي، في صعيد مصر، الأمر الذي لفت نظر، القيادة المصرية إلى أنها بحاجة إلى تدعيم شامل وضعية المرافق الأساسية على امتداد، مصر كلها، وبحاجة، في المقام الأول إلى تلك العملة الصعبة.. الوقت.
الوقت هنا تمثل في كبح جماح، القوات المصرية حتى مارس 1969، وهو، الوقت الذي اكتملت فيه سلسلة من الدفاعات الهائلة، عن كل الأهداف المدنية الحيوية داخل مصر. بهذا المعنى فإن «حرب الاستنزاف»، في معناها الأشمل كانت استئنافاً لاستراتيجية، تم التخلي عنها مؤقتاً، ولكن لم يتم إسقاطها كمفهوم، قابل للتطبيق.
كان لابد، أن تصمم القاهرة على استئناف القتال في أقرب وقت ممكن لأن، إسرائيل في غضون ذلك، كانت تنسج نسيجها الخاص، فقد بدأت في تشييد خط بارليف وهي عبارة عن سلسلة من الدفاعات والمواقع الحصينة على امتداد قناة السويس، وعلى الرغم من أنه في جوهره كان سلسلة إجراءات دفاعية إلا أن أحداث خريف ذلك العام برهنت على أنه محاولة إسرائيلية لتثبيت الحدود عنده وفرض الوضع القائم ربما إلى الأبد.
ونظر عبدالناصر نفسه إلى الخط، على أنه تأكيد لاعتقاده بأنه، لا أمل في الحل السياسي، ما لم يدرك العدو أن مصر بمقدورها مواجهته، وإجباره على الانسحاب من خلال القتال، ومن هناك جاء قرار إحياء الخطط القتالية في 20 يناير.
تعزز اعتقاد، عبدالناصر، هذا باستحالة الحل العسكري بفعل قيام القوات الخاصة الإسرائيلية بغارتها على مطار بيروت في 28 ديسمبر، التي دمرت فيها 13 طائرة عربية على الأرض، رداً على هجوم الفدائيين الفلسطينيين على طائرة، تابعة لشركة العال الإسرائيلية في مطار أثينا قبل ذلك بيومين اثنين.
في فبراير، سمح للقوات المصرية باستخدام نيران الأسلحة، الصغيرة بحرية ودون انتظار أوامر ضد العدو على امتداد القناة وصدرت الأوامر للأركان بالإعداد للمعركة. وأعلنت حالة الطوارئ. في 8 مارس، 1969 فتحت القوات المصرية نيران مدافعها مجدداً عبر القناة،، وأعلن متحدث باسم الحكومة المصرية أنها لم تعد مقيدة بوقف إطلاق النار، وكان ذلك هو المناخ الذي استشهد فيه الفريق عبدالمنعم رياض، رئيس الأركان وسط جنوده على الجبهة في حدث هو الأول من نوعه في تاريخ العسكرية العربية الحديثة.
لكن ما هي حقاً الأهداف من وراء هذا المواجهة، بالنيران عبر قناة السويس؟
الواقع أنه يمكننا الحديث، بأوسع، المعاني، عن ثلاثة أهداف رمى عبدالناصر إلى تحقيقها، وهي على التوالي:
ـ أولا: تحضير الداخل، للمعركة،، فما يجري هو في واقع، الأمر تجهيز، عملي، ومعنوي للجبهة الداخلية للمعركة مع العدو التي غدت وشيكة وحتمية.
ـ ثانيا:، إقناع إسرائيل، بصورة عملية بأنها لا أمن لها في سيناء، من خلال تأكيد، أن خسائرها أعلى من أن تحتملها اقتصادياً ونفسياً في ضوء الخسائر في صفوف القوات الإسرائيلية.
ـ ثالثاً: خلخلة استقرار المنطقة، وإشراك القوى العظمى، في تطوراتها وإقناع، العالم بأن مصر ستحارب دفاعاً عن حقها الذي لم تستطع، استرداده بالوسائل، السياسية وعبر القنوات الدبلوماسية.
إطلالة كيسنجر الأولى
لست أشك في أن الكثيرين قد تساءلوا: متى أطل هنري كيسنجر مستشار الرئيس الأميركي ووزير الخارجية الأميركي الأسبق على ساحة الشرق الأوسط، لأول مرة وفي أي ظرف كانت تلك الإطلالة؟
ها هي الإجابة تطل علينا عبر صفحة 152 من الكتاب، حيث تطالعنا المؤلفة بالتأكيد على أن رؤية القاهرة للولايات المتحدة في هذه المرحلة قد اتسمت بشعور حاد بخيبة الأمل يعزى إلى عاملين محددين:
العامل الأول أن الولايات المتحدة وافقت على زيادة امدادها لاسرائيل بالاسلحة في 2 نوفمبر 1969 الأمر الذي دعا عبدالناصر إلى تأكيد انه لايمكن ان يكون هناك تعايش بين مصر والولايات المتحدة، لأن الاميركيين متعاطفون اولا واخيرا مع اسرائيل.
وقد اعترضت القاهرة بصفة خاصة على صفقة طائرة الفانتوم الاميركية المتقدمة لاسرائيل التي اصبحت مصدرا للاحتكاك المتكرر بين القاهرة وواشنطن وقد اقترحت القاهرة أن يكون الحد من تصدير الاسلحة الأميركية إلى اسرائيل ايماءة ودية من اميركا نحوها، بما يعقبها بالنظر في تبادل السفراء بينها وبين واشنطن.
هنا بالضبط يبرز كيسنجر الذي كان قد عين حديثا مستشارا للرئيس الاميركي لشؤون الأمن القومي، فقد نقل عنه تصريحه الشهير بأن الاقتراح المصري لم يترجم وبالتالي فقد أهالت واشنطن الرماد على هذا الاقتراح.
العامل الثاني اكتشاف القاهرة أن سياسة إدارة نيكسون لن تختلف كثيرا فيما يتعلق بالشرق الأوسط عن سياسة إدارة جونسون وكان عبدالناصر قد بادر الى إرسال رسالة تهنئة إلى نيكسون والمح انه يتوقع ردا شاملا وسعد بورود الرد العنيد من واشنطن وزاد تفاؤله من خلال المحادثات التي أجراها مع وليام سكرانتون الذي قام بجولة في الشرق الأوسط للحديث باسم نيكسون وبدأ هيكل في هذه المرحلة يلمح بحذر بالغ الى توقع حدوث تحسن في الموقف الأميركي.
ولكن في مارس كان محمود رياض لايزال على تشاؤمه وأكد ان إدارة نيكسون لم تقم بأي شيء أفضل مما قامت به إدارة جونسون ووافقه محمود فوزي على انه لم يحدث الحد الأدني من التحسن في الموقف الأميركي. ومرة اخرى يلفت نظرنا زعم كيسنجر أن الولايات المتحدة كان يمكنها أن تستأنف عملية السلام بشكل اكثر نشاطا في وقت مبكر من مسيرة ادارة نيكسون لو ان عبدالناصر كان أكثر مرونة وذلك على الرغم من ان مستشار الرئيس الأميركي يعود ليقر بأن الجمود الذي ران على الشرق الاوسط كان ملائما لمفهومه الاستراتيجي عن الحرب الباردة في هذه المرحلة.
أحلام الفارس القديم
غير أن هذا الجمود نفسه الذي ناسب أغراض كيسنجر بوضوح كان مربكا للغاية بالنسبة لمصر، بعد العشرين من يوليو 1969 ويتذكر المشير عبدالغني الجمسي ان القيادة العسكرية المصرية ادركت ان تقويمها للرد الإسرائيلي المتوقع على حرب الاستنزاف كان مفرطا في التفاؤل، فهي لم تتوقع ان تبادر اسرائيل الى القاء قوة سلاحها الجوي بكاملها في الحرب وهي خطوة اعطت لاسرائيل سريعا ميزة هائلة من خلال الطائرات الموجعة على العمق المصري.
وعلى الرغم من ان فرادة الغارات الاسرائيلية على مواقع كتائب الصواريخ المصرية كان صدمة للبعض الا ان العنف الذي جوبهت به هذه الغارات من قبل المقاتلين المصريين لم يكن متوقعا كذلك من منظور اعداء مصر.
هكذا يبدو مفهوما ان يطل عبدالناصر في 23 يونيو من ذلك العام من منصة مجلس الشعب المصري ليؤكد ان القوة والعمل العسكريين المصريين يدخلان مرحلة جديدة وذلك على الرغم من سعي اسرائيل لاحراز نصر رخيص وفي اليوم التالي مباشرة اقال قائد سلاح الطيران وهو ماتم تفسيره بأن المعركة اصبحت على الابواب.
واصلت مصر هجماتها على امتداد الشهر التالي وانتقلت من القصف المدفعي الى القصف القاتل بالهاون على اختلاف اعيرتها وبالاسلحة الصغيرة وردت اسرائيل باللجوء الى اسلوب يستهدف المعنويات في المقام الاول وهو الهجمات بمجموعات القوات الخاصة في العمق بما في ذلك نسف محطتي رادار وقتل المئات من المصريين وحاولت مصر الضربة بعد يومين لكنها خسرت 18 طائرة في معركة جوية ضارية.
ابتداء من هذا المنعطف تعرضت المواقع المصرية على القناة لقصف جوي إسرائيلي منتظم، ومن جديد تخلص عبدالناصر من قيادات لم يكن راضيا عن أدائها بما في ذلك رئيس الأركان أحمد إسماعيل الذي كان قد حل محل محمد صادق.
في اليوم نفسه أي 18 سبتمبر ألغي الفارس الذي لم يدر أحد أنه قد شرع يترجل رحلته التي أزمع القيام بها إلى موسكو، وكان السبب المعلن للإلغاء هو تعرضه لنوبة من الانفلونزا، لكنه في الحقيقة كان قد عانى من نوبته القلبية الأولى، مما أرقده طريح الفراش على امتداد شهرين.
وبغض النظر عن الحالة الصحية للفارس القديم، فإن القادة العسكريين المصريين كانوا يعرفون ان قواتهم ليست جاهزة للمعركة الكبرى بعد، ففي اجتماع لدول المواجهة العربية في سبتمبر تقدم الفريق محمد فوزي بتقرير خلص فيه إلى أنه حتى مع التنسيق الكامل بين الجيوش العربية، فإنها لن تكون جاهزة للمعركة قبل 18 شهراً.
خيارات صعبة
هكذا فإن القاهرة وجدت نفسها في مواجهة مجموعة من الخيارات الصعبة في نهاية 1969، أبرزها ما يلي:
* الخيار الأول ـ كان يمكن للقاهرة القبول بخطة سلام أميركية، غير أنه على امتداد صيف 1969 وخريفه ظل الموقف المصري من الولايات المتحدة بالغ التصلب، ففي نهاية يوليو رفضت مصر خطة سيسكو التي أبلغ عبدالناصر مجلس الوزراء
فيما يتعلق بها أنها لا تختلف كثيرا عن الخطط الأميركية التي سبقتها والتي تسعى كلها وراء استسلام مصر للأميركيين والإسرائيليين، وتعزرت رؤية عبدالناصر هذه مع قيام واشنطن بالبدء في تسليم طائرات الفانتوم لإسرائيل في سبتمبر من ذلك العام، وفي نهاية أكتوبر سلمت الولايات المتحدة إلى السفير السوفييتي أناتولي دوبرينيين خطة روجرز التي رفضتها القاهرة بدورها.
الخيار الثاني ـ اقناع الدول العربية الأخرى بتقديم الدعم لمصر، وهو ما جرت مناقشته في القمة العربية التي عقدت في الرباط بالمغرب في 1969، وتم البحث في خطط عمل شاملة يمكن من خلالها تنشيط الأردن وسوريا كجبهة ثانية وطلب من الدول العربية النفطية تقديم أرصدة اضافية لشراء أنظمة أسلحة الكترونية متقدمة.
كان الاتحاد السوفييتي قد رفض حتى ذلك الوقت تقديمها لمصر، وكانت المبالغ المقترحة تتراوح بين 70 إلى 250 مليون دولار في صورة عملة صعبة. وكان عبدالناصر يحاول على امتداد عدة أشهر الترتيب لعقد قمة أخرى، ولكن القمة برهنت على أنها مخيبة للآمال حقاً، حيث لم يتفق القادة العرب حتى في الحدود الدنيا، بما في ذلك إصدار بيان ختامي لقمتهم.
الخيار الثالث: والذي ينبع من أنه حيال المواقف البائسة لابد من إجراءات يائسة، حيث كانت مصر قد بدأت منذ ديسمبر 1969 في تحريك بطاريات صواريخ سام، إلى منطقة القناة، غير ان معظمها دمر في اطار غارات إسرائيلية مكثفة بالطائرات الأميركية التي وصلت إلى إسرائيل حديثا وبالاستعانة بقدراتها الالكترونية المتقدمة، وهنا لجأ عبدالناصر إلى طلب صواريخ سام 3 من الروس بالإضافة إلى طائرة ميج 21.
وللمرة الأولى طلب دفع أطقم سوفييتية لهذه الأسلحة الحديثة الأمر الذي كان يعني قيام موسكو بدفع عناصر سوفييتية إلى دولة غير شيوعية للمرة الأولى على الإطلاق، وتأكدت أهمية هذا الطلب مع تصعيد آخر من إسرائيل في 7 يناير 1970 حيث بدأت إسرائيل في شن غارات عنيفة على العمق المصري شملت تدمير قواعد عسكرية مصرية في العمق، ولإضافة الاهانة إلى الجرح، حسب التعبير الشهير، قامت القوات الخاصة الإسرائيلية في 22 يناير 1970 باحتلال جزيرة شدوان الواقعة في البحر الأحمر لمدة أربع وعشرين ساعة، وبدا واضحاً للقاهرة ان هذا كله مسلسل من الحرب النفسية يستهدف اسقاط النظام المصري في نهاية المطاف.
وهكذا استدعى عبدالناصر السفير السوفييتي لدى القاهرة للقاء عاجل في 20 يناير وبعد ذلك بيومين سافر سرا إلى موسكو، حيث طلب من القيادة السوفييتية إمداد مصر بصواريخ سام 3 وبأطقم سوفييتية إلى ان يتم تدريب أطقم مصرية على استخدامها، وكان الرد ان إرسال هذه الأطقم غير ممكن لأنها جزء من شبكة تقتضي الحماية بالطيران، وكان الرد على الرد هو إرسال طائرات ميج 21 جي المعادلة للفانتوم مع أطقم سوفييتية للتحليق بها.
كان الرد السوفييتي الأول على هذا الطلب هو الرفض، وهو ما عقب عليه عبدالناصر بأنه سيضطر في هذه الحالة إلى الاستقالة وأن يوصي بأن يشغل مكانه رجلاً يمكنه التوصل إلى سلام مع الولايات المتحدة حيث أن هذا هو الخيار الوحيد الباقي أمام مصر، وفي نهاية المطاف وافق المكتب السياسي للحزب على إرسال كل ما طلبه عبدالناصر.
هنا برز سؤال على جانب كبير من الأهمية: هل سعى عبدالناصر إلى المساعدة السوفييتية كجزء من استراتيجية طويلة المدى ومتماسكة للقيام بعمليات هجومية وتحرير سيناء؟
من الواضح أن الإجابة لا يمكن الوصول إليها إلا بالتدقيق في أحداث عام 1970 وصولاً إلى أصغر التفاصيل. المسألة الجوهرية هنا هي أن الإسرائيليين قد اضطروا حيال ضراوة الهجمات المصرية إلى تقليص عمليات القصف بالطيران في العمق المصري ثم إلى إيقافها كلية بعد 13 ابريل 1970.
وبحلول 30 يونيو 1970 كانت مصر قد أكملت بناء قواعد صواريخ سام2 وجلبت صواريخ سام3 الأولى، وتم إسقاط أول طائرتين من طراز فانتوم في استهلال مدو لما عرف تقليديا باسم «الحرب الالكترونية».
في غمار هذه المواجهات النارية المحتدمة أعلن وليام روجرز مبادرته الشهيرة الجديدة والبسيطة في 19 يونيو، والتي تنص على «وقف إطلاق النار وبدء التفاوض»، واقتصرت على الطلب من الطرفين المتصارعين الإعراب عن قبولهما لقرار مجلس الأمن رقم 242 واستعدادهما للتفاوض وموافقتهما على وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أشهر على الأقل.
تلك هي المبادرة التي قبلها عبدالناصر وهو القبول الذي أثار جدلا له أول وليس له آخر، وإن كان المؤرخون المنصفون يؤكدون أن الزعيم العربي قبلها لإعطاء مهلة التقاط أنفاس للجيش المصري قبل دخول المرحلة الثالثة، مرحلة التحرير.
هكذا فإن وقف إطلاق النار بدأ في السريان في 8 أغسطس، وهو ما يجمع الكثير من المصريين على تأكيد أنه جزء من خطة ناصر الشاملة لاستعادة سيناء بالقوة، التي كان يمكن أن تنفذ بعد ذلك بوقت قصير، لولا أن الفارس القديم كان الأوان قد آن لكي يترجل، حيث أصيب بالنوبة القلبية الأخيرة، وفي 29 سبتمبر 1970، وكما يموت كل الناس ... مات.
عرض ومناقشة: كامل يوسف حسين |