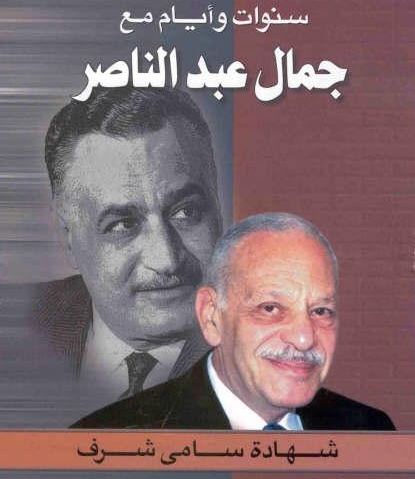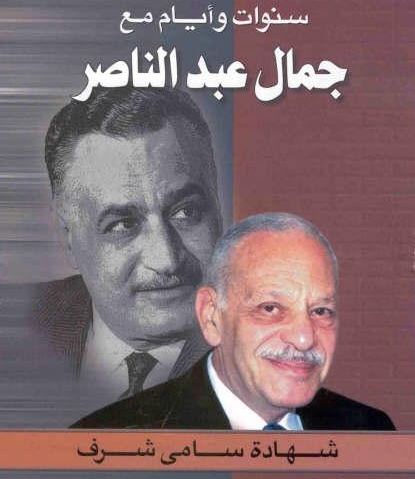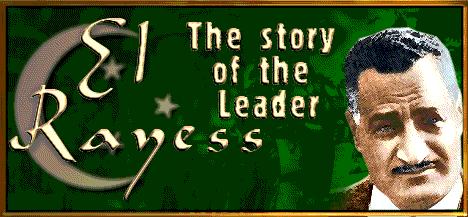| كتاب-ناصر محارباً-الحلقة(3)
كتاب-ناصر محارباً-الحلقة(3)
مونتجومري يحذر مصر من خسارة الحرب مع إسرائيل
تأليف :لورا جيمس
تقدم المؤلفة، لورا جيمس، لوحة بانورامية هائلة لمقدمات حرب الخامس من يونيو 1967، ووقائعها على الصعيدين العسكري والسياسي، قبل أن تخلص إلى النتائج التي ترتبت عليها، والتي يذهب بعض المراقبين إلى التأكيد على أننا لا نزال نرى التجليات المتأخرة لها حتى اليوم.
لكن القارئ، وهو يتابع الشهادات التي تتوالى عبر المقابلات الحية والمباشرة، التي أجريت خصيصاً لهذا الكتاب، وجهود تدقيقها استناداً إلى وثائق هذه المرحلة، لا يملك إلا أن يتأمل سؤالاً محدداً، يفرض نفسه عليه بقوة، وهو: هل كان هناك مجال لتجنب ذلك الاثنين الأسود الذي فقدت فيه مصر عشرة آلاف مقاتل دفعة واحدة؟ دعنا نلاحظ أولاً، بحكم مقتضيات الأمانة في عرض الكتاب، أن المؤلفة لم تقفز دفعة واحدة، من أزمة السويس إلى حرب 1967.
وإنما مرت قبل ذلك، على امتداد الفصلين الرابع والخامس من الكتاب، بحكايات طويلة عريضة، تبدأ ثم لا توشك على أن تنتهي، حول حرب اليمن والصراعات العربية ـ العربية، لكننا نعتقد أن تفاصيل هذه المرحلة تندرج في اهتمامات الباحثين والمؤرخين الاختصاصيين، بأكثر مما تندرج في اهتمامات القارئ العام الذي يقرأ هذا الكتاب وعينه على المستقبل.
بمعنى أنه يريد أن يخرج من قراءة وقائع الماضي بما يخدم المستقبل، بما يفيد في مواجهات يعرف أنها آتية لا محالة، ومفروضة عليه بلا شك، من الأعداء أنفسهم الذين تتناولهم هذه البانوراما التي ترسمها المؤلفة هنا بكل دمائها ونيرانها وأحداثها الموجعة.ومن المؤكد أن القارئ سيلاحظ خطاً ناظماً لا يغيب بربط الأحداث منذ البداية الباكرة، وربما حتى اليوم، فقد رأينا أن «الصيف الهندي» في العلاقات بين القاهرة وواشنطن قد انتهى حتى قبل أن يبدأ.
تحذير مونتجومري
تستهل المؤلفة الفصل السادس من الكتابة بسؤال يبدو لنا لأول وهلة وكأنه لا تنقصه الوجاهة حقاً وهو: كيف أمكن للولايات المتحدة التي اعترفت بالحكومة اليمنية وقدمت لمصر المعونة الغذائية التي كانت في امس الحاجة إليها في ظل إدارة الرئيس كيندي في أوائل الستينات أن تعيد تحديد نفسها في غضون سنوات قلائل باعتبارها العدو الأول لعبد الناصر؟
لقد بدأت العلاقات المصرية ـ الأميركية في التدهور بحلول عام 1964، حيث تم تصوير اغتيال كيندي في القاهرة على أنه مؤامرة يهودية، ونظر عبدالناصر إلى خلفه ليندون جونسون على أن موقفه من العالم العربي أقل تقديراً بكثير من موقف سلفه، وقد اختلفت مصر مع الولايات المتحدة حول حشد هائل من القضايا على امتداد العالم، ابتداء من اليمن وحتى فيتنام.
تبرز في هذا الإطار الخلافات بين القاهرة وواشنطن بشأن القاعدة العسكرية الأميركية الجوية في ليبيا، التي أعلن العاهل الليبي الملك إدريس عزمه عدم تجديد الاتفاق بشأنها مع الأميركيين وساد الاعتقاد في واشنطن بأن القاهرة تقف وراء هذا القرار.من ناحيته بادر دين راسك وزير الخارجية الأميركي إلى تأكيد أن دعم القاهرة لحركات التحرر في إفريقيا بعامة وفي الكونغو بخاصة يشكل جوهر المشكلة القائمة بين مصر وأميركا.
في نوفمبر عام 1964، أحرقت الجماهير المصرية الغاضبة والحانقة على السياسة الأميركية مكتبة هيئة الاستعلامات الأميركية في القاهرة، ولم يتردد الدبلوماسيون الأميركيون في الإعراب عن اعتقادهم بأن السلطات المصرية لم تبذل جهداً كافيا للحيلولة دون وقوع هذا الهجوم في ذلك الوقت ولم تقدم الاعتذار المناسب في أعقابه، وبالطبع لم يساعد في تحسين الموقف قيام الطيران المصري بإسقاط طائرة صديق شخصي للرئيس جونسون في الشهر التالي. ونتيجة لذلك فإن لوشيوس باتل السفير الأميركي الجديد أبقى علاقاته بوزارة الخارجية المصرية في أضيق الحدود.
بحلول عام 1967 أقنع أمران داخليان القاهرة بأن المواجهة مع واشنطن آتية لا محالة، وهما:
ـ الأمر الأول تمثل في الحقيقة القائلة إن وضعية الاقتصاد المصري في الستينيات كانت تعني في أحد أبعادها الاحتياج المتزايد للمعونات الغذائية الأميركية، خاصة وأن شحنات القمح الأميركية شكلت ثلث إمدادات مصر الصافية من القمح في عام 1961، وأكثر من نصف هذه الإمدادات في عام 1962، الأمر الذي جعل القاهرة شديدة الحساسية تجاه أي تغير في السياسة الأميركية حيالها. وفي نوفمبر 1963 تم إقرار تعديل جرونينج لقانون المعونة الخارجية بما يحظر تقديم أي معونة أميركية إلى أي بلد ينغمس في عمل عسكري عدائي ضد الولايات المتحدة أو حلفائها.
وقد افترض الذين دعموا هذا التعديل أنه يشير في المقام الأول إلى مصر، وعلى الرغم من أن جون كيندي أدان هذا التعديل علناً، إلا أن موقف جونسون بدا أكثر غموضاً، وعلى الرغم من إنكارات الخارجية الأميركية، فقد بدا أن هذا التعديل يحمل إصراراً على استخدام المعونة الغذائية كأداة أميركية للسيطرة على السياسة الخارجية المصرية. ومن هنا لم يندهش الكثيرون عندما عرض جونسون في يناير 1967 معونة غذائية بقيمة 55 مليون دولار وهو ما يقل كثيراً عما كان متوقعاً، وكانت تلك خطوة نظرت إليها القاهرة على أنها عدوانية في أقل التقديرات.
الأمر الثاني تمثل في أن ناصر أقتنع تماماً بأن السي. آي. إيه كانت تتآمر ضده. وهو أمر لم يكن مستبعداً بالطبع، فهناك مؤشرات إلى أن السي. آي. ايه كانت تعمل ضد القاهرة، في وقت مبكر من صدر الستينيات، على الرغم من توجيهات كيندي بالوصول إلى حل وسط مع القاهرة. ومن الثابت أن قادة محطات السي. آي. إيه في دول عربية قد عقدوا مؤتمراً استغرق يومين في بيروت في نوفمبر 1962 للتوصل إلى آلية لـ «هزيمة ناصر».
وقد أبلغ ناصر في يوليو 1965 شو أين لاي وسوكارنو وآخرين بأنه مقتنع بأن الولايات المتحدة بدأت هجوماً مضاداً في العالم الثالث، وأن السي آي إيه لا تسعى لإسقاطه، وبالطبع لم يساعد في تحسين هذه إلقاء القبض على مصطفى أمين واحتجاز أميركي كان يتناول طعام الغداء معه وسط اتهامات بانقلاب ترعاه السي. آي. إيه.
تشير المؤلفة في صفحة 95 من الكتاب إلى أنه بحلول مايو 1967، أي عشية حرب الخامس من يونيو، كان العدو من منظور عبدالناصر ثلاثياً، فهناك الاستعمار ممثلاً في الولايات المتحدة وتابعتها بريطانيا اللذين يقودان الغرب، الذي نظر إليه على أنه الحليف العتيد لإسرائيل والمصدر الرئيسي لتسليحها، ثم يأتي الضلع الثالث في هذا المثلث والمتمثل في قوى الرجعية.
وتعيد المؤلفة إلى أذهان القراء العرب تلك الملامح الكئيبة المألوفة في الفترة السابقة للحرب، ففي مايو 1967 يردد وزير الدفاع المصري شمس بدران أصداء الاعتقاد السائد في المؤسسة المصرية بأن بمقدورها إلحاق الهزيمة بإسرائيل، حيث يقول: «كنا واثقين من أن جيشنا على استعداد وان إسرائيل لا يمكن أن تهاجم لأن تقديرات المخابرات أشارت إلى أننا أقوى من المدرعات والمدفعية والقوة الجوية، وكان التقدير هو أن إسرائيل لن تمضي بقدميها إلى قبر مفتوح».
وما أطال شمس بدران في طرحه سيوجزه عامر بكلماته الشهيرة، أو بالأحرى بكلمتيه الشهيرتين اللتين ذهبتا مثلاً، فعندما سأله عبدالناصر عما إذا كان الجيش جاهزاً للحرب. رد قائلاً: «رقبتي يا ريس!». بل إنه أوغل في التأكيد كثيراً، فعندما سأله محمود رياض في أوائل يونيو 1967 عن مدى استعداد الجيش، رد قائلاً: «إذا تحركت اسرائيل بالفعل ضدنا، فإن باستطاعتي بثلث قواتنا فقط الوصول إلى بئر السبع».
ويتذكر محمود رياض أن مساعدي عامر كانوا على رأيه، بل اعتقدوا أنهم ليسوا بحاجة إلا إلى ربع القوات المصرية للتعامل مع إسرائيل. غير أنه كان هناك من اختلف معهم بشدة، وقطع الشوط كاملاً في ذلك إلى التناقض معهم، ولم يكن صاحب وجهة النظر المناقضة هذه إلا فيلد مارشال مونتجمري ما غيره.
فقد زار القائد العسكري البريطاني العتيد القوات المسلحة المصرية في 12 مايو 1967، ولم يتردد في أن يوجه تحذيراً صارماً للقادة المصريين من أنهم سيخسرون الحرب مع إسرائيل إذا أقدموا على خوضها، وهو ما رد عليه الفريق مرتجي بقوله: إن الجيش المصري لديه أحدث الأسلحة الروسية، وأعرب عن رأي مماثل في كلمة موجهة للبث عبر أجهزة الإعلام المصرية ألقاها في سيناء، حيث قال: «قواتنا على أهبة الاستعداد لخوض المعركة خارج حدود الجمهورية العربية المتحدة».
غير أن ذلك كان بمثابة إساءة تقدير حقيقية للموقف، فقد تراجعت مصر في سباق التسلح مع إسرائيل منذ عام 1965، وقالت السي. آي. إيه في تقرير مرفوع إلى الرئيس جونسون في مايو 1967 ان المؤسسة العسكرية الإسرائيلية متفوقة نوعياً على جميع القوات العربية، وتنبأت بأن «إسرائيل يمكن يقيناً على وجه التقريب أن تحقق السيطرة الجوية على شبه جزيرة سيناء في 24 ساعة بعد أخذ زمام المبادرة أو في يومين أو ثلاثة أيام إذا وجهت جمهورية مصر العربية الضربة الأولى.
هل خدعوا ناصر؟
بالمقابل كانت أجهزة المخابرات المصرية التي ركزت على كم الأسلحة وعدد الجنود وليس على الكيف، تسيء تقدير القوة النسبية الإسرائيلية، بل إن خبراء التكتيك العرب بصفة عامة أجمعوا على أن إسرائيل ستعجز عن خوض حرب طويلة، وإنه ستكون هناك ميزة عسكرية ساحقة لدى الجانب العربي، لدى البدء في العمليات العسكرية العربية ضد إسرائيل، وفقاً لخطة واحدة منسقة.
هكذا كان الرأي العام داخل مصر على يقين من أن إسرائيل ضعيفة ومنقسمة وتخشى القتال من دون دعم خارجي، وهذا هو أيضاً ما أكده هيكل على صفحات «الأهرام» وما قاله ناصر نفسه في خطبه التي ألقاها في مايو 1967. من هنا يبرز السؤال المؤرق: هل خدعوا عبدالناصر فعلاً؟ هل صحيح أن عبد الناصر كانت له صلة محدودة بالجيش، حيث إن عبدالحكيم عامر من حجب الحقيقة عنه فيما يتعلق بقوة مصر النسبية؟
في مواجهة هذه التوعية من علامات الاستفهام يبرز تأكيد محمود رياض: لقد اعتقد عبدالناصر ان الجيش المصري مستعد للتصدي لأي نوع من أنواع الهجوم قد يحاول الإسرائيليون شنه. لكن هذا ليس الاحتمال الوحيد، وإنما هناك احتمال آخر تقول المؤلفة في اطاره، انه ربما كان عبدالناصر يعلم ان إسرائيل هي الأقوى، وانه كان «يبلف» ولم يتوقع حقاً أن يقاتل.
وتشير المؤلفة هنا، ربما في محاولة لدعم هذا الاحتمال الآخر، إلى ان زكريا محيي الدين قد أكد أن ناصر كانت لا تزال لديه طرق لمعرفة ما يجري حقاً في القوات المسلحة، وبالتالي فإنه كان يعلم انها أقل في النوعية من الجيش الإسرائيلي.
وتقتطف المؤلفة أيضاً، في هذا الصدد من كتاب «لعبة الأمم» قول مؤلفه مايلز كوبلاند: «أبلغني ناصر بنفسه بحوار مع المشير عامر جرى بينهما قبل اندلاع الحرب بأسبوع، وجه فيه لوما شديدا لكونه متخلفاً عن عصره بعشر سنوات، ولعدم قدرة الجيش المصري على ايقاع الهزيمة بمن واجهوه في اليمن، دع جانبا جيشا حديثا مدرباً كالجيش الإسرائيلي».
وتشير المؤلفة إلى أن مفتاح هذا التناقض الظاهر بين هذين الطرحين، الذي يقول احدهما ان عبدالناصر لم يكن يدري جلية ما يجري في المؤسسة العسكرية المصرية، بينما يؤكد الثاني أنه كان على علم بالحقيقة كاملة، يكمن في أن اعتقاد ناصر بقوة إسرائيل قائم على افتراضين، هما ان العرب منقسمون على أنفسهم، وان إسرائيل تدعمها قوى خارجية قوية.
4 خطط في 20 يوماً
من المؤكد أن وقائع حرب الخامس من يونيو أكثر تعمقاً في أذهان ووجدان العرب من ان نعيد سرد تفاصيل الوقائع التي أفضت إليها وامتدت عبر أيامها الستة حسب التسمية التي اختارها الإسرائيليون لها، على حين أن الباحث البريطاني جوناثان فريدلاند يؤكد في عدد «الغارديان» الصادر في 23 مايو الماضي ان هذه الحرب لم تنته وإنها مستمرة حتى اليوم.
فلنكتف إذن بالإشارة إلى المحطات الأكثر أهمية في هذه الحرب التي تقول لورا جيمس في صدر الفصل السابع من كتابها، في صفحة 102 على وجه التحديد إنها كبدت مصر عشرة آلاف رجل ذهبوا شهداء في خمسة أيام بالإضافة إلى فقد سيناء والقناة والمصداقية الإقليمية والعالمية.
وكانت قبل التعرض لهذه المحطات السريعة والمتتابعة، من المهم الإشارة إلى انه في مواجهة الخيارين بين جهل عبدالناصر بما كان يجري في المؤسسة المصرية أو اطلاعه الدقيق عليه فإن هناك حلاً وسطاً يطرحه أشرف غربال الذي سيشغل منصب السفير المصري لدى إسرائيل سنوات طويلة، حيث يقول ان عبدالناصر لم يخطط للحرب وأيضا لم يتعثر فيها، وإنما مضى إلى الحافة، ولكنه رغب في أن يوقفه الجميع، ولكنه عندما لم يوقفه أحد كانت النتيجة كارثية بالنسبة لمصر.
وربما يبدو هذا الطرح للبعض مغرياً بتبنيه، لكن الحقيقة كانت أكثر تعقيداً من ذلك، فقد تحرك عبدالناصر بداية للحصول على مكاسب سياسية لبلاده، ولكنه كان يدرك ان تحركه يتضمن مخاطرة جسيمة بالتسبب في عمليات عسكرية واسعة النطاق.
المحطة الأولى التي كانت بداية انفجار الأزمة هي، بحسب رؤية المؤلفة، أزمة مايو 1967 التي نشبت على عجل حول النزاع بين إسرائيل وجيرانها العرب حول تقسيم مياه نهر الأردن، وهو النزاع الذي كان يدور على امتداد عقد من الزمان، ولكنه أخذ في التصاعد تدريجياً، خاصة مع انكشاف الكثير من الحقائق حول مفاعل ديمونا النووي الإسرائيلي وصفقات السلاح الكبرى التي تدفقت على إسرائيل من الولايات المتحدة.
والتوتر بين إسرائيل وسوريا، الذي ظل في الثلاجة منذ فترة ليست بالقصيرة خرج منها على وجه التحديد في 14 مايو مع ورود تقرير يؤكد حشد إسرائيل لقواتها على الحدود مع سوريا، حيث صدرت الأوامر للقوات المصرية بالتعبئة الكاملة، بينما انطلق رئيس هيئة الأركان العامة الفريق محمد فوزي إلى سوريا للاطلاع عن كثب على حقيقة التهديد الإسرائيلي لسوريا وطمأنة القادة السوريين إلى وقوف مصر إلى جانبهم.
كان الهدف من التحركات المصرية هو ردع إسرائيل أكثر مما كان بدء حرب، وفي وقت لاحق سيقول عبدالناصر ان تقديره لاحتمال نشوب حرب في ذلك الوقت كان في حدود 20% فقط، بل ان عامر نفسه يؤكد لرئيس العمليات أنور القاضي ان الأمر لم يكن أكثر من «استعراض» ردا على التهديدات الإسرائيلية ضد سوريا. وأصدر أمره إلى الفريق فوزي بتنفيذ الخطة الدفاعية القائمة والتي حملت اسم «القاهر»، وأبلغه ان الهدف هو القيام بعملية نشر للقوات وحشد لها على نحو ما فعلنا عام 1960.
تمثلت خطوة ناصر التالية في التخلص من القوات الدولية المرابطة في سيناء، حيث تم إبلاغ قائد هذه القوات في 16 مايو بضرورة إصدار أوامره لرجاله بالانسحاب، وهي الخطوة التي زادت بصورة ملموسة من احتمالات نشوب الحرب. وكانت هذه القوات تتألف من 3378 رجلاً ولا يمكنها من الناحية العملية إيقاف تحرك أي من الجانبين، حيث كانت أهميتها رمزية في المقام الأول.
لكن الخطوة التالية التي قامت بها مصر هي التي ستبرهن على أنها كانت حاسمة في مجريات الاحداث، حيث قامت مصر بإغلاق مضايق ثيران ومن ثم أغلقت عملياً خليج العقبة في وجه الملاحة الإسرائيلية، وقد اتخذ هذا القرار في صبيحة 22 مايو 1967 في اجتماع للجنة التنفيذية العليا برئاسة عبدالناصر. وتثير المؤلفة دهشتنا عندما تشير إلى ان الخارجية المصرية لم يطلب رأيها أصلاً في هذا القرار على الرغم من خطورته واندراجه في صميم مسؤولياتها.
لكن لماذا خاطر عبدالناصر باثارة حرب من خلال إغلاق مضايق ثيران؟ إن المؤلفة تشير في هذا الصدد إلى رد الفعل الضعيف وغير الحاسم من جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي ليفي أشكول على الخطوات المصرية السابقة ثم ان اشكول بعث سراً بعدة رسائل يدعو فيها إلى الامتناع عن التصعيد، بينما أكد علنا نوايا إسرائيل السلمية، ودعا إلى الوساطة الدولية وتجنب توجيه الانتقادات إلى مصر.
أيا كان الأمر، فإن مصر خلال الاسبوعين التاليين وجدت نفسها أمام ثلاثة خيارات محددة، هي:
ـ شن الضربة الأولى على إسرائيل.
ـ الاستمرار في تصعيد الموقف وإجبار إسرائيل على الهجوم أولا أو التراجع.
ـ السعي إلى حل وسط.
ويبدو في نهاية المطاف أنه تم اعتماد الخيار الثاني. وكانت المشكلة الحقيقية هي أن القوات المصرية التي مضت تتدفق على سيناء لم تكن مدربة على شن هجوم. كما أن القادة الميدانيين الذين كانوا يهيبون بالقيادة السياسية المبادرة إلى توجيه الضربة الاولى وجدوا أنفسهم وقد سقطت عليهم أربع خطط مختلفة في 20 يوما في ذروة أزمة 1967.
الغي عام الخطة القائمة وهي «القاهر» فيما القوات تتدفق على سيناء» واعتمد الخطة الهجومية «اسد» التي تتضمن هجوما على ميناء ايلات وجزء من صحراء العقبة. وبعد اغلاق مضايق ثيران وسع نطاق أهداف هذه الخطة لتشمل صحراء العقب بكاملها بعمليتي «الفجر» و«الغسق» اللتين تقرر أن تصدر الأوامر الخاصة بهما من دار عامر مباشرة.
في 20 مايو تلقى سعد الدين الشاذلي قائد إحدى وحدات القوات الخاصة في سيناء اوامر بالقيام بمهمة هجومية تشمل التوغل داخل سيناء وصدرت التعليمات لإذاعة صوت العرب بالتصعيد، وفي 25 مايو كان كل شيء معدا للهجوم مع بزوغ فجر 27 مايو. على ذمة المؤلفة فإن هذا السيناريو بكامله تغير مع فشل عامر في اقناع ناصر بأن تقوم مصر بتوجيه الضربة الأولى بل ان الشاذلي لم يتلق أمرا بالتغيير من الخطة الهجومية إلى الخطة الدفاعية إلا في الاول من يونيو.
إذا كانت مصر قد عبرت خطا أحمر من المنظور الاسرائيلي، باغلاق مضايق ثيران فإن خطا احمر آخر تم عبوره بتوقيع اتفاقية دفاع مشترك بين مصر والاردن في 30 مايو. هكذا فإن القاهرة في حقيقة الأمر لم توجه الضربة الاولى ولكنها أيضا لم تخفف من حدة التوتر في موقف متأزم بطبيعته.
على الرغم من ان عبدالناصر ابلغ القيادة العسكرية بأنه يتوقع هجوما جويا اسرائيليا في الخامس من يونيو، إلا أن القيادات العسكرية فيما يبدو لم تحمل هذا التحذير محمل الجد، فكما نعلم جميعا كانت هذه القيادات وعلى رأسها عامر نفسه تحلق في ذلك اليوم في طائرة في الطريق إلى سيناء وقال شمس بدران وزير الدفاع انه اعتقد ان ناصر كان يكرر ما أبلغه بعض الصحافيين الاميركيين من تكهنات.
في ذلك الاثنين الاسود حلقت الطائرات الاسرائيلية في اطار ما سنعلم انه خطة «الحمامة» الاسرائيلية التي اعدت وجرى التدريب عليها على امتداد سنوات لتقضي على سلاح الطيران المصري ومن ثم على القوات المصرية في سيناء. وتعقب المؤلفة على ذلك بقولها ان القاهرة اعمت نفسها عن حقيقة ما جرى، حيث تجاهلت كل المؤشرات التي كانت واضحة تمام الوضوح أمامها.
لكن ما الذي جرى حقا في ذلك الاثنين المشؤوم في الافاق وعلى الأرض؟
عرض ومناقشة: كامل يوسف حسين
__________________
إن النصر عمل والعمل حركة والحركة فكر والفكر فهم وإيمان وهكذا فكل شئ يبدأ
بالإنسان
|