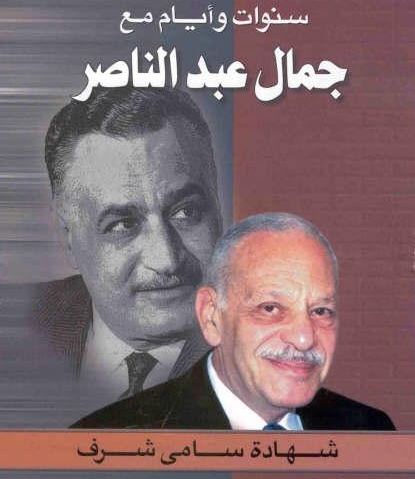 |
سـنوات وأيام مع جمال عبدالناصر
الدين . الفلسفة . العلم
( الجزء الأول )
بقلم
فــائز الــبرازى
بسم الله الرحمن الرحيم " إنما يخشى الله من عباده العلماء " صدق الله العظيم إن علماء الإنسانية هم الباحثون عن الله والقتفين والمتلمسين آثاره . بالمنطق و " إكتشاف " قوانين الطبيعة التي لابد لها من صانع وموجد وخالق . إن للكون : تاريخآ . وللحياة تاريخ . حكاية يحاول علماء كثيرون روايتها إستدلالآ وبحثآ . معتمدين على قواعد هي : 1- القوانين الطبيعية المكتشفة بشكل دائم . 2- قوانين النسبية . – وهذا يعني وجود قوانين أخرى كلية - . 3- قوانين وقواعد المنطق . 4- مبادئ ميول الطبيعة : وهي ميلانان رافقا الطبيعة منذ نشوئها : الميل إلى الإتحاد ، والميل إلى الإستقلال . – وهذا صراع وتناقض جدلي ضمن الكلي - . فلسفة الثنائية النسبية : ---------------------- خارج ( القدرة الإلهية الكلية والمطلقة ) ، تهيمن على الكون " ثنائية نسبية " . الخير والشر – الجمال والقبح – النور والظلام – الحياة والموت ... الخ ، ضمن الواحد . ففي الكون الذي نعرفه ، وفي الإنسان ، نجد هذه الثنائية ظاهرة . وأقول " نسبية " لأنها أساس منطلقات العقل في الفلسفة وفي العلوم الإنسانية ، والعلوم الطبيعية . تدرج النور والظلام في الكون ، نسبية الخير والشر في الإنسان وأيهما الغالب وبأي درجة . إذ ليس هناك حتى في الفرد الإنسان ، خير مطلق أو شر مطلق . ليس هناك جمال مطلق أو قبح مطلق .. فكل " الموجودات " تحمل ضمنها هذه الثنائية النسبية . الحياة .. والموت . كل موجود يحمل ضمنه الحياة والموت . من الكون ، النجوم ، الإنسان ، المخلوقات ، المادة . لكنني أكاد أعتقد أن : الحياة والموت ليسا طفرة مفاجئة .. أي ليس هناك ولادة فورية ، وليس هناك موت فوري . حتى تولّد النجوم يمر بمراحل طالت أو قصرت . ليس هناك نجم يخلق فورآ . وليس هناك نجم يموت ويخبو فورآ . ليس هناك زهرة تخلق وتظهر ككائن حي بلحظة ، ولن تموت بلحظة . ليس هناك إنسان يخلق ويوجد فور خروجه من الرحم . ولن يموت فجأة على غير ما إعتدنا عليه . الإنسان أمر آخر غير النطفة وغير البويضة وإن " تشكل" منهما . فهما اللتان معرضتان للفناء في حال عدم التلقيح . وهما لا يحملان في كينونتهما الحياة . بل يحملان عوامل أخرى مهما كانت تسميتها : آلية ، ميكانيكية ، فيزيائية ، كيميائية ، حركية ، نبضية ، إنعكاسية .. الخ أي شيئ عدا " حياتية " . الدين والعلم لم يقولا لنا أبدآ أنهما في مرحلة " حياتية " ، إنما في مرحلة وجودية لا يعرف لها كنهآ . إفراز وجودي لا تتوفر له " الحياة " إلا بالإندماج ، ثم إستمرار تفاعلات ذلك الإندماج . وكذلك كل أمر آخر . والموت .. لا يأتي مباشرة مهما كانت لحظته الزمنية في التحقق . مرض ، عوامل إستهلاك للخلية ، ضرر ناشئ عن أي أمر . فالحياة والموت ثنائية متلازمة بنسبية مختلفة . لا حياة ، ثم حياة ، ثم موت ، ثم حياة . – وإن إعترض بعض الإلحاديين على الدورة الثانية للحياة ، فهذا يتطابق "دينيآ وعلميآ " وسيأتي لاحقآ - . أي أن الموت موجود ضمنآ ومستمرآ منذ بدء الخلق . وهذا يقودني إلى تساؤل : هل الحياة سابقة على الموت ؟ أم أن الموت سابق على الحياة ؟ أم أنهما ثنائية كونية وجودية مندمجان ببعضهما ؟؟ . هنا نعود للبساطة الخالقة للتركيب والتعقيد . فما هي الحياة ، وما هو الموت ، ( بالمعنى العام ) ؟ . الحياة هي : الحركة ، التطور ، الإستمرارية ، البناء . الموت هو : الخمود ، الجمود ، الزوال ، التحطم . فأي معنى من معاني الحياة أو معاني الموت لا نعرفها ولم نعرفها ، إلا بالمقارنة بينهما . وإن تطرقنا إلى الفكرة القائلة : أن كل حي يحمل بذرة فنائه . فإنها لا تجيب عن تساؤلنا ، من أسبق . إذ يمكن القول : أن الفناء .. الزوال ، يحمل بذرة يطلقها قبل الموت ، هي بذرة الحياة . ( العدم ) .. قيل أن ( المادة لاتفنى ولا تخلق من عدم ) . وقد إرتكزت " الماركسية " منذ ماركس وما بعد في المؤتمر الرابع والعشرين للحزب الشيوعي السوفييتي قد تبنوا هذه المقولة العلمية آنذاك ، وإعتبروا المادة " تعريف " . بينما يطرح الآن وعلميآ أن : ( الطاقة – وليس المادة- لاتفنى ولم تخلق من عدم ) . أي أنها " أزلية" - تعبير إصطلاحي لا أكثر - . وهي هنا وكأن المادة أو الطاقة هي ( الله ) . وهذا غير صحيح بالنسبة للمادة . لأن للمادة عمر إفتراضي طال أو قصر ، وهو " العمر الذري " . والمادة " تتحول " أي أنها لا تبقى بذات الكيان والصيغة والشكل والمضمون والوظيفة . وهذا "التحول " ومع إستمراريته وفقدانه " لعمره الذري " سيموت . . أي سيزول ويتحول إلى ( عدم ) .. والصعوبة بتفسير معنى العدم . هل العدم إختفاء أم خفية ؟ أهو موجود أم أوجدناه " كمصطلح " مرتبط بقصور رؤيتنا وإدراكنا وعقلنا ؟ . من هذه ( التساؤلات / الشكوك ) يمكن أن نقول أن الحياة يمكن أن تخلق من عدم !! من الموت !! . هل يمكن أن نقول هنا عن " الخلق " ، بالثنائية ؟ ؟ . أي أن الوجود هو واقع يعبر ويحمل في ذاته ومنذ أن كان الوجود ، الحياة والموت أو الموت والحياة ؟ . وضمن هذه الثنائية و " بشكل عام " فهناك المادة ، وهناك الروح . الملموسات والغيبيات . والمادة هي الملموسات . أما الروح فهي الغيبيات الغير ممكن لمسها أو معرفة كنهها . شيئ إصطلح الدين والعلم " بدون توضيح " على تسميته . والروح : غير النَفسْ ، وغير النَفَسْ ، - بفتح النون والفاء - . الروح ( خاصة بالإنسان ) . والنَفْسْ مرتبطة ( بوعي الإنسان وخياراته ) . والنَفَسْ هو العامل المشترك لجميع الموجودات . الروح خاصة بالإله الذي أعطى جزءآ منها لخليفته في الأرض " الإنسان " . فلا يمكن إلا أن تكون طاهرة نقية . والنَفْسْ : هي الإختيار بعد الخلق .. [ ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها ] . وعليه يكون الإختيار والقرار والحساب . والنَفَسْ : مرتبط بكل الموجودات في هذا الكون الذي نعرفه نسبيآ . النفس هو مسبب الحركة والحياة والتحول والتغيير وصولآ إلى الموت . الإنسان : يتنفس الهواء ويحيا ضمن قوانين خاصة به . الحيوانات تتنفس الهواء حتى المائية منها وتحيا وفق قوانين خاصة بها . النباتات : تتنفس أيضآ .. المادة / الجماد : تتفاعل مع الهواء ، أو الأجواء المختلفة المحيطة بها وتحيا وفق قوانين خاصة بها . والعلم لم يقل شيئآ عن الميتافيزيقيا خارج الملموسات . لم يقل شيئآ عن الروح [ هي من أمر ربي ] . فأمامه – العلم – وأمامنا طريق طويل وشاق لنصل إلى فهم " مشترك " للدين والعلم . العلم تكلم عن " المادة " ولم يتكلم عن " الروح " . وهذا يقودني إلى تساؤل : طالما أن هناك ثنائية نسبية في الكون الذي نعرفه ، فما هو الطرف الآخر ( للمادة ) .. أهي الروح ؟ أهي ( المادة المضادة ) ؟ . المادة : والمادة المضادة : ( الإنفجار العظيم ) . ----------------------------------------- يقول العلم أن هناك " ذرة " إنفجرت وشكلت الكون . وينحو إلى إعتبار هذه " الذرة " هي مادة حتى وقت قريب . وأن الإنفجار العظيم قد ولد طاقة ، كما جميع البحوث والواقع العلمي تقول : أن ( المادة تولد طاقة ) . الذرة التي إنفجرت شكلت الكون وإمتداداته في إنفجارها ، والكون لايزال في " حالة تمدد " إلى أن يصل إلى مرحلة يتوقف التمدد ، ويعود إلى " الإنكماش " ، ليصل مرة أخرى إلى مرحلة تلك " الذرة " . وهذا تفسير عام يتفق مع التفسير الديني لبدء الخلق . لأن من نتائج هذا أمور كثيرة أدلها: توقف الدوران عند حد معين للتمدد ، ثم العودة للدوران " بإتجاه معاكس " عند بدء الإنكماش . وبالتالي يمكن للشمس أن تشرق من المغرب ، وتغيب في المشرق . – وهذا من ضمن آيات إعجاز القرآن - . وأعود لموضوع ( الإنفجار العظيم ) . فهل من " دليل علمي " على أن تلك الذرة المتفجرة هي ( مادة ) ؟ . ومن قام بتفجيرها ؟ وما هي الظروف التي أدت إلى إنفجارها ؟ خارج ( كن فيكون ) . هل يمكن لهذه " الذرة " أن لاتكون " مادة " . بل يمكن أن تكون ( ذرة طاقة ) . ذرة طاقة مضغوطة وإنفجرت ( مولدة المادة ) .. الكون ؟ . وسأتعرض لاحقآ لآراء علمية عن إمكانية تولد المادة من الطاقة . وهنا أصل إلى ( المادة ) .. و ( الطاقة ) . فيمكن أن يقال أن ( المادة المضادة ) هي بمثابة " اليين " أو المبدأ الأنثوي السلبي للكون ، بالنسبة إلى " اليانغ " وهو المبدأ الذكري الناشط للكون . وهذا في النهاية ما يحقق التوازن في المعادلات الفيزيائية . فالتفاعل الطبيعي الأبسط .. هو أن تندمج جسيمة من " المادة " بجسيمة مــن " المادة المضادة " المفترضة لتولد جسيمتين جديدتين يمكن أن تعرفان بإسم " الفوتونات " . و ( الفوتون ) هو في الواقع كناية عن " وميض ضوئي " بالغ الصغر ، ( الجسيمات الضوئية ) والتي تشكل الشكل الأنقى للطاقة . وهنا يمكن أن نقارن ذلك بطرح الأديان : - " سفر التكوين " ، " القرآن " : . مادة من طاقة ، شيئ من لاشيئ. وإذا نظرنا للأمر من ناحية ( فلسفية ) . وأكاد أعتقد أن الفلسفة ، التفكير ، الجدل ، التدبر ، الشك ، هي بدايات " العلم " . بدايات إكتشاف القوانين الكونية الموجودة . فمثلآ عندما جاهد / نيوتن / بعد سقوط التفاحة ، مفكرآ باحثآ عن السبب .. توصل إلى إكتشاف ( قانون الجاذبية ) . فإن تكلمنا بالمنطلق الفلسفي وتساءلنا : هل المادة هي الأزلية والتي لاتفنى وهي سبب الوجود ؟ أم أن الطاقة هي الأزلية والتي لا تفنى وهي سبب الوجود ؟ . عندها ومن البحث العقلي والتجاربي والعلمي يمكن للعلماء على مسار الأزمان ، من تحديد جواب لهذه التساؤلات . ومنذ سنوات تم إكتشاف تقنية مستوى ( النانو ) في البحث بالمادة – والنانو جزء من البليون – أنه كلما تعاملنا مع أشياء بالغة الضئآلة وتوغلنا في أعماق المادة ، فإننا نكتشف خصائص جديدة ( تمامآ ) .. مثل ( الأنابيب النانونية الكربونية ) الخارقة والمثيرة للدهشة . حتى أنها سميت : ( المادة الأعجوبة ) . فماذا سيتم إكتشافه عن ( الطاقة ) ؟ . فالمادة تتكشف عن معطيات بالغة الأهمية وتظهر خصائص جديدة مع تقدم العلم . فماذا عن الطاقة ؟؟ . الطاقة الكامنة ، والطاقة المضغوطة ، والطاقة المتفجرة .. ويبقى السؤال الهام .. هل المادة نتاج للطاقة ، أم الطاقة نتاج للمادة ، وبشكل جوابي جازم ؟ . ========================= فائز البرازي / كاتب سوري 13/2/2006 الدين . الفلسفة . العلم
( الجزء الثانى )
".. فلنبدأ بتحطيم المعابد القديمة في أنفسنا .."
" الحلاج "
عندما نتحرر من جميع الأحكام المسبقة ، تاريخ نشوء الكون ، تاريخ نشوء الحياة على الأرض ، تاريخ نشوء الأرض ذاتها ونشوء غلافها الجوي والشروط الكونية لكل ذلك . نجد أنفسنا أمام أفق واسع ومختلف تمامآ ويقف على النقيض مما كنا " نظنه " حتى الآن .
لم تتمكن ( الطبيعة ) من إيجاد مجرد الحياة فحسب . بل تمكنت من إيجاد " الأدمغة " ، وأخيرآ " الوعي البشري" . الأمر الذي لم يكن ممكنآ ( إلا لأنه كان يوجد دائمآ في هذا الكون ومنذ اللحظة الأولى لنشوئه : عقل وخيال وسعي نحو الهدف ) .
العقل – الدماغ – الذكاء :
------------------------
في محاولة لتلخيص كتاب ( تاريخ نشوء الكون ) لعالم وأستاذ علم الأعصاب والمعالجة النفسية ، ودارس نتائج العلوم الطبيعية الحديثة / هويمار فون ديتفورت / الألماني . ومع صعوبة التلخيص لبعض من الكتاب ، إذ من الصعوبة تلخيص الكتاب العلمي والفلسفي ، فإنما أحاول فتح نافذه للإضطلاع والتوسع والتفكير .
إن النقطة الحاسمة في التاريخ ، هي الحقيقة المكتشفة من العلوم الحديثة ، والتي تؤكد أن آثار العقل والذكاء كانت موجودة في العالم وفي الطبيعة منذ مدة طويلة قبل نشوء الإنسان وقبل نشوء الوعي . إننا لا نقول هذا بالمعنى " الأيديو لوجي " – وإن كانت سترتب عليه نتائج عميقة التأثير على الأيديولوجيات والنظرات الشمولية للحياة - . كما أننا لانقوله بالمعنى اللاهوتي الذي يفترض وجود روح علوية فوق طبيعية تقف وراء هذا النظام الذي نصادفه في كل مكان في الطبيعة الحية . وقد يكون هذا الطرح مشروعآ وقابلآ للنقاش ، لكنه لايدخل في إطار مانعنيه الآن .
ولقد توصل علماء السلوك اليوم إلى نتائج ذات أهمية غير عادية تقول : أنه يوجد في الطبيعة الحية ذكاء لايرتبط بأية عضوية ملموسة ، أو بكلمات أخرى : ان " العقل " ممكن دون وجود " الدماغ " الذي يؤويه .
ونحصل من كل هذا على إستنتاج مثير وبالغ الأهمية ، وهو أن دخول ( العقل والوعي ) إلى هذا العالم لأول مرة ، لم يكن معنا نحن البشر . ويبدو أن هذه المقولة هي أهم معرفة نستطيع إستخلاصها من نتائج بحوث العلوم الطبيعية الحديثة . السعي نحو الهدف ، والتكيف ، والتعلم ، والتجريب ، والإبداع ، وكذلك الذاكرة والتخيل كلها كانت موجودة منذ زمن طويل قبل وجود الأدمغة . وعلينا أن نعيد النظر ونتعلم من جديد أن الذكاء لم يوجد لأن الطبيعة تمكنت بعد سلسلة من التطور الوصول إلى الدماغ ، الذي جعل ظاهرة " الذكاء " ممكنة .
إن من أعظم الأفكار العظيمة والذكية ، هي : ( طريقة التمويه الأكثر ذكاءآ ودهاءآ ) . فعندما لاتكون لديك إمكانية الإختباء أمام مطاردك ، فإن أفضل مهرب هو : التمويه . بإكثار الأهداف الخلبية المماثلة للأصل . وتتبع هذه الطريقة منذ القدم في الحروب ، حيث يحاول كل طرف تحويل نيران العدو عن الأهداف الحقيقية ، إلى أهداف خلبية .
وأينما شاهدنا أو ضُللّنا بمثل هذه الخدع ، نفترض فورآ ( وجود عقل ذكي مدبر يرتبها ) . أي أن هذه الخطط الهادفة والمدروسة بعناية ، لايمكن إلا أن تكون نتيجة " تأملات واعية حادة الذكاء " .
وحتى لانكون ممارسين لأحكام مسبقة ، نقول أنه وجدت في الطبيعة آثار لتأثيرات " العقل " قبل وجود " الأدمغة" التي تجعل الوعي ممكنآ بزمن طويل . وأمامنا مثال من أمثلة كثيرة للبرهنة على ذلك :
تعيش في آسام في وسط الهند ، فراشة تحمي نفسها ضد أعدائها خلال فترة التشرنق بنفس الخدعة المطبقة في " التمويه " . فتقوم هذه الفراشة شأنها شأن الفراشات الأخرى ، بنسج شرنقة حول نفسها عندما يأتي وقت التشرنق ، علاوة على أنها تختبئ في أحد أوراق الشجر . ولما كانت الورقة الخضراء المليئة بالسوائل منبسطة ومرنة إلى درجة لايمكن للفراشة معها أن تلفها لتصبح كمغارة تختبئ فيها . فتحل الفراشة هذه " المعضلة " بأن تقوم أولآ بتثبيت الورقة بعناية على الجذع بواسطة خيوط تخرجها من فمها ، وتلفها حول ساق الورقة ، ثم تقوم بقص ذنب الورقة من ناحية الجذع لفصلها عنه . وكنيجة لذلك تبدأ الورقة بالذبول ومن المعروف أن الورقة الذابلة تلتف حول نفسها . بعد ساعات قليلة تحصل الفراشة على أنبوب مثالي لأن تدخل فيه وتختبئ . لكن هذا .. ليس سوى بداية .
فعندما تصبح في مرحلة التشرنق ، تكون غير قادرة بتاتآ على أي دفاع ، وهي بهذا تواجه مشكلة جديدة . فمع أن الورقة اليابسة وفرت الملفوفة وفرت لها مأوى ضد الرؤية ، إلا أنها أصبحت " مميزة " بين جميع الأوراق الخضراء الأخرى وملفته للنظر ، وستفكر العصافير ببحثها عن قوتها وبنتيجة تعلمها إن هذه الورقة اليابسة ستزودها بالطعام – الفراشة – من داخلها ، ضمن المحيط الأخضر بكامله . فستزداد المخاطر على الفراشة .
إلا أن الفراشة حلت هذه المشكلة بطريقة " ذكية وفعالة " . فتقوم الفراشة بكل بساطة بفصم خمس أو ست ورقات أخرى وتثبيتها على الأغصان كما الأولى التي ستختبئ فيها ، معلقة بجانب بعضها البعض . أي هناك ورقة واحدة فقط منها تحتوي على الفريسة المحتملة . أما الأوراق الأخرى فهي فارغة وموجودة بغرض التمويه .
وعندما يحاول العصفور بالبحث ليصادف غذاءه – الفراشة – تكون المحاولة الأولى : 1/6 . هذه الدرجة من التأمين ضد المخاطر تمنح الفراشة السكنة والفاقدة للوعي ميزة حاسمة في معركة البقاء . ويصطدم العصفور بورقة فارغة ، فيتناقص إهتمامه في البحث مستقبلآ عن أوراق يابسة .
وغن صادف العصفور وعثر على هدفه بالصدفة منذ المحاولة الأولى فسيتشجع على متابعة البحث في الأوراق الصفراء الأخرى ، لكن سيصاب بخيبات أمل كبيرة . وسيتكون لديه تضاءل في الرغبة بالبحث في الأوراق اليابسة الصفراء مستقبلآ . ومن هنا يؤدي ذلك أيضآ إلى حماية الفراشات الأخرى .
هذه الطريقة ، تبدو حتى للإنسان " تكتيك مخطط " بارع للدفاع عن النفس ، مشيرآ إلى درجة عالية مـــــــــن
( الذكاء ) . . كيف يكون ممكنآ أن تقوم حشرة بكل ذلك لحماية نفسها ، على الرغم من أن بناء جملتها العصبية وسلوكها الآخر ، يقودان إلى الإستنتاج بأنها لاتملك ذكاءآ يؤهلها إلى التوقع المستقبلي والإستنتاج المنطقي ؟؟ .
إننا نستطيع أن نتفهم إعتقاد الباحثين القدماء تجاه مثل هذه المشاهدات ، بأنها ( الأعجوبة ) . وأن الإله هو الذي وهب مخلوقاته المعرفة اللازمة لحماية نفسها ورعاية مصير أبنائها . إلا أنهم بهذا القول ، يستسلمون ويتخلون عن مهمتهم " كباحثين في علوم الطبيعة " . كما أن كلمة ( الغريزة ) الحديثة ، لاتعطي تعليلآ كما يظن الكثير من الناس . لأنها – الكلمة – ليست إلا " إصطلاحآ " فنيآ إتفق عليه العلماء للتعبير عن أشكال سلوكية معينة موروثة غير مفهومة .
جزءآ من هذه المقولة صحيح . لأنه يقول : أن هذا الإنجاز المدهش الذي تقوم به الفراشة لاينبع من ذاتها . وكأننا نصل بشكل إستنتاج رائع إلى معنى العقل الكلي .
البداية / الإنفجار العظيم :
----------------------------
في دراسة للدكتور / علي حسين عبد الله / أستاذ وباحث جامعي في الكويت . يقدم عرض علمي حول هذا الموضوع بعنوان : ( صدى الإنفجار العظيم : أقدم حفرية في الكون ) يقول :
في عام 1989 أرسلت وكالة ناسا قمرآ إلى الفضاء الخارجي بإسم " كوبي " ، لدراسة موجات خاصة لها علاقة بخلق الكون . فما هي هذه الموجات ؟ . هي إشعاع يملأ الكون كله في الليل والنهار وفي جميع الإتجاهات . وهذا الإشعاع يفسر على أنه الإشعاع الباقي من الإنفجار العظيم عند بدء خلق الكون . لذلك يقال عنه أنه أقدم حفرية في الكون . ولا يمكن رؤيتها بالعين المجردة لأنها تقع ضمن موجات الميكروويف . وهي : أول وأبعد وأقدم أشعة يمكن لأي تلسكوب إلتقاطها ، ومن المستحيل أن نرى قبلها أي شيئ ، والسبب أن الكون ما قبل هذه الأشعة كان قاتمآ . إن الإنسان إستطاع في القرن العشرين من إلتقاط " صورة الكون عندما كان الكون وليدآ ) . وتمددت موجات الأشعة مع تمدد الكون ، وبالتالي زاد طول موجتها عما كانت عليه ، ولذلك فهي تقع في نطاق الميكروويف .
وقد ترسخ موضوع " الخلفية الإشعاعية " في أواخر الثمانينات من القرن العشرين ، وترسخت نظرية الإنفجار العظيم لدى العلماء . ومن ضمن دلائلها وجود إختلاف في درجات حرارة الكون عند بدايات خلقه ، أي عند وجود هذه الأشعة . وإذا تمكن العلماء من إثبات وجود إختلاف في حرارة الكون عند تلك اللحظات ، لأمكن إثبات خطوة مهمة في نظرية الإنفجار العظيم ، ولصار هذا فتحآ أو ثورة في معرفة الإنسان للكون .
وإستطاع القمر الصناعي " كوبي " مع أجهزته الحساسة لقياس حرارة الكون بدقة تصل إلى 1 / 100000 . وعندما حللالعلماء النتائج ، كشف عن فرق في درجات الحرارة في الكون . وأرسلت " كوبي " صورآ للكون منذ بداياته الأولى تقريبآ . أي عندما كان ( الكون جنينآ صغيرآ ) بعمر 300 ألف سنة . وهو رقم لايذكر بالنسبة لعمر الكون الذي يقدر 7 , 13 مليار سنة .
إن تمدد الكون هو الذي أدى إلى إختلاف في توزيع المادة في الكون ، وهذا يعني أن البذور الأولية للمادة في الكون ، سببها إختلاف في حرارة الكون .
في عام 2001 أرسلت ناسا قمرآ صناعيآ بمجسات حساسة جدآ بإسم " دبليو ماب " وكانت أهم النتائج المحصول عليها :
1- الحصول على صورة للكون بقياس الإختلاف في درجات الحرارة في السماء سميت ( الخريطة الخضراء ) . وتمثل هذه الخريطة ، صورة الكون في مراحله الأولية عند ولادته : " عندما كان طفلآ " .
2- حدد العلماء صدور الخلفية الإشعاعية بعد الإنفجار العظيم ب 380 ألف سنة .
3- تم تحديد عمر الكون ب 7 ، 13 مليار سنة ، بنسبة خطأ 1 % .
4- بعد مرور 200 مليون سنة على الإنفجار العظيم ، ولدت أول النجوم .
5- الكون يحتوي على : 4% من المادة التي نعرفها – 23 % من المادة المظلمة لانعرف عنها الكثير –
73 % طاقة مظلمة لايعرف عنها الكثير .
6- إثبات وجود التمدد المفاجئ في بدء خلق الكون بما يسمى ( نظرية التضخم في الكون ) .
7- الكون في حالة تمدد مستمر إلى الأبد !! . [[ هناك دراسات رياضية وعلمية تنفي ذلك سنأتي لها لاحقآ ]].
وبرأيي : وهذا تساؤل طرحته في الجزء الأول : عن المادة والطاقة ... أيهما مولد للآخر ، أو أنهما تولدا معآ ؟
ان من أهم ما وصل إليه العلماء بنتائج حسية ، هو التأكيد التام على "أفكا ر آينشتاين " بأن : [ المادة في الواقع ليست سوى حالة معينة للطاقة ] .
----------------------------------
فائز البرازي / كاتب سوري
19/2/2006
الدين . الفلسفة . العلم
( الجزء الثالث )
الكون : لامتناهي أبدي مستقر . أم : متناهي محدود وغير مستقر :
في عام 1965 كان العالمان / بينزياس ، ويلسون / يقومان بتجارب على تطوير هوائيات لمتابعة ما يســمى
" أقمار الصدى " . وبالصدفة إلتقطا تشويشآ لم يتمكنا من حصر مصدره رغم الجهود المبذولة ، رغم أن حصره كان يجب أن يكون سهلآ نسبيآ بالنسبة لهما . وكانا يعتقدان تمامآ أن تشويشآ قادم من الخارج يعتبر بحكم المستحيل . سمع بالمشكلة الفيزيائي / روبرت ديك / الذي يعمل في جامعة برينستون الشهيرة ويدرس منذ سنين المسائل الفضائية . وعندما إلتحق بهما مع فريقه المتخصص ، أزال ما سمعه ورآه في الموقع هناك ، آخر الشكوك . ( إن التشويش الغامض الذي ضلل زميليه ، يأتي فعلآ من الخارج ) . إنه ظاهرة كونية كان قد " تنبأ " بها قبل عدة سنوات إنطلاقآ من " تأملات نظرية فلسفية وعلمية " .
إن ما إستقبلته الأجهزة على الموجة ( 3 , 7 ) سم ، هذا التشويش الغريب الذي كان يأتي من جميع الجهات بنفس الوقت وبنفس القوة كيفما أدارا الهوائيات ، لم يكن " تشويشآ " . إنه ليس سوى ( الإنعكاس الإلكتروني للبرق الهائل الناتج عن الإنفجار العظيم ) . أي الذي نشأ معه قبل 13 مليار سنة ، عالم الكون بكامله . كان هذا التشويش ، أول إشارة ملموسة إلى أن " الكون متناهي في المكان والزمان " .
من منا لم يتساءل عندما ينظر ليلآ إلى قبة السماء ، عما إذا كان ما فوقنا " يمتد حتى اللانهاية " ؟ - واللانهائية إصطلاح ومفهوم نحن أوجدناه للتعبير عن أمر غير مفهوم ومحدد - . وبقدر ما كان تصور ذلك يبدو صعبآ ، بقدر ما كان النقيض بتصور أن ما فوقنا " ينتهي في مكان ما " مهما بعدت المسافة . فكيف يمكن أن تكون هناك حدود كونية ، طالما أننا نستطيع أن نسأل فورآ : ماذا بعد هذه الحدود ؟ .
هذا التساؤل تطرق له علماء منذ العصور الحضارية القديمة . مثل : جيوردانو برونو ، عمانويل كانط ، فيلهلم اولبرس . ودفع / بورنو / ثمن إستنتاجه الذي إدعى فيه : ( أن لا نهائية للكون ، وثابت أبدي ) بحيث أن هذه الصيغة " تعبر عن الإلهه ذاته " أي أن الكون يجب أن يكون لامتناهيآ لأنه هو افله بذاته . وبعد محاكمة كنسية دامت سبع سنوات ، أعدم العالم الفيلسوف بالحرق علنآ في روما عام 1600 م .
اليوم .. يبرهن الفلكيون بمساعدة تلسكوبات الراديو والمراصد التي تستخدم الأقمار الصناعية ، أن "اللانهاية" في الزمان والمكان ، كانت ولم تزل من ( إمتيازات الإله وحده ) – سواء آمن الناس أم لم يؤمنوا - .
أما في هذا العالم ، فإن " اللانهائية " غير موجودة بأي شكل من الأشكال ، بل إنها غير ممكنة ، وهذا طبعآ ينطبق على الكون ككل . فكان العالمان / آرنو بينزياس ، وروبرت ويلسون / أول إنسانين يسمعان صدى نشوء العالم . السؤال بالنسبة لنا : كيف نفهم هذا الأمر بقدر المستطاع من البساطة ؟؟ .
التمدد والإنكماش :
-------------------------
إننا نميل دائمآ إلى أن نضع أنفسنا في المركز . لكن نتائج دراسات الواقع وبحوث العلوم الطبيعية تحررنا شيئآ فشيئآ من هذا الوهم . وحتى اليوم لم تزل الأرض بالنسبة لمعظم البشر ، هي مركز العالم الروحي . أي انها كما يعتقدون هي المكان الوحيد في الكون الهائل الكبر ، الذي تطورت فيها الحياة والوعي والذكاء . إن هذه القناعة هي في الحقيقة أيضآ ليست سوى رداء جديد نواجه فيه جنون " المركز القديم " – نظرية المركز : قديمة منذ صراع الكنيسة في عصر النهضة : تقول أن روحآ أو قوة خفية حلت في المراكز مؤثرة في ثقلها وفي إنجذابها –
أما في الواقع ، فإننا كما يبدو : لانملك الوعي والذكاء إلا لأن مقدمات وإمكانيات نشوء (الوعي والذكاء كانت موجودة في العالم منذ البدء ) .
كان الدكتور / فيلهلم أولبرس / في بداية القرن الماضي يتعجب من ظاهرة طبيعية وبسيطة نعيشها جميعآ كل يوم:
( لماذا يعم الظلام ليلآ ) ؟ . فلقد إصطدم " أولبرس " خلال تأملاته الفلكية بتناقض غريب : إذا كان الكون لامتناهي الكبر ، وكان ممتلئآ بالنجوم المتناثرة في كل مكان بصورة منتظمة ، فإن السماء بكاملها " يجب أن تبقى حتى بعد غياب الشمس ، مضاءة بنفس الدرجة كما لو كانت الشمس ساطعة " .
وكانت مقولته تقول : ( عدد لا متناه من النجوم ، ينتج كمية لا متناهية من الإضاءة ) . صحيح أن إضاءة نجم ما ، تتناقص طردآ وبسرعة كلما إبتعد ، وبالتحديد طردآ مع مربع بعده ، فهذا أيضآ يعني أن شمسنا لو إبتعدت عنا إلى ضعف المسافة التي هي عليها الآن ، لتراجعت قدرتها على الإضاءة والتسخين إلى الربع . حيث يبدو أن كمية الإضاءة اللامتناهية التي ينتجها عدد لا متناه من النجوم ، لا تستطيع بسبب " بعد " النجوم المتزايد أن تصل إلينا. لكن .. وكما يقول " اولبرس " : هذا الإستنتاج خاطئ ومخادع .
لأن عدد النجوم " يتزايد مع تزايد المسافة " ، بصورة " أسرع من تناقص الإضاءة " . ومن خلال الدراسات الرياضية توصل إلى إثبات ذلك . انه ومع تكبير المسافة ، يتزايد عدد النجوم بصورة أسرع بكثير من تناقص إضاءتها . ويستنتج " أولبرس " ، أنه يجب أن يأتي وقت ما ، مهما بعدت المسافة ، بحيث نصل إلى ( الحد ) الذي يعوض فيه تزايد عدد النجوم السريع ، تناقص إضاءتها الأقل سرعة ، ومن ثم يتجاوزه . وبما أنه في " الكون اللامتناهي الكبر " سيتم تجاوز هذه ( المسافة الحدية ) في كل الأحوال ، فإن السماء يجب أن تبقى مضاءة ليلآ كما هي مضاءة نهارآ .
وبناءآ على ذلك : إستخلص أولبرس : ( ان الظلام يجب أن لايحل أبدآ ، حتى في الليل ) . ولم يكن هناك من يستطيع نقضه . لأن حساباته وإستنتاجاته كانت غير قابلة للنقض . لكن .. رغم هذا " التماسك المنطقي في البرهان " ، لم يكن أحآ أيضآ يستطيع أن ينفي أن الظلام يحل ليلة بعد ليلة على الأرض . وهذا الأمر أوجد " تناقضآ من النوع الكلاسيكي " .
اليوم .. أصبحنا نعرف أين يكمن الخطأ ..
( ان الكون ليس لا متناهيآ ، لا في الكبر ، ولا في القدم ، ولا في المكان ، ولا في الزمان ) .
بهذا تسقط النقطة الحاسمة في " تناقض أولبرس " . النقطة هي في " المسافة الحدية " الحرجة .
هذه المسافة الحدية يمكن حسابها ، وهي حوالي : ( 10 ) قوة 20 . أي : 100 تريليون سنة ضوئية . وإستنادآ إلى هذا الرقم ، يتضح لماذا يحل الظلام ليلآ .
فإن الكون هو " أصغر " بكثير مما تصوره أولبرس ومعاصروه . إنه ( ليس لا متناهيآ ) وحسب ، بل هو صغير جدآ لدرجة أن تزايد عدد النجوم المطرد ، لا يبلغ النقطة التي يصبح معها حسب حسابات أولبرس ، فعالآ . إن أكبر
( مسافة كونية واقعية ) بالنسبة لنا تبلغ " 7 , 13 " مليار سنة ضوئية .. وهذا الرقم لا يساوي سوى 10 إلى
مليار ، من مسافة أولبرس الحدية . وفي كل الأحوال : يبقى مؤكدآ أننا نحصل كلما حل الظلام ، على برهان ملموس ، بأن الكون ليس لا متناهيآ ، لا في المكان ، ولا في الزمان .
ونعود إلى " الدوامة الذهنية " :
إذا كان الكون لا متناهيآ في الكبر ، فكيف يمكن أن يكون محدودآ ؟ . كيف يمكن أن : ( نتصور مثل هذه المحدودية للعالم ) ؟ . كيف يمكن أن نتصور ( الحدود النهائية التي تحتوي كل مايوجد بدون إستثناء ) بحيث لا يوجد"خارج" بعد ؟ ... من هنا فالمشكلة هي : [ عدم قدرتنا على التصور ] ..
إن " إنسان نياندريال " الإنسان الأول ، لم يكن يدرك أو يتصور أي شيئ عن مجالات العالم المحيط به ، ولا عن المجالات الكثيرة الأخرى التي أصبحنا ندركها اليوم . ليس لأنها لم تكن قد صادفته ، بل نستطيع أن ندعي بتأكيد كاف أن دماغه لم يكن قد تطور بما يكفي ليتمكن من إدراك إجزاء الواقع ، التي تختبئ خلف واجهة ما تراه العين ، في [ عدم القدرة على التصور ] . والحقيقة هنا تكمن أن وضعنا لم يختلف كثيرآ " من ناحية المبدأ " عن وضع إنسان نياندريال .
إن الإكتشاف القائل : بأن الكون ككل يختلف عما " تعودنا عليه " ، وعما " يتناسب مع قدراتنا على التأمل والتصور " ، هو إنجاز فريد قام به / البرت آينشتاين / ، وكانت خلاصة تأملاته هي : ( النظرية النسبية الأسطورية ) . إنها لم " تعد نظرية " على الأقل منذ ذاك اليوم من شهر آب 1945 عندما تدمرت هيروشيما . لأنه بدون إكتشاف آينشتاين حول ( تطابق المادة والطاقة ) لما كان صنع القنبلة الذرية ممكنآ .
هنا نصل إلى قضية " التطابق الزمني " ، و " حدود الكون " .
فقد كان إرتكاز آينشتاين على دراسة " السرعات " . وما وصل إليه ، أن السرعة اللانهائية لايجوز أن تكون موجودة في الواقع . لأنه إذا كانت هناك سرعات لانهائية ، فسنتمكن من إجتياز الكون ( لحظيآ ) ، وهذا هراء .
وكان آينشتاين الإنسان الأول الذي قال : إذا كانت السرعة اللانهائية غير ممكنة ، فلا بد من وجود ( سرعة قصوى ) ، أي ( سرعة حدية عظمى ) ، لا يستطيع تجاوزها أي شيئ .. لا المادة ولا الإشعاع ولا أي شيئ آخر . وهذا أحد مرتكزات أن " الكون متناه " . ان الجواب أتى مع آينشتاين ، على السؤال عما يجعل العالم متماسكآ داخليآ ، كان يختلف عما كان أسلافنا يتمنونه منذ آلاف السنين . إنه ببساطة ( غير ممكن ) .
ان لا أحد يستطيع أن يقول لنا ، لماذا تبلغ سرعة الضوء في الفراغ ( 5 , 299792 ) كم / الثانية تمامآ . ولماذا هذا الرقم بالذات يحدد أعلى سرعة ممكنة في العالم ؟ . علينا ( أن نقبل هذا الأمر كما هو ) .. إنه مجرد إكتشاف ثابت لم نصنعه . وهذا ينطبق بنفس الشيئ على النتائج المترتبة " إلزاميآ " على هذا الإكتشاف .
إن أهم نتائج : السرعة القصوى للضوء ، وفي حال عدم وجود أية إمكانية في الكون لإجراء الإتصالات وللقيام بمشاهدات معينة أسرع من الضوء ، يحيل مفهوم ( التطابق الزمني ) إلى شيئ عديم المعنى . أي : ان علماء الفلك لايشاهدون ولا يراقبون في قبة السماء سوى " أشباح " . لأن الأجسام السماوية التي يشاهدونها بمناظيرهم ويصورونها بأجهزتهم ، ( لم تعد موجودة هناك ) . إننا لن نتمكن أبدآ ولا بأية طريقة من الطرق ولا في أي وقت من الأوقات ، أن نرى هذا النجم أو غيره من النجوم ، كما هو فعلآ في " اللحظة " التي نراقبه فيها . هذا عن ( عدم صحة التطابق الزمني ) . فماذا عن ( حدود الكون ) ؟ .
من إستنتاجات النظرية النسبية لآينشتاين : أن " الزمان " متعلق ( بالحالة المكانية ) . فهناك علاقة " تناسب " بين الزمان والمكان . هناك علاقة متبادلة بين المكان والزمان . وأن الزمن في السرعات العالية القريبة من سرعة الضوء ، يمر ببطء . وبأن " المادة " في الواقع ليست سوى ( حالة معينة للطاقة ) . وأن " المكان " شأنه شأن " الزمان " ليس ( مطلقآ ) . وكما أن الزمان يتعلق بالمكان ، فإن خصائصه تتحدد " وتتغير " بواسطة ما يحتويه من مادة . وبما أن الكون ممتلئ بالمادة الموزعة فيه توزيعآ منتظمآ ، فإنه يجب أن يكون تبعآ لكميتها وتوزعها ( محدبآ / مكورآ ) . وهذا برهن عليه بواسطة معادلات رياضية معقدة . وبالتالي لم يعد يوجد اليوم في العالم ، فيزيائي ، أو رياضي ، يشك في ذلك .
فعندما حاول / آينشتاين / أن يعرف شيئآ عن ( الحالة غير القابلة للتصور ) ، والتي يمكن أن يكون فيها الكون المتناهي محدودآ ، حصل على الجواب : بأن ( الفضاء الكوني محدب ) . وهو لذلك لا يحتاج إلى حدود . فالكون الثلاثي الأبعاد ، وفي بعده التالي الأعلى ( الرابع ) ، ينغلق على ذاته دون أن تكون له حدود . إ ننا نتحرك هنا في مسألة حدود الكون ، على الأطراف القصوى لقدرة أدمغتنا الناشئة في " شروط أرضية " على الإستيعاب . عندما نحاول " تصور الكون المحدب " ، فإننا نصطدم مرة تلو المرة ، لا بحدود الكون ، إنما ( بحدود أدمغتنا ذاتها ) .
بعد الحرب العالمية الأولى ، أتى مدير / مرصد قمة مونت ويلسون / في كاليفورنيا / إيدفن هوبل / وتمكن من تفكيك ضباب " اندروميدا " إلى نجوم منفردة ، فقدم أول برهان على أن ما يسمى ( بالضباب الحلزوني ) الذي لايرى بالعين المجردة ، والموجود بكميات لايمكن حصرها ، ما هو إلا " مجرات " موجودة خارج ( مجرتنا درب التبان ) . ومن ذلك توصل / هوبل / ثانية إلى أن ( الكون يتمدد ) .
إن نظرية الإنفجار العظيم " بيغ بانغ " وحسب ما أثبت هوبل : أن الكون يتمدد . وأن المجرات تبتعد عن بعضها البعض بسبب الإنفجار الحاصل قبل 7 , 13 مليار سنة . وكما الجسم المقذوف ، فإن المجرات المتباعدة ستصل سرعتها في زمن آت إلى " سرعة الصفر " . ثم تبدأ رحلة العودة إلى التجاذب بين المجرات . إن الحركة الإنفجارية للكون لن تستمر حتى الأزل . وبالتالي توصل العلماء إلى أنه : ( يجب أن يكون للكون بداية ) .
وتبقى التساؤلات :
· ما هي أسباب هذا الإنفجار ؟
· ماذا كان هناك قبل الإنفجار ؟
ويعود ليعتقد بعض العلماء أن التوسع الحالي للكون آخذ في ( الإنكباح ) وهذا ضمن كثير من المؤشرات التي تؤيد إمكانية تباطؤ التمدد كنيجة للتجاذب المتبادل بين جميع الكتل التي يحتويها الكون .
عندما ( ينكبح التمدد ) . سيأتي يوم خلال مليلرات السنين ، لتصل فيه حركة الهروب ، إلى التوقف . ثم .. تنقلب بعدئذ في الإتجاه المعاكس . = إنعكاس مكان شروق الشمس ليصبح من الغرب = .
وفي تلك الحالة ، سوف يشاهد الفلكيون عند تحليلهم للحقل الطيفي للمجرات البعيدة جدآ ، " إنحرافآ أزرق " بإتجاه الموجات الأقصر ، وليس " إنحرافآ أحمر " كما اليوم .
خلال عملية " الإنكماش " ، سوف تتزايد بإستمرار ، سرعة الكتل المندفعة تجاه بعضها البعض . وأخيرآ سترتطم كل هذه المجرات التي لاحصر لعددها ، والتي تتألف كل واحدة منها على ملايين وملايين الكائنات الحية ، بأشكال حياتية لاحصر لعددها ، سترتطم جميعها مع بعضها البعض ، وتنصهر في ( أتون ) إصطدام هائل ...
عندها : سيتحطم الكون بكامله ( بإنفجار هائل لا مثيل له ) . = هل الكون بدأ من تحطم كون سابق ، وهكذا دواليك و دواليك ؟؟ = .
لكن هذا الإنفجار سيكون ثانية بعد عدة مليارات من السنين ( بداية جديدة ) ، عندما تتجمع المادة الكونية المتناثرة بسبب قوة الإنفجار ، وتشكل نجومآ جديدة في سماء جديدة ، تنشأ عليها الحياة ثانية ، وتقام الحضارات التي يكتشف فلكيوها الكون من جديد . ويفسرونه بطريقة مختلفة تمامآ : ليس كإنهيار لعالم سبقه ، وإنما ( كبداية لكونهم ذاتهم ) .
ان التاريخ ليس قصة تتابع الممالك والمعارك والحضارات فحسب . إن التاريخ الفعلي يتجاوز ذلك بكثير . إنه يبدأ من " البيغ بانغ " ، مع نشوء الهيدروجين والأجرام السماوية الأولى ، ويتمدد من هناك ، بدون أية فواصل وبتسلسل صحيح عبر تشكل الكواكب مع أغلفتها الجوية . حتى نشوء الحياة والأدمغة ، وأخيرآ حتى ظهور الوعي والذكاء ونشوء التاريخ بمعناه التقليدي ، ونشوء العلم .
إن على ( المؤرخين ) أن يوسعوا مجال بحوثهم ، ليشمل مجرى التاريخ بهذا المفهوم العلمي / الطبيعي ، ومحاولين إشتقاق وإكتشاف قوانين التطور التاريخية الأساسية من التاريخ الفعلي للعلم .
[ للبحث بقية ] .
=======================
فائز البرازي : كاتب سوري
2/3/2006
الدين . الفلسفة . العلم
( الجزء الرابع والأخير )
العقل ، الدماغ ، الذكاء ، الوعي
بداية هنا نتساءل : إن كانت الحياة قد أتت ( صدفة ) . وهذا يستدعي السؤال : كم هو مقدار الإحتمال لأن يصطف
" بالصدفة " حمضآ آمينيآ مختلفآ في سلسلة مؤلفة من 104 حلقات تمامآ بالتسلسل الموجود لدى " سيتو كروم سي " ؟ .
الجواب : هو 1 إلى (20 ) قوة 104 . فإذا ترجمنا هذا الإحتمال إلى اللغة اليومية ، نقول أنه غير ممكن . إن إحتمال نشوء " سيتو كروم سي " بالصدفة المحضة يبلغ كما قلنا حسابيآ فقط 1 من ( 20 ) مرفوعة للقوة 104. وهذا يعني أنه لو نشأ في كل " ثانية " مرت منذ بدء الكون حتى الآن ، أنزيم جديد ، لما بلغ عدد جميع الأنزيمات الناتجة ، سوى ( 10 ) قوة 17 أنزيم . وإذا أخذنا هذه الحسابات كما هي ، فيبدو لنا أن لا مفر من الإستنتاج :
1- ان الحياة إما أن تكون ( واقعة غير محتملة الحدوث بدرجة قصوى ) ، أي حالة إستثنائية فريدة وجدت في كامل الكون مرة واحدة وحيدة هنا على الأرض ، وهي بالنسبة لهذا الكون ، ظاهرة لا نموذجية على الإطلاق من كل جوانبها .
2- أو أنه يوجد حقآ عوامل ما ( ميتافيزيقية ) إستخرجت الحياة بعيدآ عن واقع مجال " الصدفة البحتة " .
وفي العموم ، هناك أمثلة حول موضوع ( الصدفة ) ، المتعلقة بنشوء الحياة . فكم من الزمن يجب أن نخض 1000 تريليون ذرة معدنية ، لكي تنتج و " بالصدفة " سيارة مرسيد س ؟ . وكم من الزمن يحتاج قطيع مؤلف من 100 قرد ، لكي ينتج " بالصدفة " وبالضرب العشوائي على 100 آلة كاتبة ، مقطعآ من مسرحية لشكسبير؟
إن شمولية الشيفرة الوراثية والتطابق في سلاسل الحموض الآمينية للأنزيمات ، الذي لايمكن إعتباره مصادفة ، وجميع الشواهد الأخرى من القرابات الجينية ، هي ليست بالضرورة برهانآ على أحادية هذا الطريق . بل إن الأرجح من ذلك ، هو الإفتراض أنه في التاريخ المبكر للأرض ، وجد عدد كبير من " البدايات المختلفة " لتشكل الحياة ، أي : من ( المشاريع الحياتية المختلفة ) . بقي من بينها جميعها مشروع وحيد هو : " الأنجع ، الأفضل".
ولو بدأ كل شيئ مرة أخرى من البداية ، لو تمكنت قوة ما من إعادة الزمن 4 مليار سنة إلى الوراء ، ووضعت الأرض الأولى مرة ثانية أمام نشر الحياة على سطحها ، سوف لن ينتج بالتأكيد نفس ما نراه حولنا اليوم .
إن ( تكرارآ مطابقآ تمامآ ) غير " محتمل " بتاتآ ، أي أن " الإحتمال " بأن تعني نفس الشيفرة الثلاثية الأسسية نفس الحموض الآمينية ، وأن ينتج عن ذلك صفوف الأنزيمات المعروفة بالنسبة لنا ، وكذلك نفس عمليات التمثل العضوي ، وأن تتواصل فوق ذلك عملية التطور ، منطلقة من العدد الهائل من الإمكانيات الموجودة ، إلى أن تشكل من الخلايا ضمن الشروط المتبدلة للوسط ، مرة أخرى بالتحديد والضبط نفس الأشكال الحياتية التي نعرفها ، من طيور وأسماك وحشرات وثدييات ، هذا ( الإحتمال بدون شك هو قريب من الصفر ) .
أقدم من جميع الأدمغة :
----------------------
في أواسط الستينات من القرن العشرين ، أجرى البروفيسور / جورج أونغار / من جامعة بايلور في هيوستن تكساس ، سلسلة من التجارب على فئران بيضاء – سأتعرض لنتائجها فقط منعآ للإستفاضة – ثم قام بقتلها وإنتزع أدمغتها ، وقام بسحب أكبر كمية ممكنة من حموض ( ر . ن . س ) الحمض النووي الريبي المحتوي على مغايرة واحدة زيادة عن ( د.ن.س) الحمض النووي الريبي المنقوص الأوكسجين . سحبه من أدمغة الفئران ، إستنادآ إلى أبحاث عالم الأحياء السويدي / هولغزهايدن / التي تشير إلى أن ظاهرة " الوراثة البيولوجية " ، تشبه " الوظيفة السيكولوجية / النفسية " للذاكرة . أي أن ( الوراثة ) هي من الناحية المبدئية ليست سوى ( ذاكرة تنوع ) .
· الفئران التي عانت وخافت وإرتعشت مرعوبة من دقات مطرقة على صفيحة معلقة فوق رؤوسها ، كانت قادرة على التعود بعد أسابيع عديدة ، وكان رعبها يتناقص يومآ بعد يوم ، حتى لم تعد تبدي أي إنزعاج أو إهتمام بما يحصل فوقها . أدمغة هذه الفئران " المتعودة " كسائل حقنت في فئران حديثة الولادة ، فكان تأقلمها من الضجيج مدهش .
· كرر التجربة : قام بتدريب الفئران على ( ما يخالف طبعها ) ، أي : ما يخالف غريزتها الموروثة ، وهي التجربة بأن تتجنب ( المكان المظلم ) وأن تعيش فقط في الأماكن المضاءة ، وذلك بإستخدام الصدمات الكهربائية . ثم قام بإستخلاص محلول غني بحمض ( ر . ن . س ) قدر الإمكان من أدمغة الجرذان " المدربة " خلافآ ( لطبيعتها وغريزتها ) . وحقن هذا المحلول بالجرذان "الغير مدربة " ، فإبتعدت عن الأماكن المظلمة ، إلى الأماكن المضاءة ، خلافآ لكل ما هو معروف في عالم الجرذان .
لقد تم التأكد ومن تجارب عديدة أخرى ، وبصورة لاتقبل الطعن ، وتم البرهنة لأول مرة على أنه : ( يمكن كيميائيآ نقل " ذكريات " نوعية محددة من فرد إلى آخر ) .
ماهي المادة التي تتألف منها هذه " الذكريات " ؟ . لم تنته بعد المناقشات الدائرة حول هذه المسألة .
ولقد تمكن / أونغار / حسب آخر المعلومات ، من تركيب ( مادة الذاكرة ) " سكوتوفوبين " في المختبر . لكن من سلسلة واحدة محددة من الحموض الآمينية ، واحدة من بين عدد لا محدود . وهي المتعلقة والمعبرة فقط من الكم اللامحدود ، المعبرة عن : " صفة الخوف من الظلام " . لكن ذروة العملية بكاملها ، أي : نتيجتها القصوى في المستقبل ، " الممكنة منطقيآ الآن " : ( إمكانية تركيب الذكريات إصطناعيآ ) .
ومع كل ما يوجد اليوم من شكوك حول بعض النتائج التفصيلية لهذه التجارب ، فإن هناك أمرآ مؤكدآ لا جدال فيه . وهو أن الأحماض النووية ، وبالدرجة الأولى حموض ( ر . ن . س ) ، " لها علاقة ما مع الذاكرة " . هذه الحقيقة الثابته تفي رغم تواضعها بغرض المحاججة .
فإذا نظرنا إلى الحقيقة القائلة أن : ( ر . ن . س ) لها علاقة ما مع الذاكرة ، أي : ( علاقة مع القدرة الفردية على التذكر ) ، وإذا نظرنا إليها من " المنظور التاريخي التطوري " ، عندئذ نتوصل إلى إستنتاج بالغ الأهمية . عندئذ نلاحظ أن قانون " الإقتصاد الطبيعي " الذي لعب دورآ لدى ( بناء الدماغ ) ، عندما بدأ التطور قبل حوالي مليار سنة بإنتاج " الأدمغة البدائية الأولى " ، وعندما تبين خلال التطور اللاحق ، أن من المفيد منح هذا العضو المركزي القدرة على إكتساب الخبرة بطريقة فردية ، عندئذ لم يبذل التطور جهودآ جديدة لتطوير هذه القدرة من جديد . لم يكن بحاجة إلى ذلك : كانت تتوفر أمامه إمكانية أسهل لتحقيق هذا الهدف . لم يكن يحتاج سوى العودة إلى مبدأ جاهز قديم ، إلى الإختراع الذي كان قد صممه قبل ملياري سنة . لقد كان آنذاك قد إستخدم ببساطة الطريقة التي كان بواسطتها منذ البدايات الأولى للحياة قد ( خزن المعلومات ) بنجاح كبير لكي يتمكن بعدها من نقلها إلى الأجيال اللاحقة " كمادة وراثية " . " ذاكرة النوع " وقدرة الفرد على " التذكر " ، ليستا متشابهتين فحسب ، بل تقومان من حيث المبدأ على نفس الآلية الجزيئية . – كما أثبت أونغار - .
فإذا كان ( سكوتوفوبين ) بروفيسور / أونغار / يحتوي فعلآ على خبرة الجرذان المدربة المتجسدة بالخوف من الظلمة ، فإن هذا سيكون برهانآ قاطعآ على أن : ( الذكريات يمكن أن توجد أيضآ خارج الأدمغة الفردية ) .
" الوراثة والذاكرة " هما شكلان مختلفان لنفس المبدأ البيولوجي . وهذا يعني أن " الأدمغة الأولى " لم تكن بحاجة إلى تطوير أو إنتاج ( الظاهرة النفسية / الذاكرة ) . كان المبدأ موجودآ وجاهزآ . لم يكن الدماغ بحاجة إلا لأن يأخذه كاملآ كقطعة جاهزة مسبقآ ، كقطعة بناء صغيرة إتحدت مع بعضها البعض ، مشكلة المرحلة التالية الأعلى . إن القدرة على " التذكر " لم تظهر على الأرض لأول مرة مع ظهور " المخ " ، لأن : ( الذاكرة هي أقدم من جميع الأدمغة ) . ومن هذا المنظور ، يصبح نشوء المخ نتيجة منطقية إجبارية ، لما سبقه من تطور . وبذلك يعتبر المخ على الأقل فيما يتعلق بالذاكرة ، هو " الحفيد الشرعي للهيدروجين " .
عندما نقتنع أن قدرتنا " النفسية على التذكر " ماهي إلا إستخدام لوظيفة بيولوجية كانت موجودة لوقت طويل قبل نشوء الأدمغة والوعي ، عندها نستطيع أن نعتقد أننا بذلك وصلنا إلى أقصى الحدود . عندئذ نكون قد تجاوزنا حكمنا المسبق المتمركز حول ذواتنا البشرية ، أي : نكون قد تجاوزنا غرورنا المبني على إعتقادنا بأننا الوحيدون من بين جميع أشكال الحياة الأخرى ، الذين ( نمتلك العقل ) ، فلا شك أن هذا الإعتقاد ما هو إلا وهم .
ففي عام 1970 قام العالم الأمريكي / نورمان آندرسون / بنشر دراسة تكميلية عن " نظرية التطور " ، التي تبدو ستهز فرضية تمتع عقولنا بحق حصري متميز . فكان / آندرسون / هو أول من صاغ الأفكار التي كانت مطروحة للمناقشة منذ عدة سنوات ، في " دراسة علمية متكاملة " ، تقول هذه الدراسة أن : ( النقل الفيروسي ) يجب أن يكون قد لعب دورآ حاسمآ في عملية التطور .
لقد عمل / آندرسون / على " إكتشاف " لعالم الأحياء الأمريكي / يوشوا ليدربيرغ / عام 1952 ، وحائز على جائزة نوبل عام 1959 لإكتشافه هذا الذي يقول : ان عمل الفيروسات يؤدي في كثير من الأحيان ، إلى نقل المادة الجينية " الحاملة للمورثات " من خلية إلى أخرى . أي : تقوم بدون قصد بنقل أجزاء – نتف – من حموض ( د . ن . س ) الموجودة في الخلية التي تهاجمها ، إلى الخلية التالية التي تهاجمها – كما يحدث مع النحل بنقله الغير مقصود لغبار الطلع من زهرة إلى أخرى - .
وقد أوضح / آندرسون / ما يمكن أن تعنيه هذه " الآلية " بالنسبة للتطور . إنها تعني ان الفيروسات تعمل كوسيط في تبادل ( الخبرات الجينية ) بصورة مستمرة بين : ( جميع الأنواع الموجودة على الأرض ) . وكانت هذه المقولة بالنسبة للباحثين ، وكأن غشاء قد أزيل عن عيونهم . فقد فهموا المعنى الحقيقي " لتماثل الشيفرة الوراثية " لدى جميع الأنواع . فكلما تمكنت خلية من الخلايا ، من الخروج سالمة من معركتها مع الفيروس ، - والخلايا تملك بحق طرق دفاعية فعالة – تكون قد حصلت على الفرصة لفحص إمكانية إستخدام الجينات ، التي نقلها هذا المهاجم بدون قصد ، لأغراضها الخاصة .
لذلك يتوجب علينا عندما نفكر " بالفيروسات " أن لانتذكر فقط موجة الرشح أو غيرها من الأمراض الفيروسية المزعجة ، بل علينا أن نعلم أن هذه الكائنات الصغيرة تعمل بلا توقف أو كلل خلال مسيرتها الطويلة عبر جميع الأنواع والفصائل منذ مليارات السنين ، على أن لايبقى أي تجديد جيني سريآ أو محجوبآ عن أي كائن يستطيع أن يستفيد منه ، أو يقوم بفعل شيئ بواسطته . وتبدو الأمور الآن ، وكأننا ما كنا موجودين اليوم على الإطلاق ، بعد خمسة مليارات سنة من نشوء الأرض ، لولا أن الفيروسات قد عملت طيلة هذا الزمن الطويل على تحقيق هــــــذا
( التبادل الجيني للخبرات ) .
وعند هذه النقطة من التطور ، التي بلغ عندها الإنفصال عن المحيط درجة القدرة على التجريد الذهني ، برزت ظاهرة جديدة . إنها ظاهرة ( الوعي ) . أي : " القدرة على إدراك الذات " . أي : الإمكانية الجديدة لأن نكوّن الأفكار حول ذاتنا ، لأن ندرك ذاتنا " الأنا " .
إننا لانعرف ما هو ( الوعي ) . فلا نملك المستوى الأعلى الذي نستطيع منه أن نراقب الظاهرة التي نريد إدراكها . غير أن ما عرفناه حتى الآن من علاقات قائمة بين مستويات التطور المختلفة الأدنى ، يمكن أن تشجعنا على الصياغة الحذرة ، بأن : [ الوعي هو محصلة لتجميع الذاكرة والقدرة على التعلم ، والقدرة على تبادل الخبرات والقدرة على التخيل والتجريد ، التي كانت جميعها قد نشأت في مراحل التطور السابقة بصورة منفصلة عن بعضها البعض ] . إن الأمر الذي لاشك فيه هو أن ( الوعي ) شيئ جديد تمامآ . جديد كما كان الماء شيئآ جديدآ تمامآ عند النظر إليه من مستوى الذرات المنعزلة . رغم ذلك فإن الظاهرتين هما بدون شك نتيجة " لإتحاد القديم" . كان هذا القديم بالنسبة للماء : عنصرين غازيي الشكل . أما بالنسبة للوعي : فإن تلك الوظائف المنفردة المذكورة أعلاه ، وغيرها من الوظائف العديدة الأخرى التي لم تظهر لنا بعد بهذا الوضوح الظاهري البارز ، التي إتحدت جميهعا لأول مرة في هذه المرحلة من التطور ضمن ( الأدمغة ) .
إن الإثارات الحسية المنطلقة من المحيط ، تتحول في إدراكات الأفراد الممتلكين لهذا الوعي إلى خصائص لأشياء موجودة " موضوعيآ " . حيث كان " الدماغ " يستطيع فقط : أن يستقبل الإشارات القادمة من المحيط والتي تمثل جذبآ أو دفعآ ، فائة أو خطرآ ، وأن يعطي ( الرد التكيفي ) المناسب ، أصبح " المخ " القادر على التجريد ، يسجل الخواص النوعية للأشياء الحقيقية في عالم ذي وجود موضوعي . وإن ما حققه لأول مرة المخ البشري من إدراك لأشياء تبقى ثابته ، ( بدلآ من إثارات المحيط التي كان معناها يتأرجح بين حدود واسعة تبعآ للحالة البيولوجية الذاتية ) هو مقدمة ضرورية لتسمية الأشياء . فكان هذا هو بداية " نشوء اللغة " . إن ثبات الأشياء هو الذي يتيح لنا إختراع وإستخدام التسميات التي ليست متماثلة مع الأشياء التي نطلق عليها هذه التسميات .
على الطريق إلى الوعي " الغالاكتيكي / المجرّي " :
-------------------------------------------------
إننا نستطيع أن نعتبر هذه المرحلة من التطور التي ننتسب إليها ، على أنها مرحلة " خاصة " من ناحية أننا نحن البشر نمثل بعد إستمرار التطور اللاواعي 13 مليار سنة من الزمن ، الكائنات الحية الأولى التي تملك القدرة كذات مستقلة على " التعرف على العالم " الذي نتج عن هذا التاريخ الطويل ، وعلى " إدراكه إدراكآ موضوعيآ" ولم توجد هذه الحالة إلا منذ عدد قليل من عشرات آلاف السنين .
وفي الحقيقة سوف يستمر التطور بعدنا وسوف يتجاوزنا غير مبال بما نكّونه آراء . سوف يحقق في مسيرته اللاحقة إمكانيات تخلّف بعيدآ وراءها ما نجسده ونستطيع إدراكه ، كما خلّفنا نحن عالم " إنسان نياندرتال " بعيدآ وراءنا . ولا توجد معطيات علمية تمكننا من التنبؤ بما سيفعله البشر في المستقبل ، أو بالكيفية التي سيتطور فيها المجتمع البشري وبالأفكار التي ستؤثر على قرارات الأجيال القادمة ، عدا أن كل هذا قد لايحصل على الأرض .
ولو إتجهنا ( إتجاهآ تخمينيآ ) للتحدث عن المستقبل ، من خلال بعض نقاط الإرتكاز التي نستطيع الإستناد عليها والتي تبرر هذه المحاولة ، نجد :
الخطوة الأولى :
--------------- التي نستطيع تخمينها والتنبؤ بها ، هي الإنتقال من " الحضارة الأرضية " إلـــــــــــى
( الحضارة الكوكبية ) ، وعلى المدى الطويل بعدها إلى ( الحضارة الغالاكتيكية / المجرّية ) . التي تشمل أكبر وأكبر من كامل المجرة . وهذا التنبؤ قائم على : ان إتحاد الحضارات الكوكبية المنفردة في روابط أكبر تتعامل مع بعضها البعض ، ما هو إلا متابعة منطقية ضرورية لكل ما حصل خلال 13 مليلر سنة الماضية . وكلما أطلنا التفكير ، يزداد لدينا الإقتناع بأن هذا " الإصرار إلى النفاذ عبر الفضاء " ، يعبر عن الميل الذي رأيناه بأشكال مختلفة في مراحل سابقة من مستويات التطور : الميل إلى التميز والإستقلال عما يحيط بنا ، الميل إلى الإنفصال عن المحيط المفروض . إن هذا الإصرار على السفر عبر الفضاء بدون تعليل " عقلاني مقنع " له ، يعبر أنه مجددآ وهذه المرة ( بقناع تكنولوجي ) عن نفس النزعة التي وجدناها على ( المستوى البيولوجي ) عند الخروج من الماء . لقد أدى خروج الحياة من الماء ، والذي كان يبدو في البداية ، لا منطقيآ وعديم الفائدة ، إلى وجود ما يسمى ( إختراع الدم الدافئ ) . الذي لم تكن تتوفر أية إمكانية للتنبؤ به ، وإلى خلق واقع جديد من " العلاقات الحضارية والتاريخية " . فمن يستطيع ضمن هذه الظروف أن يتجرأ على إعتبار مشروع البحوث الفضائية على أنه لا عقلاني وعديم الفائدة فقط لأنه : وهذا أمر لاجدال فيه ، لايستطيع في ( إطار أفقنا ) التنبؤي الحالي ، أن يقدم تعليلآ عقلانيآ مقنعآ ؟ . من يستطيع أن يحدد مسبقآ الإمكانيات الجديدة التي ستفتح أمام من يتمكن"الإنفصال" عن الأرض ؟ . رغم أنه يبدو منذ اليوم ، أن السفر عبر الفضاء " لايمكن أن يؤدي إلا إلى طريق مغلق " .
ومع ذلك فلا تناقض إذا قلنا أن الرحلات الفضائية ، أي : المحاولات المبذولة " لمغادرة الأرض " ولإكتشاف عوالم جديدة ، تمثل متابعة " منطقية " إلزامية للتطور . لكنها رغم ذلك ستنتهي في طريق مغلق .
إن التصميم الغير قابل للتفسير ، الذي يصر فيه مجتمعنا التكنولوجي اليوم على هذا المشروع الذي لايجد له بناء على خبرتنا فائدة أو تعليلآ عقلانيآ ، ليس سوى التعبير عن " الميول التطورية " التي نخضع لتأثيرها الشمولي
الفوق – فردي . فكيف يمكن أن تكون الأمور خلاف ذلك ؟ . كيف سيستطيع ( دماغنا ) أن يخضع لقواعد تختلف عن تلك القوانين التي أدت إلى نشوئه ذاته ؟ .
إن الفضاء أكبر من أن يستطيع أي إنسان ، وحتى في أقصى المستقبل البعيد ( غزوه ) . إذ أن النجوم والمنظومات الكوكبية الموجودة فيه بعيدة عن بعضها البعض إلى درجة لايمكن معها أبدآ " إجراء إتصال فيزيائي" بين الحضارات الناشئة عليها = وقد تشذ بعض الحالات المنفردة بين أقرب الجيران = .
وللبرهنة على ذلك : فسنقتصر على حجتين إثنتين فقط :
1- قدم الحجة الأولى / إدوارد فيرهولزدونك / الذي ذكر بطريقة معبرة ، أن ثقبآ بحجم رأس الدبوس في (صورة ) " لضباب آندروميدا " وهي المجرة التي تجاور مجرتنا ، والتي تبعد عنا 2 مليون سنة ضوئية ستقابله على ( الواقع ) ، فجوة لن تستطيع أية مركبة فضائية مأهولة إجتيازها في أي وقت من الأوقات . نفسر ذلك بالأرقام : - يبلغ أكبر قطر لهذا الضباب الحلزوني حوالي 000 ,150 سنة ضوئية . تقابل هذه المسافة في الواقع ، على الصورة التي قصدناها سابقآ 15 سم ، إذا كان الدبوس سيحدث في الصورة ثقبآ بقطر 1 ملم ، فإن هذا سيمثل على الواقع فتحة قطرها 1000 سنة ضوئية .
فلو إنطلقنا في ( مركبة فضائية خيالية ) تسير منذ لحظة إنطلاقها بسرعة الضوء ، أي : لاتحتاج إلى التسارع ، فإننا لن نتمكن في حياتنا من الإنتقال من أحد أطراف الفتحة إلى الطرف الآخر . إذ سنبلغ وبغض النظر عن الإمكانيات " التكنولوجية الخيالية " ، سنبلغ 100 سنة من العمر قبل أن نقطع"عشر" المسافة التي نتحدث عنها . وحتى إذا وضعنا في إعتبارنا التقدم الهائل الذي سيطرأ على تكنولوجيا الفضاء خلال مئات السنين أو حتى بعد ذلك ، فسوف لن تفيدنا بأي شيئ كل هذه التطورات المحتملة ، حتى ولا تلك الأفكار التي تتحدث عن " تجميد رواد الفضاء " أو ما شابه من الطرق ، لأننا إنطلقنا في الأصل من ( سرعة الضوء ) .
لكن : كيف سيكون الموقف إذا حصلنا على مركبات فضائية تنقلنا بسرعة ( أكبر من سرعة الضوء ) ؟ أو كيف سيكون الوضع إذا ما وفرت لنا فيزياء المستقبل ، الإمكانية لأن نتحرر من " المكان الثلاثي الأبعاد " ، وأن نتمكن بقفزة واحدة عبر ( ماوراء المكان ) ، أن ننتقل بلحظة واحدة من أي نقطة في الكون ، إلى نقطة أخرى ؟ هل نستطيع أن ننفي الإمكانيات وغيرها مما تتحدث عنه " روايات الخيال العلمي " ، إذا تصورنا مستقبلآ يقع بعد مليون سنة من الآن ؟ .
لقد وفر لنا / آرثور كلارك / هذا الجهد ، بنشره قبل سنوات ، دراسة معللة ، دحض فيها فكرة ( غزو الفضاء ) عن طريق الرحلات الفضائية المأهولة ، بطريقة قاطعة ونهائية . وهذه هي الحجة الثانية .
الحجة الثانية :
-------------- إن ضباب آندرو ميدا ، أقرب مجرة إلى مجرتنا ، يتألف من حوالي 200 مليار نجم ثابت ، أي شمس . من بينها حسب أحدث التقديرات ما لا يقل عن حوالي 6% شموس تدور حولها ، كما هو الحال لدى شمسنا . كواكب من المحتمل أن تكون عليها حياة .
6 % من 200 مليار نجم ، تساوي 12 مليار منظومة كوكبية في آندروميدا ، ومثلها في مجرتنا ذاتها . ويعرض
/ كلارك / حجته هنا :
لندع ببساطة جانبآ جميع " القيود الكنولوجية " ، ونفترض أننا لانحتاج إلى زمن يذكر عند السفر عبر"مجرتنا" من أي نقطة إلى نقطة أخرى داخل مجرتنا ، وأود علاوة على ذلك أن أضع إفتراضآ سخيآ آخر ، وهو أننا خلال هذه " الثانية " الواحدة ، سنتمكن فوق ذلك ، ليس فقط من التأكد مما إذا كان للشمس التي نزورها مجموعة كوكبية وحسب ، بل سنتمكن أيضآ من معرفة ما إذا كان يوجد على هذه الكواكب كائنات ذكية . ثم نفترض أخيرآ ، أننا نستطيع خلال نفس " الثانية " أن نعود سالمين إلى محطتنا الأرضية مع ما لدينا من معلومات . سنحتاج إذ آ
إلى ( ثانية واحدة فقط ) كي ندرس نجمآ واحدآ مع كل ما يتبعه من كواكب . كيف ستكون عندئذ التوقعات ؟
الجواب : " محطم لكل أمل " . حتى لو إنطلقنا من الإفتراضات الخيالية التي وصفناها ، فلن نتمكن خلال عمر الإنسان الواحد البالغ حوالي 60 سنة ، وإذا عملنا كل يوم 8 ساعات ، وقمنا في كل ثانية برحلة من هذا النوع ، لن نتمكن من دراسة سوى 3 , 0 % أي : 3 من الألف من الشموس الموجودة في ( مجرتنا فقط ) وحدها . وإذا ما أضفنا إلى هذه الحسابات الصحيحة ، الحقيقة المؤكدة وهي : أنه يوجد في الكون المحيط بنا ما لايقل عن عدة مئات من مليارات المجرات المماثلة لمجرتنا ، عندئذ سيتضح لأكبر المتفائلين ، أن الرحلات الفضائية المأهولة لايمكن أن تكتشف أبدآ هذا الفضاء الكوني . إننا نعيش في ( المحجر الكوني ) .
سيتوصل من يفكر بكل هذه الإحتمالات متحررآ من الأحكام المسبقة إلى إستنتاج واحد وحيد : أن الدنيا التي فوقنا مليئة بالحياة والوعي والعقل . إذا ما إنطلقنا من أن 6 % من نجوم مجرتنا لها توابع كوكبية يمكن أن تكون قد نشأت عليها حياة – وهذه تقديرات حذرة جدآ حسب رأي معظم علماء الفلك الحاليين – فهذا يعني أن أمامنا وبنتيجة تطور الهيدروجين 000 , 120 حضارة كوكبية على أقل تقدير . ويبدو لنا هذا الرقم كبير جدآ إلى درجة لا تصدق ، وهذا يعود فقط إلى أن ( قدرتنا على التصور ) مدربة على مقاييس أرضية .
والآن كيف سيكون جوابنا على ضوء هذه الرؤية ، على السؤال : إلى أين سيؤدي المستقبل ؟؟ .
إذا ما إستمرت مسيرة التطور كما حصل حتى الآن ، فإن الخطوة التالية لايمكن إلا أن تكون في " إتحاد " هــــذه
( الحضارات الكوكبية الكثيرة ) ، إلا في تجميع كل هذه الأجوبة الجزئية المنعزلة اليوم في جميع أنحاء مجرتنا . عندئذ سيتكرر في تلك المرحلة مع الحضارات الجزئية المتخصصة بإختصاصات فردية مختلفة ، مع ما حصل قبل ذلك مع الخلايا عندما أخذت تتحد مع بعضها البعض ، لتشكل كثيرات الخلايا ، لكي تتمكن من إستغلال الإمكانيات الكامنة في إختصاصاتها المختلفة إلى أقصى حدود الإستغلال .
ان الأمر الواضح هو : أن البشرية ستدخل في عملية تتحد من خلالها حضارات كوكبية منفردة كثيرة ، في روابط لتبادل المعلومات تتنامى زمنآ بعد زمن ، حتى يتحقق أخيرآ في المستقبل البعيد ، في مستقبل تفصلنا عنه الآن ملايين السنين ، إتحاد جميع حضارات مجرتنا بواسطة " شبكة من الإشارات اللاسلكية " تشبه " النبضات العصبية " في ( متعضة واحدة كونية عملاقة ) ، تملك وعيآ سيقترب محتواه من الحقيقة ، أكثر من كل ما وجد حتى الآن في هذا الكون .
--------------
في ختام ما قدمته ، أود أن أشير : إلى أن أكبر عالم فضاء في القرن العشرين ، البروفسور الألماني / فون براون/ الذي وضع أول رجلين على القمر – نيل آرمسترونغ ، أودين الدرين – في مشروع أبولو ، صرح لوكالات الأنباء وأجهزة الإعلام بعج نجاح مشروعه الكبير ، ردآ على سؤالهم : هل تؤمن بالله ؟
كان جوابه : ( كلما إزددت علمآ بحقائق الكون ، إزداد إيماني بوجود الخالق العظيم ) .
===================
المراجع :
-----------
تاريخ النشوء - هويمارفون ديتفورت .
النسبية - البيرت آينشتاين .
العوالم الأخرى - بول ديفيس .
البحث عن الحياة في الكون - مايكل ليمونيك .
--------------------
( إعتذار ) :
=======
[ الإعتراف بالخطأ فضيلة ] . وأدين هنا للدكتور / رائق النقري / مؤسس مدرسة دمشق للمنطق الحيوي ، على ساعات وشهور قضيناها في حوارات كان رفضي فيها أكثر من قبولي . واليوم تأكدت أن ذلك كان بسبب عدم إتساع معرفتي ، ومحدودية عقلي في لحظة ما . فأنهكته بحواري ورفضي لأفكاره . التي تتضمن نقاط أساسية أعترف له الآن بإقتناعي بها . منها : " اللغة الكونية الواحدة " – " المنطق الكوني الحيوي الواحد " – " العقل الكوني " . أعتذر وأقدر طروحاته المتقدمة منذ عقود .
====================================
فائز البرازي : كاتب سوري
10/3/2006
..............."
إنتهى نقل هذا الجزء
يحى الشاعر
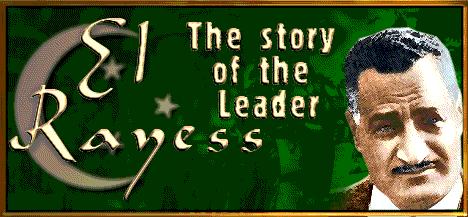 |
الــــرجوع الى الفهـــرس للمتابعة والمواصلة