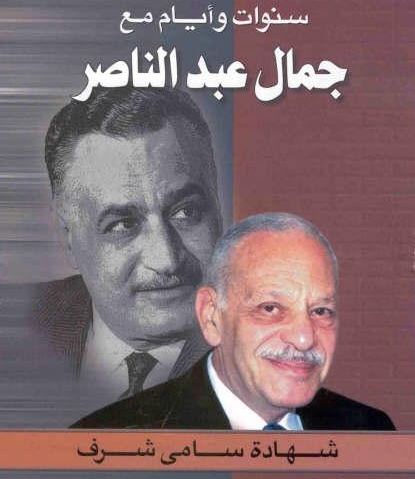 |
من أقلام الأصدقـاء والاضـيوف
الثقافة العربية الإسلامية
( عن أية ثقافة سنتحدث ، وأدواتها أسيرة السجون )
بقلم
فـائز البرازى
الثقافة عمومآ ذات طبيعة يصعب تعريفها كظاهرة معقدة . إذ ظل مفهوم الثقافة عبر التاريخ الإنساني متعدد التعريفات حسب زوايا النظر إن كانت سياسية أو إجتماعية أو فلسفية أو لغوية أو دينية . على أن أهم ثلاثة تعاريف مطروقة ومتبناه أكثر من غيرها ، في علميّ الإجتماع والأنثروبولوجيا هي :
1- التعريف الذي طرحه / إدوارد تيلور / عالم الأنثروبولوجيا البريطاني في نهاية القرن التاسع عشر والذي يقول : [ الثقافة هي ذلك الكل المعقد الذي يشمل المعرفة والعقيدة والفن والتقاليد ، وأي قدرات وعادات أخرى يتعلمها الإنسان كعضو في المجتمع ] .
2- التعريف الذي طرحه / لسلي وايت / عالم الأنثروبولوجيا الأمريكي والذي يقول : [ أن الثقافة هي القدرة الرموزية عند الإنسان ] . فهو يربط مفهوم الثقافة عند الإنسان ، بقدرة الإنسان على إعطاء معاني للأشياء ويخلقها ويستعملها ، وبالتالي فبرأيه [ أنه لايوجد إنسان بدون ثقافة ، ولا توجد ثقافة بدون إنسان ] .
3- التعريف الذي طرحه / ألفرد كوبر / عالم الأنثروبولوجيا الأمريكي ، وأبقى النقاش حولها مفتوحآ دون حسم ، خاصة في ظل المفاهيم المختلفة لها ، مثل : [ ان ليس للثقافة حضور مادي ، بل لها حضور مجرد ، وبالتالي لايمكن أن يوجد علم حول شيئ لايمكن رؤيته ] كذلك برأي / رادكليف براون / .
وبذلك عمومآ يبقى مفهوم الثقافة في علم الأنثروبولوجيا ، صامتآ عما يمكن تسميته ( الجوانب الميتافيزيقية ) للعناصر الثقافية أو الرموز الثقافية مثل : اللغة والفكر والعقيدة والمعرفة والقيم والأعراف الثقافية والأساطير .
وقد ضيق علماء الإجتماع من معنى مصطلح الثقافة ، فأصبحت تعني [ الأفكار الرئيسية للمجتمع والتي تشمل عقائد ورموز وقيم وأعراف ] . وعمومآ فالثقافة هي كبرى ميزات الجنس البشري حيث منحته السيادة في هذا الكون .
وفي بداية القرن الواحد والعشرين كان أهم ما كتب عن الثقافة ، كتاب ( فكرة الثقافة ) للمفكر والفيلسوف / تيري إيجلتون / والذي أهداه إلى مفكر عربي هو / إدوارد سعيد / . حيث يرى " إيجلتون " : أن هناك علاقة جدلية بين الطبيعة والثقافة ، يتجلى فيها البعد التكويني الإنساني ، أو " الفعالية الإنسانية " . والعمل الإنساني هو الذي يهيئ الفرصة للتأثير . فبدون الطبيعة ، لاثقافة . وبدون الثقافة لاتغيير للطبيعة . ويؤكد على تداخل مفهوم التعددية والتنوع مع مفهوم الهوية الذاتية والتهجين الثقافي . فبرأيه أن جميع الثقافات متداخلة في بعضها البعض . لاثقافة فريدة ونقية . الكل هجين متغاير الخواص ، متباين على نحو إستثنائي ، ولا يمثل بنية متجانسة أحادية التكوين .
أما / رايموند وليامز / من اليسار السياسي ، فيرى : أن أي ثقافة لايمكن أن تكون ماثلة بالكامل ومكتملة في الوعي . إنها منفتحه النهاية . الثقافة عنده هي شبكة من المعاني والأنشطة المشتركة ، ونامية بإطراد في إتجاه تقدم الوعي . ومن ثم إلى إنسانية كاملة لمجتمع كامل . والمشاركة هنا كاملة من جميع إبنائها : نخبة ، وعامة . إنها صياغة جمعية . وذلك على عكس ما يرى / تي . إس . إليوت / : حول مفهوم الثقافة المشتركة ، حيث يقسمها إلى : ثقافة النخبة / العليا ، وثقافة العامة .
وهنا جوهر الإختلاف بين : / وليامز / وبين / إليوت / . حيث أن الشيئ الأهم : [[ ليس السياسة الثقافية ، بل سياسة الثقافة ]] .
فالثقافة ليست فقط ما نعيش به ، إنها أيضآ وإلى حد كبير ، ما نحيى لأجله : الوجدان ، العلاقة ، الذاكرة ، القرابة ، المكان ، المجتمع المحلي ، الإشباع العاطفي ، البهجة الفكرية ، الإحساس بمعنى أساسي وجوهري .
المعرفة والثقافة :
-------------------
إن كان العقل غير كوني ، فإن المعرفة كونية . والمعرفة هي نتاج العقل كالفكر . إنها إحدى أهم أدوات العقل التي يستعملها الإنسان ليستولد الفكر والتفكير والتحليل والنقد . إنها مرتكز أساسي يبني الإنسان عليها معتقداته وقراراته ويعالج بها مشاكله . وإن تراكم المعرفة وإزديادها ، يؤدي إلى زيادة الصحة النسبية للإختيار والقرار .
والمعرفة هي : حصول العلم لدى الإنسان بالجزئيات القابلة للإدراك . ومن أهم مصادر المعرفة : الحس ، والعقل عمومآ . ونستطيع أن نضيف نحن العرب المسلمون ( الوحي ) كمصدر من مصادر المعرفة وإن كان هذا المصدر لايمكن إخضاعه للتجربة كما المصدرين الآخرين ، وليس لنا إلا القبول والتسليم به .
والمعرفة عند / هيجل / هي في التوفيق بين متقابلين لمعرفة كيان وتركيبة كل واحد منهما . وأن أي شيئ في الواقع هو مزيج من كل متقابل ومن المقابل له ونقيضه .
إن أهم المعارف هي معرفة الإنسان لنفسه ، ومعرفته بالآخرين ، ومعرفة الكون والطبيعة ، ومعرفة التاريخ ، شاملآ كل هذا معرفة الله الذي خلق الكون . إن كونية المعرفة في مقابل لاكونية العقل ، كشيئين متقابلين في العمومية والخصوصية ، سيفرز شيئآ جديدآ واعيآ لهذاالتقابل والإجتماع وهو : ( الثقافة ) . من حيث أنها : [ جماع السمات المميزة للأمة من مادية وروحية وفكرية وفنية ووجدانية ] – حسب تعريف المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.
ولما كانت الثقافة هي ناتج العقل كالمعرفة والإدراك ، حيث الإدراك هو " العقل " بعملية ذهنية ناجم عن المادة مع كونه غير مادي متأثرآ بالمكتسبات ومن ثم مؤثرآ بها . وحيث يختلف هذا الإدراك من شخص إلى آخر نتيجة تمايز العوامل السابقة في كل شخص ، مع إمكانية جمع أفراد ضمن مجموعات متقاربة التأثر بتلك العوامل ، متتشكل مجموعات إدراك متشابهة تفرز حسب البيئة والزمان والمكان والموروثات والتجارب المتقاربة .
هذا يصل بنا إلى القول أن للعقل العربي – الإدراك – خصائص موضوعية يتميز بها ، خاصة تلك المتعلقة بالإنتماء والهوية ، وبالتالي بطبيعة الثقافة والرؤية المعرفية العربية الإسلامية . والتي تشكل جزء أساسي من حرية الرأي .
إذ لايمكن ممارسة ( حرية التعبير ) دون التمتع بالحق في ( تلقي المعلومة الصحيحة ) . أي ان إطلاق حرية التعبير مع حجب المعلومات والمعرفة ، هو تفريغ لذلك الحق من مضمونه . فكلمة " إقرأ " هي بمعنى ( إعرف وأفهم ) وهذا ينسجم مع النهي عن الإنقياد وراء المجهول [ ولا تقف ماليس لك به علم ] . فالمعرفة حق للناس ليس قابلآ للمساومة أو الحجب .
إن الرؤية المعرفية الإسلامية بالتعبير عن طبيعة ثقافتنا ، هي في إكتشاف الرموز الثقافية وطبيعتها لبناء مفهوم للثقافة ذو مصداقية أكبر .
إرتباط الثقافة بالهوية :
------------------------
الإنتماء هو إحساس يترجم إلى واقع ملموس ينبع من هوية الفرد . والهوية ليست بيانات إحصائية ، بقدر ماهي توصيف لهذا الفرد . والهوية ليست جينات ، وليست شكلآ من أشكال الموروثات الجينية أو الصفات المكتسبة فقط . بل الهوية هي التي تقدم التاريخ للفرد ، فتبين آباءه وأجداده وجذوره ، تبين وطنه وأرضه كمرتكز جغرافي حياتي . إنها التاريخ والجغرافيا ، إنها الماضي والمستقبل ، كما أنها معطيات أساسية تحدد مصالحه وتفاعلها مع مصالح الآخرين إلتقاءآ أو تنافرآ ، تعاونآ أو صدامآ . وهذا الإنتماء الذي توضحه الهوية يدفع الفرد ليكون جزءآ من تجمع ينسجم معه ويحقق مصالحه الآنية والمستقبلية ، ثم إنتساب تلك التجمعات إلى جماعة هي أكثر شمولية وعقلانية ، تبدآ هذه الجماعة بالتأثير في الفرد الذي يملك حسآ فطريآ ( بالتوافق الإجتماعي ) . ويملي هذا الإنتساب للجماعة على الفرد ، مواقف راسخة تتأصل في ذاته ونفسيته ، ويمكن أن تتحول هذه المواقف إلى أخرى ، إذا تحول هذا الفرد إلى عضوية جماعة أخرى . أي أن طبيعة الإنتماء تملي المواقف إلى حد كبير . حيث أن حس التوافق الإجتماعي هو المسبب لبناء مواقف الفرد . وهذا الحس ، هو شعور راسخ وأصيل لدى الإنسان بضرورة التوافق مع الآخرين بفكره وعمله .
ويقول الأستاذ / محمد حسنين هيكل / : [ ان الهوية القومية تقوم على ثقافة واحدة ، وتاريخ واحد ، وأمن واحد ، ومصير واحد ] .
وظائف ومهام الثقافة في المجتمع :
----------------------------------
المعرفة والثقافة لايعبرا عن أمر مجرد يتمثل بتخزين المعلومات والقراءات والإطلاعات ، وإعادة إظهارها وطرحها كدليل على كون الفرد مثقفآ متخايلآ بمعرفته وثقافته المحصوره في " دماغه " . بل الثقافة هي موقف ووظيفة وتحليل للواقع المحيط لإستيعابه من معظم جوانبه ، وإدراك ماهيته والوصول إلى مخرجات أقرب ما تكون للصحة تبنى عليها القناعات الثابتة والمرنة ، والمواقف والمطالبات ، من خلال إستيعاب الذات وإستيعاب الآخر بشكل أقرب ما يكون للصحة ، بعيدآ عن الجهل والتقوقع والجمود . ومن أهم وظائف ومهام الثقافة :
1- تجديد الفكر كضرورة حداثية مستدامة :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إن تجديد الفكر : أسلوب التفكير ، وطريقة التفكير ، والتعمق في دراسة وتحليل المؤثرات على منتجات العقل والتفكير هي من الوظائف الرئيسية للثقافة . وللفكر العربي الإسلامي الناتج عن الإدراك ، خصائص موضوعية يتميز بها . خاصة تلك المرتبطة بالإنتماء . ومن أهم مايجب مباشرته ، أن نقوم بنقد موضوعي لعقلنا العربي الإسلامي تطلعآ إلى تطوير إدراكنا وتحديثه بشكل مستمر ، وتخليصه من شوائب وأمراض كثيره تحكمه ، لاهروبآ إلى الأمام ودخول الحداثة بعقل الآخرين ، مع رفض تقوقعه وتحجره في الماضي الذي كان – ذلك الماضي – حدجيثآ ومتقدمآ ومنفتحآ في زمان ومكان آخرين . وكما يقول الدكتور / محمد عابد الجابري / أن [ نقد العقل جزء أساسي في كل مشروع نهضة ] . وعندما ندعو إلى نقد الفكر العربي الإسلامي كوظيفة من وظائف الثقافة ، فإننا نرفض ما يسمى
( القطيعة المعرفية ) مع الماضي . فالماضي هو تراث للأمة ويجب أن نركز على هذا التراث ونجعل الصالح منه يؤسس لعقلنا وفكرنا وذاتنا العربية وفق متطلبات العصر وكل عصر قادم .
إن " ثقافة النقد " لاتزال مجرد أطر كلامية لم نرق إلى معايشتها على أرض الواقع ، بتكريس النقد الذاتي في أطر التربية والأخلاق والحقوق والقانون وإحترام الرأي الآخر ومحاورته ، إن كان داخل ذات الفرد ، أو داخل الأسرة ، أو داخل المجتمع .
2- جدلية الثقافة والمعرفة :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إن مايدعم العملية الثقافية ، هو إزدياد الوعي وتوسع المعرفة وإنفتاحها على الآفاق الإنسانية ، وكذلك فإن ما يشذب المعرفة ، هي الثقافة .
والمعرفة هي : حصول العلم لدى الإنسان بالجزئيات القابلة للإدراك عن طريق الحواس الخمسة سواء كان إدراك جزئي وبسيط ، أو مركب وموسع . فيصبح الإنسان عارفآ بالشيئ . وأدوات المعرفة : الحس ، العقل ، الوحي . وقد ميز الفيلسوف / راسل / بين نوعين من المعرفة : المعرفة باللقاء والمدرك بالحواس . والمعرفة بالوصف الذي ينطوي على إستنتاجات عقلية . وتقوم المعرفة على : التقابل بين ( ذات مدركة ) و ( موضوع مدرك ) . وهي بهذا الشكل تحصل – المعرفة – للذات العارفة بعد إتصالها بموضوع المعرفة . وتكون إمكانية تحصيل المعرفة ، إما عن طريق : ( النزعة التوكيدية اليقينية ) بإثبات قيمة العقل وقدرته على المعرفة للوصول إلى يقين ، وبالتالي عدم وقوف العلم الإنساني عند حد . أو عن طريق : ( النزعة الشكية ) التي تقوم على التشكيك في إمكانية تحصيل المعرفة الصحيحة ، مثل أرسطو وبيكون والغزالي ، حيث إعتبروا الشك منهجآ على طريق البحث والمعرفة الصحيحة.
وكما يذكر الدكتور / عزيز العظمة / : فقد تحولت " النظم المعرفية " من حالة الركون والإستناد إلى ماجاء في الكتب الدينية أو التقاليد السحرية والإسطورية ، إلى معرفة بالطبيعة والتاريخ . والنظم القانونية من فقه إسلامي وقانون كنسي وعدالة سلطانية ، إلى قانون مدني تطبقه المحاكم . والمؤسسات التربوية من كتاتيب ، إلى مدارس وجامعات . ومن الإنتقال من النار والشموع ، إلى الكهرباء . ومن الحمير والخيول ، إلى السيارات والطائرات . ومن السيوف ، إلى الصواريخ .
وبكون الثقافة نتاج الوعي بالمعارف الكونية جميعها ، إلا أن خطر المعرفة يتمثل بالنسبة لنا بما يمكن تسميته بخطر
" الإغتراب " ، أي بمعنى التغريب والتفرنج الذي هو إستلاب . والإستلاب بين تلك المعارف ، سيشكل مفهوم الوعي الخاطئ . إن الثقافة بإعتبارها ( التعبير الواعي ) عن مجتمع معين بأسلوب ولغة من خصائص هذا المجتمع ، ستنتج إذا توفرت هذه الشروط ، ( ثقافة قومية ) .
ولا بد لنا من الإمتلاء بالثقافة العربية والتراث العربي الإسلامي عند الخوض في التطوير والحداثة . والإمتلاء بالثقافة العربية الإسلامية ، وهي ثقافتنا القومية ، هو إمتلاء الهوية . وبدون هوية واضحة وممتلئة بمقوماتها ، يكون الإنفتاح على الثقافات الأخرى وخاصة المهيمنة منها ، مدعاة للإنزلاق نح الوقوع فريسة للإستلاب والإختراق.
وفي الإطار الثقافي العالمي المنفتح على المجتمعات ، يلح السؤال : متى يصبح المرء خائنآ لثقافته ؟
إن توافر مسارات التغيير أمام الأفراد ، يسمح لهم بالإنتقال من نمط حياة إلى آخر . وبموجب ذلك فإن تبني موقف لايتفق مع نمط الحياة التقليدية في " قضية عرضية " ، لايجعل المرء خائنآ لثقافته . لكن لو تعدى المرء الإختلاف العرضي إلى إنتهاج نمط مختلف ، فإن إنتماءه الثقافي يصبح موضع شك .
3- الثقافة الجماهيرية ، وتفعيل الحراك المجتمعي :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إن ( المخزون الجماعي ) للثقافة يجب أن يكون واضحآ " كوظيفة أساسية للثقافة " . وهو قدرتها ودورها في إحداث التغيير والفعل المؤثر في حياة الفرد والمجتمع . إنها رافعة التاريخ وصانعته ، وقائدة التطوير في كل مجالات الحياة الإجتماعية والسياسية والإقتصادية . ومن ضمن " وظائفها " الأخرى ما هو معني بشكل خاص بإنتاج الأفكار والرؤى والتصورات ونقد السلوك والأفكار التي لم تعد ملائمة لحركة التقدم ، وبين ما هو معني بشكل عام بما تعطيه للمجتمع من معنى ، وما تضيفه وتطوره من قيم ووعي على جميع المعاني والماديات . فتصبغ المجتمع بما تقدمه له ، وفي ذات الوقت فإنها وبشكل متلازم وجدلي ، تتسم بسمات المجتمع الذي أنتجها . ويقول المفكر والباحث السوري
/ جاد الكريم الجباعي / : ان الإنسان كفرد في المجتمع ينتج عالمه ويصنع تاريخه وينتج ذاته . وإنتاج الذات هو الثقافة . مع التأكيد أن الطابع الفردي للإبداع يتحول إلى ماهية إجتماعية ومجتمعية .
ومع فشل " السلطة الأبوية " في منح الثقافة الجماهيرية دورآ واعيآ ، وتوسعآ في التعبير والتطوير ، ظهرت التقنية الإتصالية بإختراق الثقافات الجماهيرية في المجتمعات النامية ، وساعدت هذه التقنية في ضعف وسقوط حدود كثيرة بين الثقافات . فصارت هناك ثنائية الثقافات المنفتحة ، والتي ينظر إليها بوصفها ثقافات دخيلة ، تخشاها الثقافات التقليدية . فإصطدمت الثقافة المنفتحة بمقاومة عنيفة من الثقافات التقليدية التي لم تطور نفسها وإمكانياتها وتفاعلها مع المجتمع . ومن هنا تأتي أهمية وضع تصورات وبرامج وقواعد في مثل تلك الثقافات التقليدية ، تدفع إلى صالح الإنفتاح وبصورة تضمن مناهضة التوجه لدى الحكومات لفرض السيطرة والرقابة على كثير من الأمور . كما تضمن تطوير القدرة الجماهيرية الذاتية لمواجهة الغزو الفكري الذي تحمله تقنية الإتصال الحديثة ، هذه التقنية التي تبدو كأنها رأس حربة هدفها النيل من الثقافات العريقة قبل أن تنهض من كبوتها .
إن الثقافة الجماهيرية هي نعمة للناس ومساهمة في تطوير المجتمع ، بعكس ما حدث في الأزمنة السابقة قبل إختراع وسائل الإتصال ، حيث كانت الجماهير مسحوقة غارقة في الفقر والجهل والأمية ، حين كانت الثقافة والمعرفة حكرآ على فئة قليلة العدد ، كثيرة الإمتيازات . وقد أدت وسائل الإتصال منذ إختراع المطبعة ، دورآ مهمآ في تفجير المعرفة وتثقيف الشعوب ، وأسهمت ثورة المعرفة إسهامآ جذريآ في تنمية افنسان وقدراته ، وحققت له مكاسب إجتماعية وسياسية وإقتصادية وتعددة . لكن تظهر خطورة هذه المسألة من جانب آخر ، في أن وسائل الإتصال الجماهيري العربية ، وبخاصة التلفاز والسينما ، تبث نسبة عالية من الإنتاج المستورد من المصادر الأجنبية . وهذا النتاج يتضمن قيمآ غريبة عن المجتمع العربي ، ويحمل تقديمها في طياته أخطارآ جمة ، وبخاصة على النشئ ، بالإضافة إلى الشريحة الأمية ، وجميع الذين لم يتعمق وعيهم القومي بعد . وبسبب ذلك يدق المثقفون والباحثون العرب ناقوس الخطر من جراء هذا الهجوم الذي يتهدد جوانب كثيرة من حياتنا .
ومن هنا كانت الدعوة إلى فتح الباب وعدم تقييد الحراك المجتمعي ، بل دعمه وتفعيله أخلاقيآ وإجتماعيآ وسياسيآ وخاصة في مرحلتنا التي تحتاج إلى الوعي بذاتنا ، والدفاع عنها بتفعيل ( ثقافة المقاومة ) بكل معانيها وأنواعها ومتطلباتها . وهنا لابد من التأكيد على :
· ضرورة إعتماد الوطن العربي على قدراته الذاتية ، وتخصيص نسب عالية من الدخل القومي لأغراض البحث العلمي ودعم الإبتكار والإبداع ونشر الثقافة .
· إقامة مؤسسات عديدة للترجمة الآلية والبشرية ، لترجمة ما ينشر في مختلف اللغات ، في العلم والثقافة .
· إعتماد اللغة العربية كلغة أساسية مدعومة بلغات أخرى ، في مناهج التعليم المختلفة ، الأمر الذي يؤدي إلى توطين ، ثم إبتكار العلوم المتقدمة التي تخدم الوطن العربي .
· القطيعة مع النظم التربوية والتعليمية التي أسسها الغرب الإستعماري في الوطن العربي لخدمة أغراضه وخلق أجيالآ تابعة له لغويآ وثقافيآ . وإقامة نظم تربوية وتعليمية تهدف إلى تجذير الأجيال المتعاقبة في لغتها وثقافتها القومية ، وتستجيب لحاجات تنمية المجتمع .
· مواجهة الغزو الثقافي الإستعماري ، بخلق المؤسسات الوطنية والعربية التي تنتج منتجآ ثقافيآ يجذر المواطن في واقعه وفي تراثه ويمده بنظرة واضحة للمتطلبات المستقبلية .
· إدانة إعتماد بعض المنتجين الثقافيين على التمويل الأجنبي المشبوه ، لإنتاج البرامج التلفزيونية والإذاعية والسينمائية ، التي تهدم القيم العربية الأصيلة .
· دعوة الأنظمة العربية بإلحاح إلى رفع الحواجز أمام المنتج الثقافي العربي وتسهيل تداوله ، وتخفيض تكاليفه .
· الشجب والتشهير بمحاولات بعض المثقفين العرب الإنتهازيين ، إجراء إتصالات مشبوهة ومدانة مع العدو تحت مختلف التسميات والذرائع .
التنمية الثقافية ، ومحددات الثقافة :
--------------------------------------
تعني التنمية الشاملة في أحدث مدلولاتها ، تنمية الجوانب الثلاثة التالية : الثقافية – الإجتماعية – الإقتصادية . وتتم تنميتها جنبآ إلى جنب وبشكل مترابط دون إهمال احداها . والتنمية هي عملية مشاركة على نطاق واسع تهدف إلى إحداث تغيير في المجتمع لإحراز التقدم في النواحي المادية والإجتماعية ، بما يضمن تحقيقآ أفضل للعدالة والحرية والقيم الأخرى لدى عموم الناس ، من خلال سيطرة أفضل على مجمل العوامل البيئية . ووفق هذا الطرح ، يتم تحقيق التنمية من خلال :
1- توزيع المعلومات والمنافع الإجتماعية بصورة عادلة تؤدي إلى القضاء على فجوة المعلومات بين الذين يعرفون فيستفيدون من الفرص ، وبين الذين لايعرفون فتضيع عليهم الفرص .
2- المشاركة الشعبية في تخطيط برامج التنمية وتنفيذها .
3- الإعتماد على الذات ما أمكن في التنمية .
4- التكاملية بين الأنظمة التقليدية – القديمة – والحديثة .
ولتضييق فجوة " المعلومات " ، لابد من بث رسائل إتصالية حافلة بالتفصيل ، تتناسب مع مستوى الفئات المتأخرة، وبث رسائل إتصالية موجهة للفئات المتأخرة بالذات وقد لاتناسب غيرها ،و إستعمال وسائل الإتصال المحدودة مثل أشرطة الكاسيت والفيديو ،و إستعمال قنوات الإتصال التقليدية . وبإتباع إستراتيجيات الإتصال التنموي ، تقوم وسائل الإتصال الجماهيري بتقديم مواد ثقافية بهدف زيادة المتلقين في جوانب حياتهم المختلفة . وفي المجال الثقافي تعمل وسائل الإتصال من خلال تقديم برامج ثقافية تعمل على زيادة " الوعي " بأحداث التراث المهمة ، المحلية والعالمية بما يعمق الوعي بالهوية والإنتماء .
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا : ماهي المحددات الثقافية التي ستلازم هذه التنمية ؟ .. نستطيع القول أن ( وظائف الثقافة ) هي التي توضح هذه المحددات تطويرآ وتغييرآ ، بما يتناسب مع كل مرحلة لإستكمالها دون القفز فوق المراحل وصولآ إلى مراحل أخرى لم يتهيأ المجتمع لها ، ولم تفرغ الوظيفة الثقافية المحددة من أداء مهمتها بعد .
أي أن محددات الثقافة تتوضح وتترابط حسب كل مرحلة . وأكاد أعتقد أن من أهم محددات الثقافة هي : الهوية – الهدف . حيث تؤدي ( المرحلية ) إلى ترابط وثيق بينهما وبين الثقافة .
فالهدف من الثقافة يتحدد حسب متطلبات المجتمع في كل مرحلة . فهو قابل للتطوير والتغيير والتجاوز إلى أعلى ، عند تحققه في مرحلة ما . كذلك الهوية بكونها تمثل واقعآ مجتمعيآ وسياسيآ تخدمه وتمثله . وهذا الواقع لن يبقى إلى أبد الآبدين على ما هو عليه ، وبالتالي فإن ( مفهوم الهوية ) سيتطور مع تطور الواقع المتمثل فيها ومتناسبآ مع مرحلتها ولن تبقى الهوية متحجرة ثابته ، وعندها تتطور الثقافة ووظائفها مع تطور محدداتها ، بعيدآ عن الإنغلاق ، وأيضآ بعيدآ عن الإنفلاش والضياع .
أدوات تفعيل الثقافة :
----------------------
عندما نقف مع / عبد الرحمن منيف / في رأيه عن الأوضاع الثقافية وضرورة تفعيلها ، نلمس المأزق الذي تعيشه الثقافة العربية اليوم . المأزق الناشئ من حيرة الثقافة وشعورها بالعجز . هذه الحيرة نتيجة إخفاقات الماضي ، وعدم القدرة على قراءة الأسباب الحقيقية لهذا الإخفاق ، ومن ثم الشعور القوي بالإحباط ، أو البدء مجددآ من الصفر في كل محاولة للنهوض .
ولأن العالم اليوم بالغ السرعة ومتشابك العلاقات ، كما يراد أن تسيطر عليه أنماط محددة من الأفكار والسلوك . ولأن الثقافة تلعب دورآ أساسيآ أو هكذا يفترض ، فإن الآخر القوي والمختلف يضع أولويات لما يجب أن تكون عليه الثقافة. فزيادة طغيان الثقافة الإستعمارية ، مقابل تراجع الثقافات الوطنية وتصدير وطغيان أنماط من الأفكار والأساليب بهدف إرباك الثقافات الوطنية وتغيير أولوياتها ، وإشغالها عن ( همومها الحقيقية ) ، وإغراقها في هموم وإهتمامات لاتعنيها في " المرحلة الراهنة " ، يوصل إلى زيادة وإتساع الهوة بين المتقدمين والمتخلفين .
لذلك فإن الثقافة والمثقف لابد أن يلعبا دورآ مركزيآ في وطننا العربي ، مما يجعل الثقافة والمثقف مختلفين من حيث ( الدور والمسؤولية ) عن أدوار الآخر ، كواجب وضرورة تمليها ظروف هذا الوطن ، خاصة في المرحلة التاريخية الراهنة . مع ضرورة تذكر دور المثقف الأوروبي في فترة إنطلاق عصر الأنوار ، وما تصدى له من دور ومهمات من أجل الوصول إلى النتيجة التي نراها في أوروبا الآن . والتي تختلف الآن عن مثقفي البلدان المتقدمة الذين أعفوا أنفسهم أو أعفتهم الظروف التاريخية من القيام بمهمات معينة ، نظرآ للإنتشار الواسع للمؤسسات المدنية والأحزاب والصحافة ورقابة الرأي العام وحرية الرأي والضمير ، والذي لاوجود لهذه الصيغ والقيم في وطننا .
والثقافة لاتستطيع الهروب من المشاكل والهموم الحقيقية للناس ، ولا التنكر لطموحاتهم وأحلامهم . ولأن جوهر الثقافة الوطنية القومية هو : الوعي التاريخي للعصر والواقع معآ ، وإدراك حقيقي للأخطار والتحديات ، فمن خلالها نستطيع قراءة الأفكار وآمال المستقبل ونحس بالمخاوف ونقرأ التحديات .
من هنا تصبح الثقافة العربية في مواجهة واسعة وكبيرة بين خيارين وإرادتين : خيار وطني قومي دافعه الحرية والكرامة ومقاومة التبعية والسيطرة ، وخيار العدو الذي يريد الهيمنة والإلحاق والإستغلال . ومن خلال صراع الإرادتين ، تتحدد المواقف ويحكم عليها . وبذلك تتجاوز الثقافة مجرد تسجيل المواقف أو البراعات اللغوية والأسلوبية والمعرفية ، لأن حقيقتها تتجلى الآن في رفض ما يريد العدو فرضه أو تكريسه ، وتتجلى في ( ضرورة تحريض القوى الحية في المجتمع ) كي تختار ما يعبر عن مصلحتها وطموحها . فالشمولية النسبية لهذا الخيار المجتمعي المبني على وعي وثقافة الجماهير ، ستزيد من قوة وصلابة الإرادة والممانعة والمقاومة لمشاريع الإلحاق والتبعية . وتفعيل الثقافة المجتمعية ، يقتضي :
· توسيع حرية الحراك الثقافي وحرية التعبير والنشر .
· تشجيع الدولة على تفعيل الحراك الثقافي بدون وصاية .
· دعم المراكز الثقافية بكل أشكلها : مطالعة ، كتابة ، تأليف ، دوريات ، شعر ، موسيقى ، فنون جميلة .. .
· سعي هيئات المجتمع المدني لإقامة الندوات والحوارات والمنتديات والجمعيات المدنية والثقافية بدون خلفيات أيديولوجية أو سياسية أو حزبية .
· تنمية حركة الترجمة .
معوقات الثقافة :
------------------
من أسف ، فإن كل ما يحيط بنا وما يعيشه مجتمعنا العربي ، هو معوق للثقافة ولكل مناحي التطوير في حياتنا . إننا نستطيع أن نفرز معوقات الثقافة إلى أمرين : أمر خارجي - وأمر داخلي .
والأمر الخارجي : هو التدخل ومحاولة السيطرة وفرض التبعية والإستغلال والنهب من قبل الغرب الإستعماري لجميع الدول والمجتمعات العالمية خدمة لأهدافه وإستراتيجياته الإقتصادية والسياسية والإجتماعية . وهذا الأمر حادث على مر التاريخ وليس بالأمر الجديد . ولن أتطرق لهذا ( الأمر الخارجي ) المفهوم والواضح ، وحتى لانجعل منه مجرد " سبب " نعلق عليه أسباب تخلفنا وفشلنا وأخطائنا كما نفعل الآن لننجو من نقد الذات والتهرب من مسؤولياتنا .
والأمر الداخلي : وهو ما تعلق " بذاتنا " سلطات وشعوب . فهما – السلطة والمجتمع – متضامنين في مسببات التخلف وإفراز المعوقات .
وفي العموم : فإن إشكالياتنا الثقافية الأولوية ، هي الدائرة حول هاجس الهوية والنقاء الثقافي ، وعدم القدرة على التوافق مع تحولات الزمان والمكان كما يطرح الأستاذ / تركي الحمد / . فهي هاجس نخبوي قبل أن يكون همآ إجتماعيآ عامآ . وكذلك الإرتباك الناجم عند متلقي الخطاب الثقافي المختلف ، حسب إختلاف المنطوقات الأيديولوجية ، وهذا ما يجب الإبتعاد عنه ، وعن مشاريع أدلجة الثقافة . وتلك المسافة الفاصلة بين صومعة المثقف ، وبين الواقع الجماهيري وعدم الإهتمام بقضاياه الفعلية ، وعدم قدرة تلك النماذج من المثقفين على النزول إلى الشعب إلى أرض الواقع . وهناك إشكاليات ثقافية لاتتجاوز ذهن المتعامل معها وبها ، إذ لانستطيع أن نجعل من الطفل شابآ ناضجآ ، بدون أن يمنح فرصة زمنية لإكتساب المعرفة والخبرة والتجربة ، ومن خلال الصراع مع المعطيات والمتغيرات .
كما أن هناك معوقات لبناء الثقافة ترتبط بمعطيات عقلية وفكرية منها ، كما يطرح الدكتور / محمد جابر الأنصاري / :
· الغلو في تديين الدنيا : مع إنتشار مقولة " الإسلام دين ودنيا " المضللة أكثر الأحيان . مع أن النصوص الدينية المتعلقة بشؤون الدنيا ، قليلة وعامة ، ومفتوحة للتأويل والتفسير حسب مقتضيات القضية المتغيرة في الزمان والمكان . فالله تعالى في سورة المائدة – 3 – آخر ما أنزل من القرآن وليس فيها منسوخ – مع إختلاف مفاهيم النسخ – قال : ( اليوم أكملت لكم دينكم ) . ولم يقل : أكملت لكم دينكم ودنياكم .
· التقديس الإختزالي للتراث : والتراث بمعنى " الميراث " . ( وتأكلون التراث أكلآ لمّا ) الفجر – 19- أي دون التفريق بين حلاله وحرامه . وهكذا يمكن أن ينصرف إلى الميراث أو الموروث الثقافي .
· المعادلة المقلوبة في العلاقة بين حلقات الزمن الثلاث : وتعبر عن ذلك مقولة / مالك بن أنس / : ( لايصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها ) . أي أن المستقبل لايعني أكثر من محاولة العودة إلى الماضي . هذا الفهم للثقافة الماضوية ، لايمكن أن يتعايش مع ثقافة مستقبلية في بنيتها .
· المبالغة في تضخيم الذات : مع وجود التوتر والخلاف الدائم القائم في علاقتنا بالآخر ، سواء كان هذا الآخر هو ماعدا الأمة على المستوى الخارجي ، أو ما عدا " الرأي الصحيح " ! على المستوى الداخلي . وبالتالي نريد أن نقنع أنفسنا بأنه لن تقوم لنا قائمة ، إلا بتلاشي هذا الآخر . لكن .. كيف سيتلاشى هذا الآخر ونحن في هذه الحالة من التخلف والفرقة والعلل ؟ . ليس هناك سبيل لذلك إلا ( إنتظار معجزة ) تنقلنا من القاع إلى القمة . وهذه إحدى صفات الثقافة العربية المعوقة . أي السحرية المغلفة بغيبية اسطورية .
كذلك فإن من معوقاتنا الثقافية ، فقدان ( نزعة التحليل الإجتماعي النقدي ) ذات الحس التاريخي الواقعي ، والتي هي حلقة الوصل الضرورية التي نحتاجها لنقيم جسرآ بين الثقافة العربية الجديدة ، وبين واقعها العربي . إن نزعة التفكير الإجتماعي ، أي : التحليل العلمي ، المنطقي والواقعي لمسيرة تاريخنا وحاضرنا وإحتمالات مستقبلنا ، هي أشد ما إفتقر إليها أدباؤنا ومثقفونا في أغلب مراحل النهضة العربية الحديثة . وهي النزعة التي أشاح عنها الجمهور العربي في سواده الأعظم ، عندما برزت في كتابات عدد من كتابنا ومفكرينا القلائل .
وعلاوة على ذلك . فإن هناك الكثير من معوقات الثقافة في الواقع العملي الذي تعيشه مجتمعاتنا العربية ، أهمها :
1- ديكتاتوريات السلطات والمؤسسات الأبوية .
2- الوصاية وبكل أنواعها : وصاية السلطة ، وصاية ولي الأمر ، وصاية المثقفين ، .. الخ .
3- تقليص هامش التعبير عن الذات وعن المشاكل وعن الحلول التي يمكن أن تطرح للتفكير والدراسة وإختيار الأنجع منها .
4- فرض الثقافة الموجهة والملزمة والمقننة من السلطة على المجتمع وعلى الحركة الثقافية .
5- الرقيب العام ، والذي يمكن أن لايكون على أية صلة بالحركة الثقافية .
6- الرقيب الذاتي ، والذي يفرضه معظم المفكرين والمثقفين على أنفسهم . إما خوفآ أو طمعآ أو مراءاة ، أو بسبب الأحكام المسبقة المترسبة بالذات ، أو التخوف من ردود الأفعال المجتمعية .
7- الفقر والمعاناة الإقتصادية ، والتي تتجلى بالإنشغال بالبحث بالبحث لتوفير أسباب المعيشة الضنكة ، وضروريات الإختيار بتوزيع الوقت وفائض المال إن وجد . فالدجاجة هنا أهم من كتاب .
8- عدم الوعي بإرتباط الثقافة بالعوامل السياسية والإقتصادية والإجتماعية .
وإن كانت أمتنا العربية تمر بمرحلة إهتزاز وفقدان بوصلة التوجه ، فإنها تعيش مرحلة إنتقالية تتجلى فيها أزمتها من خلال سببين رئيسيين يضم كل واحد منهما أسبابآ فرعية متفرعة منه ، أو أنها في مجموعها مكونة له :
الأول : - أن أزمة هذه الأمة تتجلى بمحاولة التحول الجذري من المجتمع التقليدي القديم ، إلى مجتمع جديد في مفاهيمه الحضارية والثقافية والإجتماعية والسياسية ، ضمن المرتكزات الأساسية لهذه الأمة ، والذي سيستتبع تطوير وتوضيح وتفعيل الهوية القومية الإسلامية وفق نظرية للإدراك والوعي الموضوعي والعلمي ، قابلة للتوسع والتحسين في نطاق التطلع الإنساني .
الثاني : - أن الأزمة العربية معلقة بشكل أو بآخر بأزمة عالمية إنسانية في الفكر والواقع ، شاملة تغير في المفاهيم،ومناهج التفكير ، وأساليب التعليم ، والمكونات الثقافية ، وأنماط العلاقات والنشاطات السياسية والإجتماعية والإقتصادية ، والمفاهيم الأمنية والإستراتيجية .
وأود الإدعاء .. بأن تحميل الفشل والتخلف على الأفكار وعلى التركيبة فقط ، وإبراء إزدواجية الممارسة وأسلوب التفكير ، هو تحميل سطحي وفاقد لمرتكزات تقوم عليها هكذا إدعاءات والتي وكأنها تدعونا إلى الإستقالة من الوجود ، ومن الفعل ، ومن النقد والتصويب وإعادة البناء والسعي إلى التحديث والتطلع إلى الحداثة . إلا أن ربط الحداثة ، بالتخلي عن التاريخ والقيم والذات ، لهو مرض فكري فيروسي يزيد من عمق أزمتنا ويظلم ذاتنا ظلم الإنتحار . وأدفع هنا بإبداع الشاعر الداغستاني / رسول حمزتوف / : ( إن أطلقت رصاصك على الماضي .. فإن المستقبل سيغتالك ) .
الثقافة والإبداع :
----------------
ان إزدياد وعي افنسان بذاته ، سمح له بأن يميز بين ما هو " ذات " وما هو " لاذات " ، فأصبح يمارس حياته بين
" الأنا " وما هو " ليس أنا " . واليس أنا ، إنقسم عنده إلى ماهو " بشري " الذي يسمى ( الآخر ) ، وما هو متعلق " بالطبيعة " بإمتدادادها المفتوحة . وهذه النقلة الرائعة ، هي في نفس الوقت ( منحة أصيلة ) . ذلك لأنها هيأت لهذا الكائن الإنسان ، مساحة غير مسبوقة من الحركة المتنوعة التي عرفت في ظاهر السلوك بإسم ( الحرية).
ومن فرط فرحته بها ، ومن فرط عماه عن حدودها وخداعها ، راح يتغنى بما تصور أنها تعنيه حتى ( قدسها ) ..
وعندما تقدست ، أصبحت صنمآ في ذاتها لذاتها ، فحرم نفسه من حقيقة حركيتها وتنويعات جدلها . فالحرية الحقيقية ، لاتتفق مع التقديس ، وإن كانت لاتنفي ( توليد مقدسات مرحلية ) لمسيرة الجدل شريطة أن تكون قابلة للتطور مفتوحه النهاية . وهذا " الوعي بالحرية " أوقع الإنسان في عدد من المضاعفات ، بقدر ما أعطاه قدرآ متزايدآ من الفرص للتطور المسؤول ، والخطِر في آن .
فما هو وضع الحرية بما هي عليه ، " لابما شاع عنها ولا بما اختزلت إليه " ، في علاقتها ( بالإبداع ) ، على مستوى العملية الإبداعية ، وعلى مستوى الناتج الإبداعي ؟ .
بداية يجب أن نتفهم ضرورة التمييز بين " الإبداع " وبين " مخرجات الإبداع " . وهنا فالحرية في الإبداع لاتبدأ بحرية التعبير ، ولا تنتهي بحرية النشر ، فالنقد . صحيح أن حرية التعبير وحرية النشر ، هي إعلان جيد عن حجم المساحة التي تتجول فيها حركية الإبداع لمجموعة من البشر في وقت بذاته ، وفي موقع بذاته . لكن لاينبغي أن نقبل هذا الإختزال بشكل يعمينا في النهاية عن أساسيات أعمق وألزم فيما يخص العملية الإبداعية ذاتها . إذ لا إبداع بلا حرية حقيقية ، ولا حرية بغير حركية مرنة ، ولا حركية مرنة بغير جدل غامض ، ولا جدل إلا في حضور عدد من المتناقضات متضافرة في رحاب وعي خلاق ، يتخلق مع ( آخر ) يمارس نفس العملية من زاويته وبطريقته .
وإن المجال الجوهري الذي يمكن أن تختبر فيه وتتحقق أيضآ فيه بعض حرية الكائن البشري بما تميز به من وعي وإرادة ، هو مجال " الإبداع " . فالكائن البشري هو الكائن الوحيد – فيما نعرف – الذي أمكنه ويمكنه أن يمارس إبداعه ذاته ، بما يشير على إمكانية إبداعه لما يعد به . ويفعل ذلك من خلال تلك النقلة النوعية التي أكسبته الوعي والإرادة ، اللذان سمحا له بإستعمال العقل ومنتجاته ، ليمارس فيما يمارس ، ما أسماه ( الحرية ) وقود الإبداع البشري وشرطه .
ومن هذا المنطق تصبح مسألة الحرية وعلاقتها بالإبداع ، إشكالية تطورية بشرية غير مسبوقة قبل الإنسان . وليس معنى أن الإنسان قد إكتسب الوعي والإرادة ، أن تطوره الذاتي والنوعي ، قد أصبح مستقلآ عن آليات التطور الطبيعية التي أفرزته ، بل ان هاتين الميزتين تجعلان الإنسان أكثر من المحيط والظروف ، متضامنآ في المسؤولية عن الطفرات اللاحقة : إما تطورآ .. وإما إنقراضآ .
والإبداع البشري هو عملية تطورية أصلآ . وما " الناتج الإبداعي " إلا إعلان عن " عجز مرحلي " عن تحقيق بعض رؤى هذه العملية ( حالآ ) . فكأنما يقوم هذا الناتج الإبداعي بالإحتفاظ ( بحق التطور ) كما سجله ، في الوقت المناسب . والإبداع البشري كما نعرفه ونمارسه ، أصبح محنة الإنسان وشرف تمتعه بالوعي في آن واحد . وهو في نفس الوقت إختبار لأحقية الإنسان في المشاركة في مسار تطوره .
والشروط الواجب توافرها لحرية ( حركية العملية الإبداعية ) ، هي غير الشروط اللازمة لإمكان ( الإعلان عن ناتج العملية الإبداعية وتسويقه ) ، مع أن العلاقة بينهما وثيقة . وحتى تتحقق " العملية الإبداعية " في رحاب الوعي والإرادة ، فثمة شروط وفاعليات لابد من تحققها بدرجة مناسبة . وأهمها :
· مساحة كافية لإستيعاب حركية الوعي .
· تنشيط لأكثر من مستوى من الوعي .
· القبول بدرجة من المخاطرة .
· حركية مناسبة ذات توجه جدلي .
· قدرة على التناسب بين الكمون والحركة .
وتختلف هذه الشروط والفاعليات عن تلك التي يجب أن تتوفر لتحقيق " حرية التبادل والتسويق والحفاظ على الناتج الإبداعي " . إذ يتحرك الناتج الإبداعي – مخرجات الإبداع – بحرية وبشروط أخرى وفاعليات مختلفة . منها :
· قدر كافي من الموضوعات والمعلومات والمعارف والخبرات .
· محيط من السماح ممتد من " العملية الإبداعية " حتى إعلان نتائجها .
· أدوات للأداء والتعبير والتفعيل والإخراج .
· فرص مناسبة لإستعمال هذه الأدوات ، وفرص لإعلان ناتج إستعمالها .
· إمكانية توصيلها لأصحابها ، وإمكانية الحوار حولها لمراجعتها بما يسمى " النقد " .
والإبداع هو مخاطرة نحو المجهول . والإبداع الأصيل لايوجد فيه سقف للمخاطرة ، ولا توجد فيه محظورات . وإن كان الحظر قد يأتي " لاحقآ " حين تنتقل العملية الإبداعية ، إلى مستوى " الناتج الإبداعي المعلن " . والأخذ بالمخاطرة في مراحل العملية الإبداعية التي هي شديدة الخصوصية ، ليس لها سقف . المخاطرة هنا تقتحم أي محظور من أي نوع مهما تقدس : دينيآ ، ايديولوجيآ ، علميآ ، أو عرفآ ، أو تقاليد ، أو محرمات ، أو وعي عام ، أو رأي غالب ، أو قانون . المبدأ الأساسي في هذا الموقف ، هو أن ( كل شيئ قابل للتداول ، وكل مسلمة قابلة للمراجعة ، وكل مقدس قابل للفحص والنقد ) .
لكن عادة ما يحتاج الأمر إلى خطوة ( إبداعية توسيطية ) تقوم بالتوليف بعد إتمام العملية الإبداعية ، بين المخاطرة الأولى الغير محدودة ، وبين المراجعة التالية ، التي تحيل " العملية الإبداعية " ، إلى " ناتج إبداعي متاح " . ويمكن أن نقول أنه إذا إنعدمت المخاطرة بالإطلاق ، مات الإبداع ، أو تسطح إلى أبعد الحدود . والرقيب على هذا الإبداع ، خطرآ على الإبداع . والرقيب هنا قد يأخذ أشكالآ مختلفة :
· فقد يكون الرقيب جاهزآ قديمآ في داخلنا منذ الولادة فيما هو جينات ووراثة .
· وقد يكون الرقيب قد لحق بنا منذ بداية التنشئة ، وهو يمسك بيده المعجم القديم الثابت ، لتحديد المسموح والممنوع .
· وقد يكون من واقع سلطة دينية – وليس الدين في ذاته – سلطة تمادت في التفسير والتحجيم والوصاية بما يعوّق ، لا بما يخلق .
· وقد يكون داخليآ وليس من الخارج ، من قبل ايديولوجية شاعت وتمادت حتى أصبحت من المسلمات بإعتبارها النهاية القصوى .
· وقد يكون الرقيب مؤلفآ من كل ذلك ، فالمصيبة في شأن كل هؤلاء الرقباء ، هي أننا كثيرآ نكون الذين عيناهم في داخلنا ، بل ونحتفل بمراسم تسليمهم صولجان الرقابة ، ولذلك ولغيره لانحاول مقاومة هؤلاء الرقباء أو مواجهتهم أو مخالفتهم أو تحجيمهم .
· وقد يكون الرقيب أحيانآ من قبل ( منظومة الحرية ) حين تصبح " قيمة مقدسة " ، لاحركية نابضة . فقد يخطر لمبدع أثناء إنطلاق إبداعه ، أن يقر بعض الحواجز في كل أكبر لايعرفه ، فيبدو هنا وكأنه قد تجـــاوز (تقديس الحرية ) ، ولا يستبعد أن يقفز إليه الرقيب من داخله فيمنعه من التمادي في هذا السبيل خوفآ من الحكم عليه بالهرطقة في حق الإله المسمى ( الحرية ) . هنا يصبح الرقيب المعين من قبل " الحرية " ، هو نفسه الحائل دون ممارسة حقيقة وحركية الحرية ، بما يترتب عليه من فساد أصالة العملية الإبداعية .
في الإبداع ... تبدأ الحرية من الداخل إلى الخارج ، كما تتدعم من الخارج للداخل بإستمرار . والخطر الأكبر يتمثل في إحتمال أن ينتقل قهر الخارج المعلن الذي يمكن رفضه وإختراقه وتجاوزه ، إلى قهر الداخل المستسلم المدعي للحرية. إن الرقيب الداخلي قد يكون أعمى وأقسى من كل الرقباء الخارجيين . فالحرية ليست ( قيمة إيجابية في ذاتـهـا ) بشكل مطلق . فحرية الجنون مثلآ تكون تدميرية للذات وللآخرين ، وحرية الطفل لاتضمن أي بناء قادر على الإستمرار بما هو .
إن حرية العملية الإبداعية ، هي التمهيد الضروري لممارسة الحرية إبداعآ بما يميز الكائن البشري بحضور وعيه معها ، في جدل مع ( الآخر ) أبدآ .
==================================
@ هذا البحث المقدم ناتج عن تمثل ثقافة وطروحات ومقالات ومؤلفات العديد من الأساتذه والمفكرين العرب ، إضافة لمقالات سابقة لي ، مع بعضآ من فقرات من كتبي ، ثم إخراجها بالشكل الوارد ، وبالتالي الشكر والفضل يعود إلى هؤلاء المفكرين والكتاب .
----------------------------------------------
فائز البرازي / كاتب سوري
18/5/2005
..............."
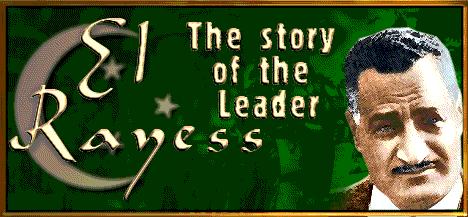 |
الــــرجوع الى الفهـــرس للمتابعة والمواصلة