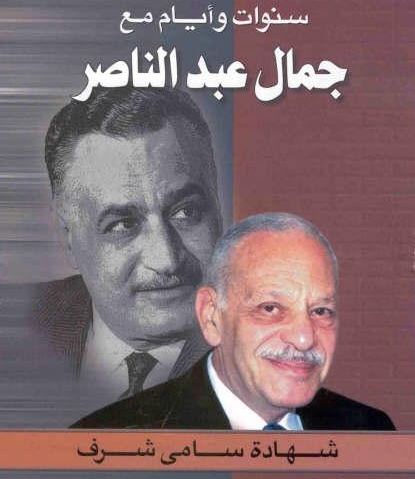 |
من أقلام الأصدقـاء والاضـيوف
نحو تطوير المفهوم القومي
بقلم
فـائز البرازى
نحو تطوير المفهوم القومي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مثلما للمكان تأثيره وعوامله وإنعكاساته على حياة الأمم والشعوب ، فإن للزمان أهمية كبيرة في فرض عوامله ومتغيراته بشكل متصاعد يستمدها من إستمرارية الحياة وتطورها ، وضرورات التغيير والتطوير الناجم عن تدافع بني الإنسان مع بعضهم البعض ، ومع الطبيعة ، ومع الحاجة المولدة للبحث علميآ وإجتماعيآ وإقتصاديآ وسياسيآ .
ولما كانت " اللغة " هي العامل الأساسي في التعبير والتوضيح والحوار والتبليغ ، فإن لكل لغة وسيلتها في ذلك . هذه الوسيلة هي ( المعاني والمفاهيم ) التي تفرض إستخدام كلمات لغوية للتعبير عنها . وهذه المعاني والمفاهيم ماهي إلا إنعكاس لمعطيات الزمان والمكان الذي يتطور فيه البشر ، وبالتالي فإن التطور والتجديد وإكتشاف إنعكاسات جديدة أو متبدلة ، تفرض نفسها في التأثير على تلك المفاهيم والمعاني . وفي معظم الأحيان ليس هناك إمكانية لتغيير " الكلمة " المعبرة عن المضمون أو المعنى ، إلا على مدى طويل من الزمن هذا إذا جاز ذلك أو تمكن منه ، وبالتالي تبقى الإشكالية بأن يكون للكلمة أكثر من مفهوم ومعنى ، هي المسؤولة عن سوء الفهم وعدم تحقيق التقارب ، وخلق الإختلافات في أكثر الأحيان .
ان هناك معاني ومفاهيم ثابتة يعبر عنها " بكلمة / إصطلاح " لا تتغير بتغير المكان والزمان . مثل : الجبل – البحر – النهر الإنسان – الشمس .. الخ . وهناك معاني ومفاهيم تخضع وبكل تأكيد للتغير والتبدل وإختلاف الفهم ومقصد التعبير ، وتبقى الكلمة / الإصطلاح عنها واحدة ولكنها تفهم بأشكال مختلفة ، وتعطي صورآ مختلفة في كل زمان ومكان . منها :
- السماء : ويمكن أن تعني عند البعض قديمآ هذا الغلاف الجوي فقط . وفق معلوماتهم ورؤياهم وإمكانياتهم العقلية . وتعني الآن : الفضاء بأسره ، الغلاف والفضاء الخارجي للكون الفسيح اللامحدود ، وفق المعلومات المتحصلة من التقدم العلمي ومن تطور العقل البشري .
- إبن الله : وكانت تعني حرفيتها وفق المعتقدات المغرقة في القدم والمتلائمة مع أفكار تعدد الآله ، والتي أخذت بعض الأفكار المسيحية تلك " الحرفية " سواء بسبب النقل أو الترجمة أو الإبتكارات الفكرية الإنسانية لأغراض دينية وسياسية . بينما تعني من جهة أخرى : أبناء الله وهم البشر جميعآ ، بإتبار أن الخالق لهم ولسبب وجودهم هو واحد ، هو الله . وبالتالي لاتعني المفهوم الجنسي والبيولوجي .
وهناك كلمات أكثر من أن تعد وتحصى . وهنا يمكن ذكر بعض هذه الكلمات / المصطلحات ذات الدلالات المختلفة وفق المكان والزمان ، ووفق الرؤى المرادة لها :
الحرية – الدولة – الأمة – الديمقراطية – القومية - ... الخ . وفي هذا المقال ، أتناول كلمة(القومية) ومضامينها ومعانيها المتغيرة عبر المكان والزمان ، والتي تقتضي منا جميعآ إعادة إنتاج مضامين ومفاهيم جديدة تتناسب وتتلاءم مع التغيرات الإجتماعية والإقتصادية والسياسية ، وطبيعة العلاقات الإنسانية وإنسجامها مع الواقع ، وإبعادها عن التحجر والتعصب ، للتخلص من إشكاليات لا داعي لها ولا لتناقضاتها مع المعطيات الزمنية والواقعية الراهنة .
مفهوم القومية :
--------------------
( القومية ) مفهوم حديث تاريخيآ بدأ يظهر في العالم منذ أواخر القرن الثامن عشر . ومر المفهوم بمراحل عدة متغيرة حتى اليوم .
وما قبل ذلك وإذا أخذنا جذر القومية العربية تاريخيآ ، نجد أنه مشتق من مفهوم " القوم " . وهم جمع من الناس متجانسين تجمعهم جامعة يقومون عليها . فقوم الرجل : أقاربه ومن في منزلتهم . والقومي : من يؤمن بوجوب معاونته لقومه ومساعدتهم على جلب المنفعة ودفع المضرة . فهي بداية – القومية – " صلة إجتماعية " وجدانية تنشأ من الإشتراك في الوطن والجنس واللغة والمنافع . [ [ مجمع اللغة العربية 2001 ]] .
ومنذ القدم الذي يصعب الوصول إلى تاريخ محدد عنه ، كانت " الهوية " العربية حصيلة تاريخ طويل من التفاعل بين الإنسان العربي وبيئته الجغرافية سواءآ مع الوطن الأول ( جزيرة العرب ) ، أو توسعه نتيجة الهجرات المتوالية عبر الزمان بإتجاه الشام والعراق وشرق أفريقيا وشمالها ، والتي كانت قد حصلت لأسباب عديدة منها : المناخي أو الإقتصادي أو الثقافي . وقد دفعت هذه الهجرات بالعرب للتفاعل مع الأقوام والثقافات التي وجدوها في البلاد التي إستقروا فيها ، مما جعل ومنذ القديم " الثقافة العربية " ذات طبيعة إنسانية منفتحة على الثقافات كافة . وبالتالي فإن الأساس الذي قامت عليه ( الهوية العربية ) هو أساس ثقافي ولغوي وإجتماعي .
وفي مجال الأدلة التاريخية والآثارية ، يؤكد / د. عامر سليمان / عضو المجمع العلمي وأستاذ في كلية الآداب جامعة الموصل ، في ندوة التراث العربي الإسلامي ، على أن : - بتصرف – ( الأقوام الجزرية " العربية القديمة " – نسبة إلى جزيرة العرب – كانت ومنذ الألف الثالث قبل الميلاد على الأقل قد مارست سلسلة من الهجرات من موطنها الأول ، وإنتشرت في الأقاليم المجاورة لها ولا سيما إلى بلاد الشام وبلاد الرافدين ومصر وشرق أفريقيا وشمالها حتى المغرب . وهذا ما إستدل عليه من التحليل بواسطة " الإشعاع الكربوني " لفخاريات من المناطق المختلفة يرقى تاريخ بعضها إلى الألف الخامس قبل الميلاد . وما كتب عليها من لغات ذات أصل عربي يجمعهما جذمان – أصلان – عدنان وقحطان . ومن أهم القبائل المستقرة في الشام والعراق على سبيل المثال : الأزد – خزاعة – لخم – إياد – تغلب – ربيعة ) .
كما أن الدلائل اللغوية تمتد إلى أواخر الألف الرابع قبل الميلاد ، وقبل قيام ( الدولة الأكادية ) بأكثر من ألف ستة في العراق . وأن اللغة الرسمية كانت إلى جانب اللغة السومرية والآرامية والبابلية ، هي اللغة الأكادية ، التي تمثل أحد فروع اللغات الجزرية " العربية القديمة " . وكمثال للتقرب من ذهن القارئ أقول : في دراسة للأساتذه / ألبير فريد نقاش ، وحسني زينة / المتخصصون في التراث اللغوي للمشرق العربي ، قدموا أقدم نص أدبي في العالم وهو : ( أخذة كش ) ، والأخذة بضم الألف وتسكين الخاء وفتح الذال ، تعني " اللقية " أي الرقيم . وكش – بكسر الكاف وتسكين الشين – هي مدينة في العراق . من هذا النص الأكادي المكتوب بالحرف العربي :
( آخذ فاك ش رقت )
ويقرأ في العربية : ( أخذت فاك ذا الرقة ) .
ويوصل بعض الدارسين ، هجرات القبائل العربية إلى شمال العراق – المنطقة الكردية عمومآ – وتزاوجها وإندماجها مع قبائل آرية مهاجرة إلى جبال كردستان الحالية حيث هناك تطابق لغوي تام بين : كلمة " قرد " – المناطق الجبلية – و " الكرد " في لفظ عربي سامي ، لا فارسي ولا كردي . كما أن هناك كثير من المؤرخين ينسبون الأكراد إلى أصل عربي ، إلى: ربيعة بن بكر بن وائل . وجماعة تنسب إلى : مضر بن نزار أولاد كرد بن مرد بن صعصعة ، حتى قيل شعرآ قديمآ :
لعمرك ما الأكراد أبناء فارس ولكنهم أبناء كرد بن عامر .
كل ما سبق ذكره يعزز عامل ( اللغة ) كعامل يدخل في صلب تحديد الإنتماء . إذ ليس هناك أي محاولة حتى الآن لتحديد مفهوم الهوية العربية ، لم تكن اللغة ركنآ أساسيآ فيه .
ويجمع الدارسين والمتخصصين في علم الإجتماع أن أهم عناصر " الإنتما ء" هو التماهي مع ما ينتمي إليه الإنسان . فيكون الإعتزاز والتضامن والتوحد ، وبالتالي المشاركة في الإنجازات والإخفاقات ، والأفراح والأتراح . إنها وحدة المصير والمعاناة . وبالتالي فإن ذلك كله يستند إلى تحديد " إجتماعي " للهوية ، ( يفرض حدودآ من نوع ما ، لكنه لا يفرض حدودآ ثابتة وصارمة لا يمكن تجاوزها أو حتى إعادة رسمها بتغير الأوضاع والأحوال ) ، كما يذكر عالم الإجتماع الفرنسي
/ بيار بورديو / .
كما يطرح / د. خلدون النقيب / إمكانية قيام ( إمتزاج وإستيعاب حضاري لفئات مختلفة متباينة دينيآ ، إثنيآ ، قبليآ ، في نسيج حضاري واحد ذي إمتداد تاريخي بعيد المدى ، وبناء إجتماعي متكامل ) .
وفي " التمازج الحضاري " يشدد / إدوار الخراط / على : ( التنوع في داخل تناسق شامل ، وان هذا التنوع عنصر إثراء ، لا عنصر تشتيت أو تفرقة ) .
وهذا يوصلنا إلى أن جذور القومية العربية هي ( العروبة ) التي تشكل إحساس بالإنتماء إلى كيان مشترك – إجتماعي أو سياسي – واحد يجمعه التمازج واللغة والمصالح والتاريخ ، بصلة إجتماعية وجدانية .
نشوء المفهوم القومي :
-------------------------
إن هناك إختلافات حادة حول ( المفهوم التاريخي للقومية ) . فقد تم تعريف بعض المؤرخين والباحثين مثل : / ايرنست جيلنر / القومية ، على أنها مطابقة لمتطلبات الإقتصاديات التي تعتمد على التصنيع ، ومن ثم فهي مرتبطة بظروف تاريخية محددة . فحتى تكون للدول في القرن التاسع عشر مقدرة على التنافس في الساحة الإقتصادية ، فقد كان يتعين عليها أن تنظم نفسها لتحقيق هذا الهدف، وتخلق " مجتمعآ متجانسآ يطبق نظامآ تعليميآ للجميع " . ومن هذا المنظور تكون القومية قد خدمت أغراض التصنيع الفعال .
بينما آخرين مثل : / هوبزيوم / يؤكدون على جوانب أخرى . حيث يرون أن القومية في بدايتها في النصف الأول من القرن التاسع عشر ، قد قدمت خدمة إيجابية للديمقراطية في سعيها لتحديد الشعوب التي أصبحت ذات سيادة ، غير أن عراها – القومية – في فترة لاحقة من القرن التاسع عشر ، وإتخذت شكلآ عرقيآ ولغويآ محدودآ يوصف بأنه داع إلى الفوضى .
وبكل الأحوال وفي الحالتين السابقتين تحديدآ ، لا تعد القومية ( ذاتية في آلياتها ) ، وإنما تعتمد على التطورات الإقتصادية والسياسية والإجتماعية الأوسع نطاقآ . فالقومية هي " نتاج جانبي للتاريخ وليست من محركاته " وإن كانت هذه المقولة صحيحة من حيث أن القومية هي ناتج للتاريخ ، فإنه وفي أحوال كثيرة يكون هذا الناتج – القومية – هي من بعض محركات التاريخ .
هذا من جانب إستقراء التاريخ والوقائع . أما على الجانب الآخر ، وفي المفهوم " الميتافيزيقي " والمفهوم " السوسيولوجي " ، فيرى / د. نديم البيطار / ان الكيفية التي نحدد بها " هويتنا " تكون مرتكز أساسي في النضال لبناء حياة جديدة وإنسان جديد . وأن هيمنة التحديد الإعتباطي لهو من أكبر الأخطار التي تدمر المستقبل . وأن أكثر المفاهيم للهوية القومية إنتشارآ هو" المفهوم الميتافيزيقي " الذي يحدد شخصية الأمم والشعوب في ضوء جوهر ثابت يضبط إمكاناتها المستقبلية ، ويكشف بالتالي عن وجود إختلاف " انتولوجي " في التركيب النفسي / العقلي الذي يميز بينها . وهو مفهوم يقدم الهويات القومية في إطار تصورات " إستاتية " أو كنماذج مثالية ، وليس " كمجموعة حية " تتميز بإحتمالات تكشف عن ذاتها في عملية تحققها أو كتاريخ يصنع نفسه .
إن " سيكولوجيا الأمم " كانت ترمي في نظر مؤسسيها في القرن التاسع عشر من أمثال : / لازاروس ، و شتاينهال / ، بأن تكون علمآ جديدآ مثمرآ . لكنها في الواقع وكما تكشف التجربة التاريخية ، منهجآ مزورآ خارج العلم ، وذلك بسبب إنطلاقها من هذا " المفهوم الميتافيزيقي " بدلآ من إنطلاقها من ( مفهوم تاريخي ثقافي ) .
ان الهوية القومية هي هوية نسبية وتاريخية يحققها شعب ما عن طريق تفاعله أو علاقته الديالكتيكية مع التاريخ . ولا يرثها من " جوهر " متأصل فيه . إنها إستجابة تتحول مع تحول أوضاعنا الإجتماعية التاريخية ، ونقتبسها عنها ، وليست ردآ طبيعيآ .
إن مفهوم الهوية القومية منتشر جدآ في جميع أعمال المؤرخين والفلاسفة والأدباء وعلماء الإجتماع والأنتروبولوجيا والسيكولوجيا ، أي الذين ينشغلون بدراسة ( السلوك الإنساني ) في أي شكل من أشكاله ، دراسته دراسة موضوعية علمية تشكل ضرورة أولى في إدراك ديناميكية العصر التاريخي ، ليس فقط بسبب إنتشاره ، بل لأن الأمم تشكل في الوقت الحاضر أقوى الأنظمة الإجتماعية التي تحدد " بسياستها ونشاطها مجرى الحركة التاريخية " .
كما أن قضية ( التوحيد السياسي ) تشكل ضرورة تاريخية حضارية أولى بالنسبة لأكثرية البلدان . لأن مقومات العصر تفرض أي مواجهة خلاقة معها ، إتحادات سياسية كبيرة بين مجموعات كبيرة بينها . وتكاثر عدد الدول / القومية ، إقترن ولا يزال بحدة متزايدة في الإنتماءات التي تدور حولها . وهي إنتماءات كانت تزداد إرتباطآ بالظلم والأحقاد والخصومات التي تباعد وتفصل بينها ، بدلآ من التعاون والتفاهم .
ومن هنا نستطيع أن نقول : أن " المفهوم الميتافيزيقي " يحدد شخصية الأمم ، الشعوب ، الثقافات المختلفة بجوهر أو تركيب نفسي / عقلي ُابت ينطلق منه ، بصرف النظر عن الأوضاع الإجتماعية والإقتصادية والتاريخية والفكرية التي تحيط بها ، فيعالج مستقبلها ونمط حياتها وكأن هذه الأوضاع غير موجودة أو من دون أثر مهم في تغيير أو تعديل أو تحويل ذلك التركيب أو الجوهر . لذلك فإن المفهوم الميتافيزيقي يفصل الجوهر عن الوقائع والتحولات الخارجية بدلآ من ربطه بها .
أما ( المفهوم السوسيولوجي ) فعلى نقيض المفهوم الميتافيزيقي . فهو يرى أن الهوية القومية تعني في أحسن الحالات طرق تفكير وشعور وسلوك متماثلة ومهيمنة نسبيآ ، وتتغير مع حركة التاريخ وتحولاتها الجذرية . فالهوية القومية هي نسبية وتاريخية يحققها شعب ما عن طريق تفاعل أو علاقته الديالكتيكية مع التاريخ ، ولا يرثها من تركيب نفسي أو جوهر متأصل فيه – أذكر ذلك مرة أخرى .. للتأكيد - . إنها إستجابات نعانيها عن طريق النشأة الإجتماعية ، وليست ردآ فطريآ غريزيآ .
والفكر الإجتماعي الحديث ، إبتعد في العقود القليلة الماضية عن المفهوم الميتافيزيقي ، وأصبح من المعترف به بشكل عام أن " خصوصيات " أي شعب هي( نتائج عوامل التاريخ الديناميكية ) كإحتكاك الثقافي ، الحروب ، الهجرة ، الإختراعات ، الأزمات ، الصراعات الإجتماعية والسياسية ، التصورات الأيديولوجية .. الخ . هذه العوامل هي التي تحدد هوية الأمة أكثر بكثير من العوامل الأخرى الثابتة كالجغرافيا ، والغريزة ، والطبيعة الإنسانية ، والعرق . إنها الثقافة والحضارة والإندماج . فهذه الهوامل الديناميكية هي عوامل متحولة عبر التاريخ ، وبالتالي فإن مفهوم الهوية تكون هي الأخرى متغيرة ومتحولة . إن هناك " تصورات ومشاعر جماعية " تستقر في اللغة والأنظمة والعادات والقيم .. الخ ، يمكن الرجوع إليها في تحديد هوية الشعوب والأمم . لكن هذا لا يعني أنها " ثابتة " متأصلة في " طبيعة " الشعب أو الأمة .
إن ما سبق يؤيده إلى حد كبير الباحث / جيمس مايول / حيث يصور مسألة الجمع في تعامل البشرية مع القومية من ناحية ، والأحكام التي يسجلها التاريخ من ناحية أخرى فيقول : ( تعتبر القومية في الغرب نقمة .. بينما يعتبرونها في الجنوب نعمة . وتفسير هذا الإختلاف في الإدراك الذي لا يمكن أن يخرج عن الإطار التاريخي . فالقومية تاريخيآ في الحالة الأولى ، مرتبطة بالحروب والدمار والتعصب الأعمى . أما في الثانية ، فهي مرتبطة بالتحرر والتقدم وتفوق الولاءات القومية على التفكك ) .
إنتقال المفهوم السياسي القومي للعرب :
----------------------------------------
لقد نشأ المفهوم القومي العربي المعاصر منذ إنحلال الخلافة الإسلامية وصعود أوروبا . ويذكر عدد من الباحثين أن عصر النهضة العربية بدأ عام 1798 مع غزو نابليون لمصر وبدء المجابهة المباشرة بين الغرب والشرق ، وبمعنى أدق بين الخلافة العثمانية المنهارة ، وبين أوروبا الصناعية والمتطلعة للهيمنة على العالم .
وفي سياق المواجهات الداخلية والخارجية ، أخذ يتشكل عصر النهضة العربية تدريجيآ من خلال مقاومة الهيمنة الأوروبية من جهة ، وبدء إنتشار الثقافة والتعليم الحديث وهو ما ساعد على قيام جمعيات ومنتديات ثقافية وحركات سياسية وإجتماعية متصارعة . وكانت بالمجمل العام ، تطرح أسئلة هامة ساهم الوعي فيها ، ومنها :
· ماهي طبيعة الضعف والخلل في الشرق ، وما مصادر قوة أوروبا ؟
· ماهو الداء وماهو الدواء ؟ وكيف ننهض من كبوتنا ونصلح حياتنا ؟
· ماهو السبيل الأفضل للخروج من حالة الركود والتخلف والجهل ، إلى حالة الحركة والتقدم والوعي ؟
· كيف نتعامل مع الحضارة الغربية ؟ وهل نقبل عليها ، أم نرفضها كليآ أو جزئيآ ؟ وكيف يكون الإقتباس من الغرب من دون التخلي عن الأصالة ؟
· هل نحدد " هويتنا " على أساس ديني أم عرقي أم قومي علماني أم طبقي ؟
· هل نصلح المجتمع بالدين أم بالعلم ؟ وكيف نحرر أنفسنا من النظام الإستبدادي ونقيم نظامآ بديلآ يتجاوب مع الشعب ويمثل إرادته ويستند إلى قانون يتساوى أمامه المواطنون كافة من دون تمييز وبصرف النظر عن الإنتماءات المتعددة ؟
· كيف نحقق العدالة الإجتماعية ؟ وما هي العلاقة المطلوبة بين الحاكم والمحكوم ؟
أسئلة كثيرة بدأت تطرح وتثير نقاشات حادة ، وتكونت بمرور الوقت ثلاثة تيارات فكرية واضحة المعالم ، وهي :
1- التيار الديني : المنقسم بدوره بين المحافظة والإصلاح .
2- تيار التحديث الليبرالي : الذي شدد على الأفكار القومية كبديل للخلافة ، والعلمانية كبديل للدمج بين الدين والدولة ، والعقلانية النسبية ، كبديل للإيمان المطلق واليقينيات ، والتحرر الإجتماعي والثقافي ، كبديل للإمتثال التقليدي .
3- التيار النقدي الثوري : الذي يلتقي مع الفكر التحديثي الليبرالي من حيث الميل للتنظير القومي والعلماني والعقلاني والتحرري . إنما ذهب أبعد من ذلك فإهتم بالتحول الثوري في بنية العلاقات التقليدية والمؤسسات والنظم السائدة ، بإتجاه التأكيد على أهمية مقولات العدالة الإجتماعية للتخفيف من حدة الفوارق الطبقية .
ومع مرحلة الصراع في سبيل الإستقلال بين الحربين العالميتين الأولى والثانية ، صعدت ( الفكرة القومية ) . فمع إنتهاء الحرب العالمية الأولى وإنهيار الخلافة العثمانية ، وجد العرب أنفسهم رازحون تحت هيمنة الإستعمار البريطاني والفرنسي ، ولم يخفف من وطأة هذه الهيمنة ، كون أوروبا أكثر تقدمآ وذات أنظمة ليبرالية ديمقراطية في " مجتمعاتها " ، مقارنة مع الحكم العثماني ، بل على العكس تمامآ . إذ أدرك العرب أن الإستعمار الأوروبي سيكون أكثر ضررآ وتحكمآ وشراسة وإمعانآ في تجزئة الوطن العربي وإستغلال موارده وطاقاته الطبيعية والبشرية .
وتحقق تخوف العرب وتوقعاتهم مع مؤامرة سايكس – بيكو ووعد بلفور وظهور تحقق هيمنة أوروبا بسبب مصالحها ولا أخلاقياتها وبإستفادتها من تقدمها العلمي ، لقهر الشعوب وتمزيقها وإستغلال مواردها ، بحيث أن الخراب والضرر الذي أحدثه الغرب في الوطن العربي منذ ذلك الوقت وحتى الآن ، سيكون من الصعب جدآ تجاوزه .
ونتيجة لهذه التطورات وإتساع قاعدة الطبقة الوسطى ، وإنتشار التعليم ، تعزز التيار القومي وكان تحديثيآ على الصعيد الفكري ، ونشأت صراعات فكرية وإنتظمت القوى في أحزاب وحركات سياسية تصارع لتحقيق التحرير والتحرر ، كلآ حسب مفهومه وأفكاره . وكانت تلك الصراعات الفكرية أكثر تجليآ بين : التيار الديني ، وبين التيار القومي التحديثي . ومن ثم نشأ التفاعل بين : التيار القومي التحديثي ، وبين التيار التقدمي الإشتراكي .
نشوء الدولة / الأمة ، وإرتباط مفهوم القومية بالدولة :
---------------------------------------------------------
على الرغم من أن معاهدة ( ويستفاليا 1648 ) تعتبر نقطة إنطلاق " نظام الدولة ذات السيادة " ، فإن " الأيديولوجية القومية " أدخلت تعديلآ هامآ بعد مضي 150 سنة تقريبآ . وبعد ذلك لم يكن يكفي أن ترتكز السياسة الدولية حول دول ذات سيادة . إذ إعتقد القوميون أنه يتعين أن تكون هذه الدول ذات سيادة دول / أمم ، إذا كان لها أن تكون شرعية حقآ . ومع ذلك وعلى الرغم من أنه لا يوجد في العالم سوى 190 دولة عام 2000 ، فإن هناك مابين : 3000 – 5000 أمة ، و 575 دولة / أمة محتملة . وبالتالي يكمن في النظام السياسي العالمي إحتمال كبير بنشوب نزاع قومي – إثني .
إن إكتساب كيان " الدولة " يحظى بشعبية أكبر ، ويتم السعي إليها أكثر من أي وقت مضى . لكن هذا يثير أسئلة هامة بشأن الطبيعة المتغيرة لكل من الدول وكيان الدولة بشكل أعم . ويمكن طرح ثلاثة أسئلة رئيسية تثير جميعها خلافآ حادآ :
الأول :- ماهو تعريف الدولة ، من حيث سماتها التكوينية .
الثاني :- ماهي أغراض الدولة ، أي الغرض من وجود الدولة .
الثالث :- ما مقدار أهمية الدولة بالنسبة لفاعلين آخرين في السياسة العالمية .
وبالنسبة للسؤال الأول : فيؤكد المعتقد التقليدي المقبول ، أن للدولة خصائص مشتركة أهمها : الأرض – حكومة ذات سيادة – مواطنون من السكان . وتشكل هذه " تنظيم " كيان الدولة . ولكن بالشكل العام ، هذا التعريف القانوني الحرفي ليس شاملآ أو مرضيآ كثيرآ . فهناك العديد من الدول لاتتوفر فيها هذه الخصائص بالكامل . وفي نفس الوقت يجادل البعض بأن التعريف غير كامل من دون ذكر " سمات " أخرى لكيان الدولة مثل : ثقافة مشتركة – إحساس بالهوية الوطنية – مستوى أدنى من الإستقرار السياسي – وقليلآ من الرفاه الإجتماعي والإقتصادي .
وبالنسبة للسؤال الثاني : ماهو الغرض من وجود الدولة ؟ فالرأي هنا منقسم على نحو خاص في قائمة أبعد من أن تكون شاملة . فمثلآ حدد / مارفن فروست / أربعة مذاهب فكرية منفصلة يمكن من خلالها تصور مبعث نشوء الدول : تعزيز النظام الدولي – بقاؤها مع ما ينتج عن ذلك من تشديد على الأمن – حماية شكل معين من الحكم السياسي – الدفاع عن مصالح الطبقة المسيطرة . وعلى رغم إختلافات هذه المقاربات الأربعة ، فإنها تشترك في عامل حاسم ، وهو أن الدولة هامة بوصفها آلية مجهزة لتحقيق أهداف معينة ، وأنها عقلانية قوية ومتفوقة .
أما عن السؤال الثالث : ما مدى أهمية الدولة ؟ فلا يوجد حتى الآن جواب سهل موحد . غير أن هناك من يطرح أن الدولة تتمتع بسيادة مطلقة غير مقيدة . فهي تتفاعل مع فاعلين آخرين في علاقات لاتعد ولا تحصى . وهذا يمكن أن يؤكد سيطرة الدولة بالنسبة لقضايا معينة ، لكن بالنسبة لقضايا أخرى فإن دور الدولة أقل بكثير .
ونيجة لهكذا إجابات ، فإن " الدولة " مفهوم موضع خلاف . إذ أن مغزاه ذاته ، وغرضه ، هما موضع نزاع ، ولا يظهر سوى نزر يسير من التقارب في توافق الآراء ، مما يجعل إستقصاء طبيعة كيان الدولة إشكاليآ على نحو خاص .
وفي العموم : فإن الدول رغم " شدة تنوعها " ، فإنها تملك بالمجمل العام خصائص : الأرض – الحكومة ذات السيادة – الشعب . وكلها خصائص هامة . إلا أن خاصية ( السيادة ) حكومة ذات سيادة ، تعني عدم وجود أي سلطة أعلى من الدولة في الشؤون الداخلية والخارجية على السواء . فهي تضمن ( مصدر حيوية الدولة ) . وتوفر ضمانات بالمساواة الرسمية والإستقلال السياسي ، وتوفر إمكانية الوصول إلى الموارد والعلاقات ، وهي كيان لا يضاهى .
لكن ومنذ إبتداء النظام الدولي للدول ( معاهدة ويستفاليا ) ، كانت هذه السمات ولأسباب كثيرة ، موضع إنتهاك مستمر . " فالنزعة الإقليمية " المتميزة بمنطقة جغرافية ما والتي هي مسؤولية دولة واحدة فقط ، تتضمن في ذاتها ناحية تاريخية كانت فيها " الأرض " مصدر نزاع شرس . وحتى عندما لاتكون " وحدة الأراضي " موضع تحد ، فيمكن أن يبرز نوع من التعدي على الوضع الإقليمي بأساليب أخرى ، مثل الخلاف على الحدود الجغرافية المشتركة . وبالتالي فإن إنتهاكات الوضع الإقليمي هو " خرق للسيادة " إضافة إلى أمور أخرى مثل : الفرض – التفويض – التعدي ، وكلها إختراقات لسيادة الدولة .
أما بالنسبة للسمة الثالثة وهي التي تهمنا هنا .. " سمة الشعب / السكان " . فإن التقييد ضروري هنا أيضآ مثل السيادة . إذ لايمكن القول أن ( الدول هي بلا شعوب تحكمها ) . إن الفرار من الدولة التي تؤوي الشعوب هي " أعمق " مشكلة ، خاصة عندما تكون الدولة ذات جماعات متعددة الأعراق ، ويظهر فيها إحساسآ ضعيفآ بالهوية الوطنية التي تطغى على جميع الإعتبارات . وهنا تعتبر الأقلية الإثنية ( المتقوقعة ) والغير مؤهلة ( للإندماج ) لأسباب مختلفة ، أنها أقل قدرآ من غيرها داخل الكيان السياسي الواحد . وفي معظم الحالات ينشأ الصراع من هنا .
الصراع القومي والإثني :
------------------------
إن مفهوم ( الدولة / الأمة ) الحديث ، يعتمد على إندماج مكوناتها في أربعة عناصر :
1- المشاركة السياسية لكل مكونات المجتمع في مؤسسات الدولة .
2- المشاركة الإقتصادية ، مع توزيع عادل للثروة بين مجمل مناطق الدولة ، وإتاحة الفرص العادلة لجميع المواطنين ضمن هذا الكيان السياسي / الدولة .
3- المشاركة الثقافية وإحترام جميع الأديان والمذاهب والشعائر واللغات .
4- المشاركة في إدارة الدولة وأجهزتها بدون إبعاد لفئة أو عنصر من عناصر الأمة .
إن تحقيق تلك المشاركات ، سيتيح " إندماج " جميع أفراد نسيج المجتمع في هذه الأمة ، بغض النظر عن : اللون – الجنس – الدين – القومية . ويحقق مفهوم المواطنة الحقيقية وتقوية الإحساس
( بالهوية الوطنية ) .
وخلال المسار التاريخي ، ومنذ بداية ( عصر القومية ) نهاية القرن الثامن عشر ، حصلت توترات بين مفهومي ( الدولة ) و ( الأمة ) . حيث لا تتطابق الحدود السياسية للدولة ، مع الحدود الثقافية للأمة ، كما هو الحال مع الغالبية العظمى لما يسمى دول / الأمم ، فينشأ إحتكاك بين " مبادئ وحدة الأراضي الإقليمية " ، وبين " حقوق الأقليات الإثنية والدينية واللغوية " . وقد زادت حدة هذا الإحتكاك مع نهاية الحرب الباردة .
ولا بد هنا من التطرق لمفهوم / هاتشنون ، و سمث – 1991 / في توضيح التميز بين الإثنية والقومية . إذ يعتبران أن : ( الإثنية هي طريقة تفكير بشأن العالم يتجلى طوال التاريخ المدون . وهي
- الإثنية – تستند إلى المشاعر التي تربطنا بمن يشتركون معنا في ثقافة واحدة ، ويتعدى إدراك الجماعة للإختلاف عن غيرها ، مستندة إلى " أسطورة " تتعلق بالمنبت الواحد والتاريخ المشترك والإحساس بالتضامن والإرتباط بأرض معينة ) .
بينما من ناحية أخرى : ( فالقومية هي فكرة حديثة ، وصنف مميز جدآ من الوطنية ، ولا تصبح منتشرة أو مسيطرة إلا في ظروف إجتماعية معينة ، وهي تسود في واقع العالم الحديث
إن جوهر مبدأ القومية يقوم على أساس المجموعة التالية من الإفتراضات :
فالعالم مقسم إلى أمم ، والأمة هي مصدر كل القوة السياسية والإجتماعية ، والولاء للأمة يفوق جميع الولاءات الأخرى ، ويجب أن تتماهى الكائنات البشرية مع أمة إذا شاءت أن تكون حرة وتحقق ذاتها ، ويجب أن تكون الأمم حرة وآمنة إذا كان للسلام والعدالة أن يسودا العالم ) .
على أنه مما سبق نرى أن العلاقة بين الإثنية والقومية معقدة جدآ ، بخاصة أن الكثير منا يحملون على ما يبدوا " هويات متعددة " . ولا تبدأ هذه العلاقة بإتخاذ أسباب العنف ، إلا عند توافر عوامل مثل : التضمين ، الإستبعاد السياسي ، التقوقع ، عدم الإندماج ، الظلم الإجتماعي ، زعزعة الأمل وعدم إحترام الإختلاف الثقافي . وتؤثر هذه النزاعات في السياسة العالمية بعدة طرق : فهناك مشكلة كيفية الرد على الحركات الإنفصالية ، وكيفية الحفاظ على حقوق الإنسان من الإنتهاكات بسبب النزعات الإثنية ، ومشكلة تجزء العالم وتفتته في ظل عدم حل هذا الصراع ، خاصة أنه مع نهاية الحرب الباردة إزداد النزاع الإثني في العالم وباتت الأسرة الدولية تدرك أن النزاعات التي كان ينظر إليها على أنها نزاعات بين النظام الرأسمالي وبين النظام الإجتماعي الماركسي ، إنما هي نزاعات إثنية في جوهرها .
فالصراع بين الإثنية والقومية يشكل تحديآ رئيسيآ لوحدة أراضي دول معينة ، أو حتى لبقائها . كما أنها تحدي جوهري لنظام الدولة ذات السيادة في كليته . فالدولة هامة للأمة ، وهي دلالة على القيمة الذاتية ، وتسمح للأمة بأن يكون لها دور أقوى في حماية مصالحها وثقافتها . وما دامت ( الدولة ذات السيادة ) ، هي وحدة التنظيم الرئيسية في السياسة العالمية ، فإن العامل المحدد الأساسي للنزاع الإثني ، سيكّون السياسات التي تتبناها فرادى الدول للوصول إلى الحكم الجيد والرشيد في المجتمعات متعددة الإثنيات .
وعلى مستوى الوطن العربي : فإن مشكلة الأقليات إثنية كانت أو دينية ، تنبع من ( السلطة ) بشكل عام وبدرجة كبيرة . فلا الدين الإسلامي ولا المجتمع العربي منبع هذا التمايز . وفي كثير من الأحيان يصل " الإندماج " بين الأقليات والأكثرية حدآ متميزآ لعلاقة متينة من المحبة والإلتصاق والتعامل التجاري والمادي والإحتفالات بمناسبات وأعياد الأطراف في نسيج الوطن الواحد ، ويأخذ شكلآ مشتركآ واحدآ ، حيث لم تكن الإثنيات والأقليات مسببة لأي مشكل للوطنية والقومية . ونستطيع أن نميز أسباب بروز المشكلة في الوطن العربي الآن بإرتباطها بعوامل رئيسية :
1- السلطة : والإستبدادية ، وضعف مفهوم المواطنة بشكل عام .
2- التزمت : الخارج بدون معايير عقلية أو موضوعية ، بل نفسية من الطرفين .
3- العامل الخارجي : المساعد والراغب بإذكاء هذا الصراع لمصالح خاصة به .
القومية مقابل العولمة :
------------------------
مع ظهور " العولمة " منذ أواخر القرن العشرين ، وتنامي مفهومها وطروحاتها المستمرة في القرن الواحد والعشرين ، نشأت خلافات حادة بشأن ( المعنى التاريخي للقومية ) . فقد عرف بعض الكتاب مثل : / ايرنست جيلنر / القومية ، على أنها مطابقة لمتطلبات الإقتصاديات التي تعتمد على التصنيع ، ومن ثم فهي مرتبطة بظروف تاريخية محددة . وليكون للدول مقدرة على التنافس في الساحة الإقتصادية ، فقد كان يتعين عليها أن تنظم نفسها لتحقيق هذا الهدف وتخلق " مجتمعآ متجانسآ يطبق نظامآ تعليميآ للجميع " . أما / هوبزيوم / فيؤكد على جوانب أخرى .. في سعيها لتحديد الشعوب التي أصبحت ذات سيادة ، غير أن عراها تفككت وأخذت شكلآ عرقيآ ولغويآ محدودآ يصفه بأنه دافع للفوضى . – وهذا ما ذكرته سابقآ - .
وفي الرأيين السابقين تطرح القومية بأنها تعتمد على التطورات الإقتصادية والسياسية الواسعة ، وهي ليست – القومية – ذاتية في آلياتها . فالقومية ( نتاج جانبي للتاريخ وليست من محركاته ) . وإن كنت أعتقد أن هكذا حكم ليس مطلقآ ، بل نجد أحيانآ أن " القومية " هي محرك وفاعل أساسي في التاريخ من خلال فعل ودوافع " القوميين " – الناس - ، فالتاريخ لا يصنع نفسه بنفسه بشكل مجرد عن كل المحيطات الفاعلة بجدلية كونية تساهم في صنع التاريخ .
وعمومآ .. توضع العولمة والتفكك متقابلين . فيقال أن التفكك رد جدلي على العولمة ، وليس أثرآ من آثار الماضي التي يمكن أن تنبعث من جديد . وكلما إشتدت العولمة ، أصبحت الجيوب المقاومة لها ولنفوذها الطاغي أكثر ضراوة .
ويوضح / سميث / رأيه حول هذه الفكرة : [ نجد أنفسنا في حقبة العولمة وتخطي الحدود ، وأسرى دوامة الصراعات حول الهوية السياسية والتفكك العرقي .. كيف يمكن تفسير هذه المفارقة ؟ هل هي نتاج حتمي لجدلية عولمة ثقافية ينتج عنها نوع جديد من السياسات المعنية بالهوية ؟ أم أنها مجرد عملية إحياء لعصر ولى من عصور الكراهية والحروب القومية ؟ ] .
ولا شك أن هناك الكثير من الحجج التي تساق لتربط ربطآ صريحآ بين التفكك والعولمة معتبرة أن التفكك هو رد الفعل الجدلي للعولمة . ومن أبلغ العبارات حول ذلك : [ أن العولمة تحفز قوى المعارضة التي قد تؤدي بالسرعة نفسها ، إلى خلق عالم متفكك ، يزداد تفككه يومآ بعد يوم ]- ماك غرو : 1992 - . ويشرح / هاسنر – 1993 / هذه العلاقة ، في ضوء الحاجة النفسية الإجتماعية العميقة إلى التمايز ، بأنه عند مواجهة ( التأثير القوي المؤدي إلى التجانس ) في العالم المعاصر ، تزداد الحاجة إلى ( التنوع والفرز ) .
ونستطيع أن نعتبر / أنتوني سميث / من أشد المؤيدين صراحة للفكرة التي تذهب إلى أن القومية لها تاريخها المستقل ، وليست إفرازآ للنظام الرأسمالي ، ولا لمسار العلاقات الدولية ، ولا للعولمة أيضآ . وفي الوقت الذي يرفض فيه / سميث / الأصداء الهائلة للحداثة والعولمة ، يتمسك بوجهة النظر التي تنص على أن مفتاح فهم القومية [ يكمن في الأطر الدائمة للثقافات التاريخية وتراثها ، والروابط العرقية أكثر مما يكمن في النتائج التي تفرزها العلاقات الدولية المتشابكة ] . كما أنه يرفض فكرة أن الثقافات العالمية الناشئة قد تحل محل الثقافات القائمة حاليآ ، كما أن فكرة " الذاكرة الجماعية " تعد فكرة محورية في مفهومه للثقافة . وبما أنه يتعذر وجود مثل هذه " الذاكرة العالمية " ، فإن النتيجة الحتمية هي أن تكون الصور المفترضة لأي " ثقافة عولمية " ليست إلا إختلاقآ من صنع الخيال . إنها [ ثقافة عالمية غير محدودة بزمان ، ولا تلبي أي إحتياجات حياتية كما لا تستحضر في الذهن أي ذكريات . فإذا كانت الذاكرة أمرآ لا تتحقق من دونه الهوية ، فيمكننا القول : اننا مقبلون على مرحلة إنعدام الهوية العالمية ] .
وهذا يدخلنا في مفهوم ( الثقافة ) كمحور يدور حوله كثير من التفسيرات الإجتماعية للعولمة . حيث يطرح أن العولمة تتضمن " تطوير نوع من الثقافة العالمية " ، وأن هناك أيضآ وجود وعي عالمي جديد . لكن ذلك لايعني بالضرورة أن تكون الثقافة " متجانسة " وموحدة في كل بقاع العالم . وإنما يعني أن الثقافات ستكون " نسبية فيما بينها وليست موحدة أو مركزية " .
ويتعارض هذا المفهوم للثقافة مع مفهوم ( كينونة الدولة ) . لأن الثقافة تأبى أن تكون محصورة بموقع جغرافي أو مقيدة بمكان مادي محدود . وفي الوقت نفسه ، فإن من المفارقات أن ( القومية ) هي عنصر من عناصر الثقافة إنتشر وشاع في سائر أنحاء العالم . ومثل هذه المفاهيم تنطوي على العديد من الإشكاليات ، حيث يرى كثيرون من الكتاب والمفكرين أن هناك شك في جدوى ( مفهوم الثقافة ) بمعزل عن مجتمع بعينه يسهل تحديده .
ومن إعادة طرح علاقات التوتر بين القومية والعولمة ، فإن التوتر بين ( البنية التحتية لنظام إجتماعي عالمي ) ، وبين ( عالم الدول القومية ذات السيادة ) ، فبالنسبة لكثيرين يمكن تبين هذا التوتر في الأنماط المتغيرة للهوية ، في وقت لم يعد للدولة فيه أي سيطرة أو إحتكار على ولاء الفرد فيها . والنتيجة هي : [ أن العولمة والتفكك يحدثان تحولات بطبيعة المجتمع السياسي في أرجاء العالم كافة ] . ويمكن أن يعطى وبصورة عامة منظورآ للعولمة يتبين من خلال التالي :
1- ان العولمة لا تكون مفهومآ صحيحآ إلا إذا إعتبرناها معبرة عن " مرحلة جديدة ومتميزة في السياسة العالمية " .
2- ان هناك مفهوم للعولمة يغلب عليه " الطابع الإقتصادي " . مؤداه أن العولمة عبارة عن تحول نوعي عن إقتصاد دولي ." فالإقتصاد المدول" هو إقتصاد فيه " الإقتصاديات القومية " المنفصلة هي المسيطرة رغم إتساع النشاط بين الدول . أما في " الإقتصاد المعولم " فإن الإقتصاديات القومية المختلفة تصبح جزءآ من النظام بواسطة عمليات أو تعاملات دولية .
3- وإذا كان للعولمة من وجود فعلي حقآ ، فإن أقل ما يمكن أن يقال : أنه من المتعارف عليه أن جزءآ كبيرآ من المشكلة المطروحة عند تناول منهجي للعولمة ، هو في إعتبار العولمة عملية متعددة الأوجه بشكل حتمي ، هو في إعتبار العولمة عملية متعددة الأوجه بشكل حتمي ، بإعتبار أن العولمة مركبة من أربعة عناصر : التغيرات التقنية – خلق إقتصاد عالمي- العولمة السياسية – عولمة الأفكار .
وفي محاولة لفهم أكثر حول تأثير " العولمة .. الكوكبة .. الكونية " على العالم وعلى الدول وعلى القوميات وعلى المجتمعات ، فإنه يجب التوضيح والتأكيد على ناتج التحولات المسببة والمرافقة للعولمة ، هو في أساسياته متمثل في إنتقال أوروبا وأمريكا الشمالية من عصر الحداثة إلى عصر ما بعد الحداثة بلغة الفكر الفلسفي . بينما إنتقلت بلدان بقية العالم من مرحلة الإندماج في الإقتصاديات الدولية ، إلى مرحلة التبعية الكلية . وما يقال عن تحول العالم بفعل العولمة إلى " قرية صغيرة " ، وحلول السوق مكان الوطن ، هو قول غير صحيح على الإطلاق . فالعالم في واقع الحال لم يتجول إلى أسرة دولية واحدة تجمعها مصالح ومطامح واحدة وإحترام متبادل ، بل لا زال العالم يعيش التناقضات والصراعات التي تسود العلاقات بين الأمم . بل تعززت بعد أن تعمقت حدة الإنقسام بين مجتمعات متخلفة ومنها الوطن العربي ، وبين مجتمعات متقدمة تعيش عصر ما بعد الحداثة إن لم يكن عصرآ متقدمآ للحداثة فقط .
إن ما أدت إليه " العولمة " ليس تحقيق التماسك والتعاون والتكافل بين الدول والشعوب في سبيل الخير الإنساني العام . بل أدت إلى ظهور أداة فعالة جديدة تسعى لترسيخ هيمنة من يسيطرون على نظام الإقتصاد العالمي ، ويملكون وسائل الإنتاج التكنولوجي المتقدمة . ويرافق كل هذا تفتيت داخلي في المجتمعات الضعيفة . إن ما يسمى خطأ " بالقرية الصغيرة " ليس سوى هيمنة أمريكية ساحقة تفرض على العالم الإندماج الكلي في النظام الرأسمالي الحر . مما جرد الدول المتخلفة والمستهلكة من قدراتها على التحكم بمصيرها وسيادتها على مواردها الطبيعية والإنسانية . فتوزعت بين : دول خاضعة أو محاصرة ومنبوذه ومعرضة للتفتت المتعمد .
ومما رافق " إنتشار العولمة " ، تعزيز العلاقات والصراعات العرقية في الدول النامية وتفسخها إلى دول صغيرة لا شأن لها . وبقدر ما تتماسك وتتمسك الدول القوية بمناعتها وتلاحمها الداخلي ، تفقد الدول الضعيفة الكثير من قدرتها على مقاومة التجزئة . فتسعى كل فئة لتعزيز مواقعها على حساب الفئات الأخرى ، وعلى حساب المجتمع ، وعلى حساب الدولة . وما نشاهده من بدايات لتفتيت المجتمع العربي ، لا ينفصل عن تفتت المجتمعات القطرية .
إن للعولمة " وجهآ مظلمآ " فمن بين نتائجها السلبية أن المجتمعات الضعيفة تفقد ( سيادتها القومية ) وخصوصياتها الثقافية ، وتصبح معرضة لمختلف التقلبات وخاصة الإقتصادية منها . والتي تفاقم الوضع بظهور طبقة جديدة يمكن تسميتها " بالطبقة العالمية " التي تتشكل من النخب الإقتصادية الناشطة في إطار الشركات العالمية العابرة للقارات ، وبإستقلال عن البلدان التي تعمل فيها فتهتم بمصالحها الخاصة سواء تناقضت مع مصالح بلدانها أم لم تتناقض . وبالتالي فإن ذلك يفرز تحولات في ولاءات النخب الإقتصادية ، ومن دون إعتداد يذكر بالإنتماءات وبالحدود السياسية للدول ذات السيادة . وبالتالي ففي ظل العولمة تفقد دول العالم الثالث كل أهمية إستراتيجية ، ولا تعود لملكية الموارد الطبيعية أهميتها ، وتفشل التنمية في تحقيق ما سعت إليه في معظم دول الجنوب ، وتبدأ الشركات " الكوكبية " تفرض وجهة نظرها في التعامل مع مختلف الدول النامية .
وبإستمرار الوضع على ما هو عليه في المستقبل ، فستتفكك ( الدولة ) وتزول ، ليحل محلها ( (الشركات العابرة للقارات ) لتكون هي القائدة وصاحبة السيادة على الفرد وعلى المجتمع . ولقد وصفت الكاتبة الشهيرة / نادين غورديمير / العولمة ، بقولها : ( ان العولمة هي عولمة للفقر والحرمان الثقافي والأمية ) .
نحو رؤية جديدة للمفهوم القومي :
------------------------------------
ان الفكر القومي العربي يعيش مرحلة من مراحل الضعف والتشتت والتشكيك لم يشهدها ، ويخوض صراعآ مريرآ على جبهتين في الوقت ذاته :
الأولى : صراع الأقليات والإثنيات - صراع التفكك .
الثانية : صراع مع العولمة والهيمنة - صراع الدمج القصري .
وبالتالي فلا بد له من أن يجابه كلتا الحالتان ومعآ . ولن تتأطر تلك المجابهة وتتعقلن إلا من خلال تجدده وتطوره ، وتجديد مفاهيمه وتطوير آلياته .
فالمفهوم القومي عمومآ ، ومنه الفكر القومي العربي ، مر بمراحل متعددة كانت ذات طابع إجتماعي –عرقي – سياسي إقتصادي . وكل حسب المرحلة والظروف المكانية والزمانية ، ومتطلبات الشعوب والدول . فهل يمكن لمفهوم القومية العربية ( التي لم تعد بحاجة لإثبات / د. جمال الأتاسي ) أن يستند الآن إلى مضمون (المواطنة والديمقراطية ) التي تشمل المفاهيم الإجتماعية والإقتصادية والسياسية في الدولة الحديثة ؟ .. ثم كيف يمكننا أن نفهم ذلك وننقله من الوعي الثقافي الفكري ، إلى أرض الفعل والواقع السياسي حيث أن الثقافة والوعي لا ينفصل عن السياسة ، وإن كانا ليسا شيئآ واحدآ . ثم ما هي الآليات التي لابد من أن تسود وتكون الحامل والمنفذ لتجسيد الفكر القومي في التحديات التي يواجهها ؟ مع التأكيد على أن ما هو " مقدس " في المواطنة أو الديمقراطية أو الهوية ، هو ( القيم ) وليست الآليات . أسئلة كبيرة وصعبة ، والأجوبة العقلانية والعلمية بحاجة إلى جهود كل المفكرين والمثقفين والسياسيين في جدل وحوار بناء متطور .
وفي العموم .. فإن المواطنة والهوية ، هي بداية الإنطلاق ..
المواطنة والهوية :
---------------------
إن الإندماج الإجتماعي والسياسي ، يسعى فيما يسعى إليه ،ترسيخ الهوية العربية . ولكن ذلك لايعني في أية صورة إلغاء التعددية والتنوع في الإنتماءات الخاصة أو الحد منها . وليس القصد أيضآ التذويب والصهر في بوتقة واحدة ذات بعد واحد ، ولا فرض ثقافة الأكثرية على الأقليات أو العكس . إن القصد هو التكامل وتعزيز الهوية المشتركة من دون التعرض للتنوع والتعدد كمصدرين من مصادر إغناء المجتمع والثقافة . فالحضارة العربية تآلف حضارات متنوعة قديمة وحديثة تداخلت وتفاعلت وتغيرت كما غيرت عبر تاريخ طويل . لكن هذا التآلف ليس واحدآ في مختلف المناطق العربية ، بل نسبيآ .
وإن كانت مسألة " غير المسلمين " في المجتمع الإسلامي قد ظلت واحدة من المسائل التي تلح على الفكر الإجتماعي للمفكرين المسلمين في العصر الحديث وتتحدى الأصول التقليدية ، منطلقة من قاعدة المساواة على قدم " المواطنة " ، فإن مسألة " غير العرب " في المجتمع العربي كانت أكثر حدة بسبب غلبة صيغة المجتمع العربي من ناحية عملية متجسدة على أرض الواقع . وعمومآ فليس ثمة معالجات قومية معمقة لموضوع الأقليات تناسب حساسيتها وأهميتها في المجتمع العربي . وهذا ما لاحظه / السيد ياسين / في تحليله " لمضمون الفكر القومي العربي " فقال : ( ان التعبير عن الموقف من الأقليات كان محدودآ ) . فموقف الفكر القومي العربي من الأقليات الغير عربية في الوطن العربي ، يرتبط بالنظرة إلى موضوع ( المواطنة ) نظرآ للإرتباط الوثيق بين مدى مساواة أفراد هذه الأقليات ، مع الأغلبية بمبدأ المواطنة والتساوي أمام الدولة والقانون . وهذه النظرة الموضوعية لمشكلة الأقليات والمواطنة ، تواجه أحيانآ دعوات غير مفهومة لإستخدام القوة لحل مشكلة الإستعصاء على الإندماج القومي ، كما دعوة / ياسين الحافظ / الذي يقول : ( الطوباويون الحالمون هم الذين يعتقدون أن التقدم الثقافي والتطور الأيديولوجي الإجتماعي ، يحلان وحدهما مشكلة الإندماج القومي ومشكلة الأقليات . والواقع أنه لابد من قدر مناسب من القوة لإستئصال الرواسب التاريخية العميقة الجذور النابعة من المركز والمعارضة لبناء دولة قومية ، لدى الأقلية ) . – من كتابه : في المسألة القومية الديمقراطية - .
وفي موضوع المواطنة ، ثمة شرطين لابد من وجودهما لضمان مبدأ المواطنة وتطبيقه ، وهما :
الأول : زوال مظاهر حكم الفرد أو القلة من الناس ، ونحرير الدولة من التبعية للحكام ، بإعتبار الشعب مصدرآ للسلطات وفق شرعية دستور ديمقراطي ، ومن خلال ضمانات مبادئه ومؤسساته وآلياته الديمقراطية على أرض الواقع .
الثاني : إعتبار جميع السكان الذين يتمتعون بجنسية الدولة ، أو الذين لايحوزون على جنسية دولة أخرى " البدون " المقيمين على أرض الدولة وليس لهم في الحقيقة غيرها ، مواطنين متساوين في الحقوق والواجبات يتمتع كل فرد منهم بحقوق وإلتزامات مدنية وقانونية متساوية ، كما تتوفر ضمانات وإمكانيات ممارسة كل مواطن لحق المشاركة السياسية الفعالة وتولي المناصب العامة . [ علي خليفة الكواري – مفهوم المواطنة في الدولة الديمقراطية / 2000 ] .
ونادرآ ما نجد معالجة عميقة مباشرة لمبدأ المواطنة في ( الفكر القومي للمؤسسين الأوائل ) العرب وهذا يعود بالدرجة الأولى إلى الإستغراق التام الذي إستحوذ على رعيل القوميين الأوائل في مسألة بعث الهوية العربية . فإستقراء إهتمامات الجيل الأول من القوميين أمثال : عبد الحميد الزهراوي ، رفيق العظم ، صلاح الدين القاسمي ، نجيب عازوري ، عبد الغني العريسي ، عمر فاخوري ، وغيرهم ، يشير بوضوح إلى أن إنهماك أولئك الرواد كان منصرفآ إلى قضايا بعث يقظة عربية مشتركة ، والدفاع عن هوية جامعة للعرب ، وصياغة العلاقة بين العروبة والإسلام ، وفصلها عن العلاقة مابين العرب والعثمانيين . وفيما بعد .. إستحوذ على المعلم القومي / ساطع الحصري / هم تأسيس تعريف واضح للعربي ، والإشتغال على البنية التحتية " الهوياتية " ، التي يصعب تصور قيام شكل من أشكال المواطنة من دون الإنتهاء منها .
وفي ( الفكر القومي العلمي ) : نجد في كتابات / قسطنطين زريق / مقاربات ومعالجات إيجابية لمبدأ المواطنة بالمفهوم الحديث . حيث يقول مثلآ : ( المواطنية لاتوجد بالطبع والسليقة ، ولا تحدث قدرآ وإعتباطآ ، ولا تمنح منحآ من مصدر خارجي ، بل تكتسب إكتسابآ شأن قيم الحياة الأخرى ، وبمقدار ما يبذله أبناء المجتمع من أجلها وبمبلغ إقبالهم على التضحية بمصالحهم وبولاءاتهم الأخرى في سبيل ولائهم الوطني المشترك ) . ثم يتحدث عن أربعة شروط " للحياة الوطنية الصحية " هي :
1- توفير الكرامة لأبناء الوطن ، وتحقيق مستوى لائق من العيش المرتبط تبعآ " لوفرة الدخل الوطني العام " و " عدالة توزيع هذا الدخل " .
2- قيام الحياة الوطنية الصحية على التعاطف والتساند والولاء المشترك . فلا يكون ثمة وطن إذا كان ولاء الفرد فيه متجهآ أولآ إلى أسرته أو عشيرته أو طائفته أو مهنته أو الجهة التي تكفل مصلحته الخاصة . عندها يتفتت الوطن وتتضارب الإتجاهات وتتناقض المصالح ، وينتفي معنى الوطن .
3- تفتح الحياة الوطنية على الحضارة ، فتكون مؤثرة كما هي متأثرة بالتراث البشري العام .
4- أن تكون هذه الحياة الوطنية مساهمة في الحضارة الإنسانية ، فالوطن ينمو بالعطاء و ينمو بالأخذ .
ونستطيع أن نلمس أهم أسباب ضعف مبدأ " المواطنة " في الفكر القومي العربي :
· غلبة تنظيرات دور الدم واللغة والتاريخ – النظرية الألمانية – في تشكيل الوعي القومي ، على حساب تنظيرات الحقوق والواجبات – النظرية الفرنسية – في تشكيل أي مجتمع قومي حديث .
· ضغط أولويات التخلص من الإستعمار والتبعية للخارج ، ومحاولة بناء دولة ما بعد الإستقلال بالتوازي مع مواجهة التحدي الصهيوني .
· الموقف المتشكك الذي إتخذه الفكر القومي الكلاسيكي من قيام ديمقراطية عربية في الدول التي سماها " دول التجزئة القطرية " .
واليوم .. وفي المحاولات الحثيثة ( لتجديد الفكر القومي العربي ) نجد إنطلاقآ له لمواجهة مشكلة الأقليات ، الإهتمام الكبير في إندماج مكونات أي أمة بإعتماد أربعة عناصر :
1- المشاركة السياسية : أي التمثيل السياسي لكل مكونات المجتمع في أجهزة الدولة : " البرلمان ، الحكومة " بصورة متساوية . لأن أي إقصاء يمزق النسيج الوطني .
2- المشاركة الإقتصادية : أي إتاحة الفرصة لكل رجال الأعمال من كل الأديان والمذاهب والإثنيات والمناطق ، بالإنتفاع من العملية الإقتصادية ، بدلآ من أن تحصر الدولة مقاولاتها في حفنة من الأتباع .
3- المشاركة الثقافية : بمعنى إحترام جميع الأديان والمذاهب والشعائر واللغات والتلاوين الثقافية . وهذا شرط مهم من شروط الإلتحام للأمة .
4- المشاركة الإدارية : فهناك الجهاز الحكومي الإداري بكافة مراتبه ، والجيش والأمن بحاجة إلى مشاركة كل فئات وعناصر السكان فيها ، بدون إستبعاد لأي سبب كان .
وفي الأساس والأهم ... فإن " بوابة الوحدة الوطنية " هي : ( الحرية ) . فعندما ينال المجتمع حريته ، وتتعمق في فضائه الممارسة الديمقراطية ، تزول كل هواجس الخوف ، وتضمر كل نوازع الإستقلال الذاتي والإنفصال . فالديمقراطية بكل آلياتها ومؤسساتها ومقتضياتها ، هي التي تعمق خيار الوحدة الداخلية ، وتبنيه على أسس متينة وقواعد حضارية صلبة . فالتعدد الثقافي واللغوي في كل الكيانات السياسية . ففي سويسرا مثلآ هناك ثلاث مجموعات ثقافية / لغوية كبرى ، ولم يمنعهم ذلك من بناء وحدة داخلية حضارية تعطي لكل مجموعة حقوقها في الدولة / الأمة السويسرية . كما أن الديمقراطية في الهند قد سمحت لأكثر من أربعين جماعة ثقافية / لغوية كبرى ، من بناء دولة / أمة مقتدرة ، ومجتمع ديمقراطي يمتلك تجربة تاريخية متواصلة في الحرية والتسامح بين المجموعات المتعددة التي يتشكل منها المجتمع الهندي ، والدولة / الأمة الهندية .
إن العدالة سبيل التعايش – والحرية تعني غياب الإكراه ونجاوز كل الحساسيات – والحرية بوابة الوحدة ، والحرية شرط أساسي لتجاوز الطائفية ، والحرية طريق المواطنة . وإن التعدد والتنوع لا يمنعان الإندماج والوحدة الإجتماعية والوطنية .. فالذي يمنع كل هذا هو الإستبداد وغياب الحرية وغياب العدالة وغياب المساواة .
وفي مجال " الهوية " أيضآ .. وهي الأساس والمبدأ الذي يجب أن يعبر عن وضع حقيقي عقلاني متوازن ، هناك فرق كبير في المفهوم وفي النتائج . بين " الهويات القاتلة " ، وبين " الهويات البناءة " . والهوية العربية اليوم يجب أن تكون ذات مفهوم متوازن يجابه " التفكك " كما يجابه " العولمة " . ولا يجب أن يصح لواحدة ، ولا يصح للأخرى . لا يجب أن يصح لمجابهة العولمة ، ولا يصح لمجابهة خطر التفكك والعكس صحيح .
ولمفهوم الهوية رؤى متعددة تنطلق من تحديد عبارة " الهوية القومية " كما يقول د. نديم البيطار. والمهم فيها هو تعيين مجموعة الظواهر التي ترجع إليها ، والتي يمكن أن تميزها بشكل فعال عن غيرها من الظواهر . وهي تعني مجموعة من الميزات يشارك فيها أفراد مجتمع معين من الناس ، رغم إختلافاتهم الفردية والميزات الشخصية التي يلتقون فيها كأعضاء في جماعات .
كما أن هناك مسألة " درجة ثبات الهوية القومية " وإستمرارها عبر التاريخ . فمثلآ : عرب اليوم غير عرب الجاهلية ، وسكان أوروبا الشمالية الآن ليسوا متماثلين مع القبائل الجرمانية . وبالتالي فإن الهوية القومية ليست أمرآ ثابتآ تمامآ ، وهو ليس ناجم عن خصائص عرقية فطرية وراثية ، بل أن الهوية القومية هي من ( نتاج التاريخ ) تخضع للتحول وفي سيرورة دائمة وليست في كينونة ، وليس هناك من هوية قومية متأصلة أو منسجمة تمامآ . بل هناك أكثرية أفراد قومية معينة أو قسم كبير منهم يتشابهون نفسيآ وفكريآ وإجتماعيآ إلى درجة تسمح عند الإشارة إليهم ، بالحديث عن هوية قومية عامة ترجع إلى تجربة متماثلة للتاريخ . فالمجموعات البشرية أو القومية ليست أمرآ غيبيآ أو أسطوريآ ، بل واقعة تاريخية . لكن " الأسطورة " فقط هي التي ترجع هذا التمايز إلى أسباب بيولوجية أو نفسية أو عقلية ثابتة . فليس هناك من فروق ذهنية نفسية بارزة أو فاصلة بين المجموعات القومية المختلفة . فالإختلاف والفروقات بينها هي كمية وليست نوعية . ويمكن أن نجد هذه الفروق بين الأفراد وبين الجماعات التي تتشكل منها كل قومية ، ولكن ليس بين الأمم والقوميات.
كما أننا في تبني مفهومآ حديثآ للهوية القومية ، يجب أن نتجنب الإعتماد على هوية قومية منسجمة مع ذاتها ، ثابتة عبر التاريخ . لأن ذلك يعني الإعتماد على حتمية غير موجودة ، وممارسة تعجز عن التفاعل مع التاريخ الحديث تفاعلآ خلاقآ ، وبالتالي التعثر والهزيمة لمثل هذه الممارسة . والهوية القومية يجب أن تعني أيضآ ، تجنب الإنسان وفي كل مكان ، التعصب القومي من أي زاوية كانت وخصوصآ بين الأمم التي حققت دولها / القومية ، فلم تعد بحاجة إلى النضال في سبيل إقامة دولة واحدة تعبر عن وجودها القومي الواحد ، أو تحرر هذا الوجود من أشكال إستبداد وإستعمار قد يكون خاضعآ لها .
والهوية القومية تنتج أساسآ عن عاملين : عامل داخلي يتمثل في تقاليد تمتد عبر الماضي ، وعامل خارجي يعكس تفاعل الأمة مع وضع عالمي متغير يكشف عن موجات ثقافية ونماذج حضارية متعاقبة ، تقود إلى ردود فعل داخلية تفرض التحرر من تلك التقاليد أو تحويلها . وهذا يعني أن كل أمة أو هوية قومية هي في الواقع صورة مصغرة عن الإنسانية ، تعبر عنها – عن الإنسانية – من زاوية معينة . فكل هوية قومية هي تكوين لاينطوي على عناصر داخلية فقط ، بل أيضآ على إسهامات إنسانية عامة . فهي ماهي عليه ليس بسبب ماحدث في وطنها وفي مجتمعها ، بل بسبب ماحدث في عواصم وحضارات وثقافات أمم وشعوب أخرى ، وهذا يعني إنفتاحآ إنسانيآ بين شعوب العالم وثقافاته ، إذ أنه أصبح ضرورة بقائية للإنسانية نفسها .
ويتبع / د. حليم بركات / منهجآ نقديآ تحليليآ جدليآ يتفق في نقاط كثيرة مع / د. نديم البيطار / ، مع بقاء الإختلاف الكبير بينهما حول عامل ( اللغة ) الذي لا يعيره د. البيطار أهمية كبيرة ، بينما يعتبره د. بركات من أساسيات الهوية القومية . ويؤكد منهج د. بركات على التالي :
1- سعيه لتحليل عناصر التوحد ( كالسمات العامة أو الخصائص التي تميز الأمة وتعطيها شخصية متفردة عن غيرها ، والثقافة ، والمصالح الإقتصادية ، والقيم الأخلاقية ، والمبادئ ) حيث يتناولها في سياق العمل المشترك وفي التاريخ والمجتمع وليس خارجهما . بحيث لا تفهم " الهوية " خارج سياقها التاريخي والإجتماعي .
2- يقدر أهمية تعدد الهويات ، ضمن الهوية العامة المشتركة . ويرى في التنوع مجالآ لإغناء تجربة الوحدة ، إذا تم التوفيق الصحيح بين مفهومي التعدد والوحدة في مناخ من الإحترام المتبادل والحرص على المشاركة لا الإقصاء . وهنا تصبح ( الأمة ) ليست مجرد مجموعة متعايشة من الإنتماءات المختلفة ، بل انها تفاعل حر في إطار عام من الإمتثال الطوعي لا القسري .
3- إن " الهوية القومية " هي في حالة دائمة من التطور والتكون والتحول . إنها كينونة مستمرة شكلآ ومضمونآ ، من حيث علاقتها بذاتها وبالآخر . فالوعي الذاتي معرض دائمآ لتيارات التحول طوعآ أو قسرآ ، فيعيد المجتمع الفاعل بالتاريخ والمنفعل به تجديد هويته المتوارثة ، ويمنحها أبعادآ جديدة بما فيها تلك التي ربما لم يكن يتقبلها سابقآ ، وتدخل في صلبها عناصر لم تكن موجودة أصلآ . إنها – الهوية – مشروع تاريخي نكافح لإنجازه ، وليست " حتمية " ذات نزوع إتكالي .
4- ان الحديث عن " الهوية " يقود بالضرورة إلى رسم حدود بين الذات والآخر . بين ( النحن) وال ( هم ) . والسؤال هنا : عن ماهية ونوعية الحدود التي نريد أن نقيمها بيننا وبين الآخر ، وما الحدود التي نريد إزالتها ؟ .. فلقد حدد ( العربي ) هويته في العصر الحديث متأثرآ بعلاقات الهيمنة التي فرضها عليه الغرب وبدافع التحرر من هذه الهيمنة . ومن هنا كان الكفاح المرير من أجل " الهوية القومية " والتمسك بالعروبة .
5- ان هناك علاقة وثيقة متبادلة بين مواقع الأفراد والجماعات في البنية الإجتماعية الإقتصادية ، وبين الإختلاف في تحديد الهوية القومية . فالجماعات التي تحتل مواقع القوة والجاه والثروة ، وتهيمن على النظام السائد وتستفيد من العلاقات مع القوى الخارجية المهيمنة ، تختلف في فهمها للهوية القومية وممارساتها ، عن تلك الجماعات التي تشغل مواقع دونية وتكون أكثر تضررآ بسبب الأوضاع القائمة ، وتلك الجماعات التي تقع في الوسط بين بين . ويأتي خوف بعض الحركات القومية من فكرة الفروق الطبقية ، تحسبآ من أن يأتي الصراع الطبقي على حساب الصراع القومي ، والقهر الطبقي كما أظهرت نظرية التبعية والوقائع التاريخية في ظل الهيمنة الغربية .
ومن النقاط الخمس السابقة ، نستطيع أن نطرح تعريف للهوية على أنها : [ وعي للذات والمصير التاريخي الواحد ، من موقع الحيز المادي والروحي الذي نشغله في البنية الإجتماعية ، وبفعل السمات والمصالح المشتركة التي تحدد توجهات الناس وأهدافهم لأنفسهم ولغيرهم ، وتدفعهم للعمل معآ في تثبيت وجودهم ، والمحافظة على منجزاتهم وتحسين وضعهم وموقعهم في التاريخ . الهوية من حيث كونها أمرآ موضوعيآ وذاتيآ معآ ، هي وعي الإنسان وإحساسه بإنتمائه إلى مجتمع أو أمة أو جماعة أو طبقة ، في إطار الإنتماء الإنساني العام ] .
ويجب أن يكون واضحآ ، أن أهم عناصر الهوية ، الحرص على التنوع أو التعدد في إطار المصلحة العامة ، بشرط ألا يكون التمايز مدعاة للتمييز وإقامة علاقات هرمية تراتيبية بالإستناد إلى قيم عمودية . والهوية يجب أن تكون مرتبطة بالتعددية الديمقراطية ، وتقوم على أساس المساواة في الحقوق والواجبات . فلا تهيمن طبقة أو جماعة أو مجموعة من الجماعات على غيرها . وبالتالي يكون من أهم طموحات الهوية المشتركة أن تحتفي بالتنوع ، بدلآ من فرض الإمتثال القسري ذو البعد الواحد . إن هناك علاقة عضوية وثيقة بين التحرر القومي من الهيمنة الخارجية ، وبين التحرر من هيمنة الطبقات والجماعات السائدة داخل المجتمع . والهوية القومية تفترض الولاء للمجتمع أو للأمة ، ولاء قائم على الإمتثال الطوعي ، وعلى حل التناقضات حلآ عادلآ . وتكون السلطات بما فيها السلطة السياسية شرعية ، بقدر ما تجسد مصالح المجتمع وتطلعاته من دون تمييز أو إقصاء للآخر. فللمجتمع أو الأمة أولوية على الدولة وليس العكس . فالدولة هي التي تستمد سلطتها من المجتمع ، وهو الذي يفترض أن يمنحها حق تطبيق القوانين وفرضها على المواطنين أفرادآ كانوا أو جماعات . ولكن وكثيرآ ما تنشأ أزمات مستعصية بسبب أن الدولة كثيرآ ما تفرض نفسها بإسم المجتمع وهي قادرة من موقعها أن تفرض تفسيراتها الخاصة ، ومن هنا ينشأ ( الإغتراب السياسي ) . وخاصة عندما يوظف المجتمع في خدمة الدولة ، بدلآ من أن توظف الدولة لخدمة المجتمع . وينتج عن ذلك تاليآ خلل في الولاء وحتى في الهوية .
فعندما تفرض السلطة والقوى أو الطبقات المتحكمة رؤيتها على المجتمع ، فتشكل حينها هذه الرؤية السلطوية ، هوية ثقافية وسياسية وإجتماعية مشوهة ، وتحل محل الهوية القومية التي تتمثل فيها إرادة الشعب والمجتمع .
ان مفهوم الهوية القومية هو حالة تتخذ فيها الجماعة صورة ( الدولة المنظمة سياسيآ ) . والباحثون في الهوية القومية يفترضون إفتراضآ واقعيآ من الناحية العامة ، بأن " الأمة " هي أهم جماعة يمكن للفرد الإنتماء إليها ، ويعطيها ولاءه . والتي تجب التضحية في سبيلها بالولاءات الأخرى .. عشائرية ، أسرية ، شعوبية ، حزبية .. الخ ، إن هي تناقضت مع الولاء لها . وهي بلا شك حالة من ضمن مسألة أوسع وهي ( الهوية الجماعية ) التي تقترن بالجماعات المختلفة . وهنا نصل إلى ....
صورة الدولة السياسية :
---------------------------
خلال مسار الفكر القومي العربي منذ ما بعد الحرب العالمية الأولى وحتى الآن ، ورغم الإبداعات الفكرية التي عمقت وأثرت الفكر السياسي العربي ، ومنها بالتأكيد نظريات في الأمة ، بما يكفي لتأسيس فكرة الأمة العربية في الثقافة وفي الوعي الجمعي العربيين ، وخلقت مفهوم واضح لآليات تنمية النسيج المجنمعي العربي الموحد ، مقابل الأفكار والنزعات الإنكفائية إلى الهويات الماقبل القطرية ، والقطرية . وبينت مخاطر الإقليمية والتفكيكية من جهة ، ومخاطر العالمية من جهة أخرى على كيان العروبة ومستقبل الوحدة .
إلا أنه ورغم هذه الإبداعات بقيت مسألة غائبة في الفكر القومي العربي ، وهي مسألة : الدولة/الأمة، الدولة القومية . ومع بعض التعرضات الشكلية والفرعية لها من خلال موضوع الأمة ، لا من حيث كونها موضوع أساسي مستقل للبحث " ككيان سياسي " لهذه الأمة ، وفي تبيان الضمون السياسي والإجتماعي والقوى الإجتماعية الحاملة للمشروع القومي وعلاقة الدولة والجماعات الغالبة فيها ، بالأقليات . وكذلك البحث في علاقة الدولة / الأمة ، مقابل الدولة / القطرية ، وكترجمة سياسية للفكر القومي العربي .
ان الكثير من الأمم قد شكلت " دولها القومية " ، بينما العرب وبعد تفكك دولتهم الدينية !! ، وبعد إجراءات التقسيم الإستعمارية للوطن العربي ورسم حدود تفكيكية للوطن من باب " التفرقة " والتجزئ لإستمرار وجود الإستعمار ، وبقاء هيمنته حتى بعد رحيله ، وبسبب إستمراء الحكام القطريين لهذا الوضع لتحقيق الجاه والسلطة والمال لكل منهم على حدة غير متعرضين لمنافسة آخرين ، مع إمكان قبولهم لتجزء أكثر إذا كان سيحقق ظهور حكام سلطويين جدد لما سيقسم ، لكل هذا لم تظهر الدولة / الأمة في الوطن العربي . وبقيت " أشباه الدول " تحكم بشكل بعيد جدآ عن مفهوم " الدولة الحديثة " ، بعلاقات عشائرية أو عائلية أو حزبية ضيقة .
هذا ( الواقع ) الذي نعيشه اليوم يقتضي منا فهمه والعمل من خلاله . لا إستسلامآ لهذا الواقع ، ولكن حتى لا نعيش الأحلام والرغبات والرؤى التي يجب أن تكون ، فنبتعد عن " الفعل السياسي " الواقعي ، ونبقى نسير في المكان . ان الواقع يقول : ان هناك ما يمكن أن نسميه تجاوزآ ( الدولة الوطنية ) . والمثل والرغبات والتطلعات تقول : بوجوب العمل مهما استهلك من الوقت للوصول إلى
( الدولة القومية ) . – ولسنا هنا بمجال التكلم عن منجزات الدولة القومية لو تحققت - .
" الدولة الوطنية " : وهي واقع سياسي . والسياسة فن الممكن ، ولكنها عاجزة " بحد ذاتها " كفعل سياسي من تغيير الواقع الممكن الذي تعمل من خلاله . وبالتالي لابد من رفدها وإحداث تأثير فيها من خلال ( المعرفة والوعي والثقافة ) إذ أنها ومع ترابطها معهم ، ستصبح " فن التغيير " . إنها بترابطها مع تلك الثلاثية وإعتمادها عليهم تؤدي إلى إنعكاس وطريقة رؤية الواقع ، ثم إلى التمرد على هذا الواقع . فبالفعل السياسي تخلق أدوات التغيير إلى واقع جديد .. ممكن جديد ، لواقع متطور عما كان . إن أعظم التقدم الإنساني بشكل عام ، بدأ بالفكر وبالوعي وحتى " بالحلم " .
ولكن .. لايجب القفز عن الواقع ، عن ( الدولة الوطنية ) ورفضها ، إيمانآ وتطلعآ إلى ( الدولة القومية ) ، الدولة / الأمة . فأي تغيير يبدأ من الواقع والإعتراف به وتوصيفه وتفهمه وتحليله والتفاعل معه وعلاج أمراضه ، لينطلق الإنطلاقة السليمة للتغيير ضمن الظروف الموضوعية والتاريخية .
وعندما نتكلم هنا عن " الدولة الوطنية " ، وعن ماهية أغراض وجودها ، وعن أهميتها ، وعن وظائفها ، فإننا نتكلم ونعترف بوجود الدولة الوطنية وحقها في السيادة والقيادة وتحقيق الأمن والمساواة والعدل والتنمية لمجتمعها . والدولة الوطنية أيضآ التي نتكلم عنها ونعترف بوجودها ، ليست هي : الدولة الوطنية / القطرية البحته ، بنمطها وتعريفها وأغراضها ووظيفتها ، إقليمية المنطلق والواقع والنتيجة والهدف . إننا هنا نتكلم عن : الدولة الوطنية / القطرية الكيان ، قومية الغرض والهدف . بما يعني القبول والفعل والإعتراف بهذه الدولة الوطنية / القطرية ، هو :
" واقع سياسي " نتفاعل معه بكل جهد وأمانة وإعتراف . ثم ومن خلال نظرة الوعي والمعرفة والحضارة والجدلية ، نتطلع ونتوجه ونعمل ( بفعل تراكمي تدرجي ) نحو الدولة القومية ، الدولة / الأمة .
===============
فائز البرازي : 28 / 9 / 2005
..............."
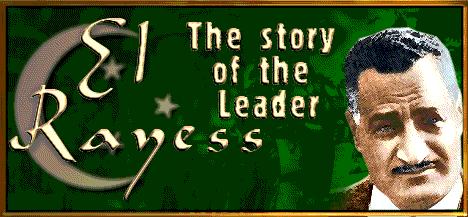 |
الــــرجوع الى الفهـــرس للمتابعة والمواصلة