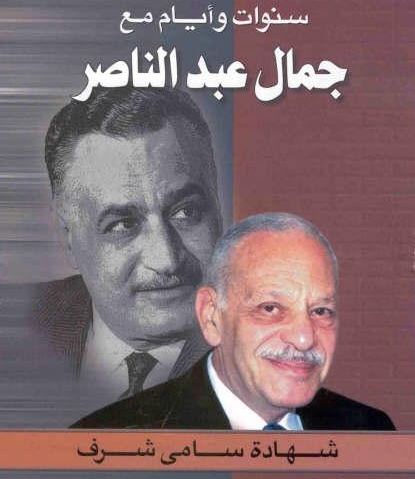 |
من أقلام الأصدقـاء والضـيوف
العـقل العـربى
بقلم
فـائز البرازى
العقل العربي / مدخل
الدماغ البشري " كمادة " في تركيبته ووظائفه البيولوجية والفيسيولوجية ، واحد عند كل البشر . والعقل " المعنوي " هو أحد إفرازات الدماغ المادي . العقل هو أداة الفهم والتفكير والجدل .
والدماغ كمادة نادرة تتفاعل مع ذاتها كيميائيآ وفيسيولوجيآ ، وتتفاعل مع عوامل أخرى خارجية كثيرة جدآ ، من أهمها : المحيط / الجغرافيا – التاريخ / الأحداث والتجارب – العلاقات الإجتماعية والثقافية السائدة في مجتمع إنساني ما . حيث يتأثر الدماغ في تفاعلاته الذاتية والمحيطة ، فيظهر العقل كإفراز متطابق مع هذه التفاعلات . ثم يقوم العقل بالتأثير لإحداث التغيير ، أو الإستسلام والإندماج وتكرار ذات المعطيات التي قام عليها في فهمه وقبوله المسلم بها لهذه المعطيات الإجتماعية والثقافية . أي : أن العقل متأثر ومؤثر في عالم المادة وفي عالم التفكير .
إن إختلاف ( أنماط التفكير ) ينبع من الإختلاف بين العقول في الفرد الإنسان ، وبالتالي في المجتمع الإنساني ، نتيجة تأثر هذه العقول بالدماغ ، المتأثر بما سبق الإشارة إليه . وللإبتعاد عن تكرار مصطلح " الدماغ " ، فسأبحث مباشرة في ( العقل ) كأداة مباشرة في ( أنماط التفكير ) .
العقل و المحيط / الجغرافيا :
يلعب المحيط / الجغرافيا دورآ أساسيآ بالتأثير في العقل وإفرازاته كأنماط تفكير . فالدراسات والأبحاث وحتى المشاهدات تلمس هذا التأثر .
فمثلآ : هناك فروقات بين الأفراد والتجمعات البشرية ، بين من يولد ويعيش في مدينة ساحلية ، وبين آخر في مدينة داخلية صحراوية . بين أمكنة القحط والجفاف ، وبين أمكنة الخصب الخضراء والمراعي . بين سماء صافية مشرقة ، وبين سماء داكنة ملبدة بالغيوم . وبين من يعيش في مدينة عادية ، وبين من يعيش في عاصمة . وهذا مضافآ إليه مايتعرض له موقع جغرافي ما ، من إحتلال وسيطرة خارجية .
فالمكان هنا / الجغرافيا .. لها تأثير في تشكل العقل ، وتترك أثرآ مهمآ في بنية العقل وأنماط التفكير ، التي يغلب عليها إما الطابع الرومانسي الروحي ، أو الطابع المادي . ولعلنا نتساءل من ضمن تساؤلات كثيرة عن : الشعر ، فقه اللغة ، التأمل ، وحتى عن سبب نزول الأديان في منطقتنا فقط كما " نعرف " من القرآن الكريم المرسل للبشر كافة .
كما أن " أسلوب التعامل " في طراوته أو شدته ، يختلف بين ساكن صحراء أو بين ساكن مدينة . ففي سوريا مثلآ : فإن الإختلاف في أسلوب التعامل ونمط التفكير بين قاطني مدينة حماه على حدود الصحراء ، ومدينة حمص الوسطى ، خير مثال لشدة التعامل في الأولى ، وطراوته في الثانية ، والمسافة بينهما لاتتعدى 40 كم . . هذا إضافة إلى عناصر وعوامل أخرى ..
وهذا ماتكلم عنه / إبن خلدون / قبل أكثر من ستمائة عام وقبل الباحثين المحدثين ، في مقدمته الشهيرة / مقدمة إبن خلدون / حيث وضح الفرق بالتفاصيل وتأثيراتها على أنماط التفكير ، بين البداوة ، والمدينية .
التاريخ / الأحداث والتجارب :
إن الأحداث والتجارب تترك بصماتها الواضحة في مسيرة الحياة ، وفي تفاعل العقل مع تلك الأحداث والتجارب ، من إنطباعات ومن تعاطي ومن أسلوب تفكير ومنهج عمل .
وعلى مر التاريخ في المنطقة العربية ، المنطقة التي تعرضت أضعاف عما تعرضت لها مناطق أخرى في العالم ، من أطماع وإحتلال وسيطرة . ولعل الموقع الجغرافي والثروة لمنطقتنا قد ساهما في ذلك إلى حد كبير . فجميع منطقتنا العربية وعلى مر التاريخ تتعرض دائمآ لموجات محاولات السيطرة وللإحتلال الخارجي الغربي ، أو الإقليمي المحيط . وهذا ما طبع العرب وطبّعهم على مقاومة الإحتلال وتقديسهم ( للحرية الجماعية ) – الإستقلال – التي تعطي حريات فردية أخلاقية وشرفية وقيمية .
إلا أنه وخلال معظم المسار التاريخي للمنطقة العربية ، لاتكاد الثورات والحروب والمقاومة تنتهي من تحقيق ( الإستقلال ) ، بثورات وعنفوان ووحدة وطنية عميقة وصادقة ، لاتكاد تحقق الإستقلال إلا وتنكفئ تلك الشعوب والنخب والنظم على نفسها ، مبتعدة عن إكمال مسيرة الإستقلال والحرية نحو البناء والتقدم . فتعود سيرتها الأولى نحو : الفردانية والشخصانية والعصبية والعشائرية والقبلية .. وهذا المسار يكاد يكون متكررآ خلال تاريخ منطقتنا العربية . إعتدنا على الثورات والرفض ، ولم ندخل مرحلة البناء والمدنية والعلم والعمل الجماعي .
وهذا " التاريخ " يكاد يكون متوارثآ وسائدآ في أنماط التفكير العربي .. ثورة ونهوض .. ثم كمون وإستسلام وتخلف .
العلاقات الإجتماعية والثقافية :
ولأكن أكثر تحديدآ في هذا المنحى .. فهي العلاقات السائدة في وبين قاعدة المجتمع ، إلى رأس النظام ، ومن رأس النظام إلى قاعدة المجتمع .. علاقات أولية متبادلة التأثير والتأثر ، ويعتريها ( الإنقطاع ) شبه الدائم في مرحلة ما من مراحل التواصل المفترضة .
وإن بدأت بالعلاقات المجتمعية الشعبية السائدة في الإجتماع والثقافة ، لكونها المنبع والمنهل والمفرٍز لأنماط التفكير وأساليب التعايش والتوجه ، للأنظمة وللسلطات الحاكمة والمجتمع . وهي من الأهمية القصوى في تشكل النخبة والسلطة ، ثم بإنعكاس أفعال وأنماط تفكير النخبة والسلطة على المجتمع .
والدليل على ذلك : أنه ومنذ قرون طويلة في منطقتنا العربية ، لم تأت نخب أو نظم وسلطات من ( المريخ ) لتحكم هذه المجتمعات وتقودها .. بل كانت إفرازات المجتمع .
إن العلاقات الإجتماعية والثقافية الشبه سائدة ، ماهي إلا نتاج : العقل ، وأنماط التفكير ، والثقافة .
فالعقل العربي : إنبنى و"تحجر" على عقلية البداوة والعشائرية ، وشيخ القبيلة ، والصراعات ، ورفض الآخر حتى القريب .
وأنماط التفكير : كانت تتواجد وتتفاعل وتجتهد لخلق الأسلوب والطريقة التي تحقق التوجه القبلي العشائري .
والثقافة : التي تكاد لاتظهر بشكل " معرفي " فاعل نحو تقدم المجتمع العلمي وتطوره وبنائه .. إستندت في معظمها وعلى قلتها وتحجرها ، على : المفاضلة بين النقل السائد ، وقليل من الدعوة للعقل .
والسبب في معظمه ، يعود أساسآ إلى رفض المعرفة العالمية الإنسانية ، والتقوقع على تراث سابق للمعرفة . حتى أصبحت الرؤية السبه عامة تتمثل في نمط تفكير يقول : ( ان ماصلح به ماضينا ، هو مايصلح حاضرنا ) .. أي : الدعوة للعودة إلى التاريخ والنمطية السابقة ، وإستقدام ودعوة الزمن الماضي بكل معانيه ومعطياته وظروفه وبيئته وتجلياته .
وكان الفكر الديني في كل الأديان : اليهودية ، والمسيحية ، والإسلام ، هو من يحاول إسترجاع ذلك في معظمه ، لتبقى له الهيمنة والسيطرة على المجتمعات وعلى الإنسان ، كساحر القبيلة في العهود الماضية ، من خلال " مؤسساته الدينية " التي يشكل ( العقل ) والتفكير والتبصر والحوار ، خطرآ داهمآ على وجودها وعلى مصالحها الدنيوية ، وتراكم تراثها الديني المتخلف زمنيآ في معظمه .
وإن كان كل هذا " التوصيف " السابق ، لايعني ( القدرية ) التي لايمكن الفكاك منها ، أو الحكم المبرم الذي لابد أن نعيش مستسلمين له ، فلا بد من أن نبحث ونعمل للخروج من هذا الأسر .
إن تكوين العقل .. أي عقل ، بحاجة إلى وعي وإرادة وفعل ، لتغيير وتطوير هذا العقل المتكون .
وأخيرآ .. أنا هنا لأتساءل قبل الإجتهاد ، وأترك للأخوة الإجابة .. مالعمل ؟؟ .
فائز البرازي : 31/1/2007
..............."
العقل العربي / ضحية
العلاقات الإجتماعية والثقافية :
ان التأثير المتبادل بين العقل ونمط العلاقات والثقافة ، من أهم وأخطر مانحصده من نتائج . فبدءآ من إفرازات عقل البداوة وتأثيراتها في نمط العلاقات الإجتماعية والأنماط الثقافية ، ثم عودة نتائج ذلك لتؤثر على العقل ونمط التفكير ، ضمن دائرة جدلية مؤثرة ومتأثرة تحدث تراكمآ مستمرآ في التكون السيئ للعقل ، وللعلاقات ، وللثقافة .
وان أهم العلاقات الإجتماعية التي تساهم في إنتاج الإيجابية أو السلبية ، هي : ( العلاقات الأسرية ) ..
فالطفل داخل بيئته الأسرية : - يتربى على جملة واسعة عائمة المعاني تضعه وتحفر به عميقآ لتتأصل في نفسيته وذاته . فمن كلمات مثل : " العيب " ، و " الحرام " ، التي قد تتوسع فتضَيق وتسجن إنطلاقة الطفولة وتجاربها الحياتية وتضع قيودآ على عقل بدء التفتح والإنطلاق . كل ذلك ضمن مفاهيم واسعة فضفاضة للعيب والحرام ، ولتشمل بدون حق مفاهيم غير صحيحة ولا صحية وواسعة مرتبطة فقط " بالتعليمات الأسرية " بدون مفاهيم ودلالات واضحة لمعنى وحدود العيب والحرام .
يضاف إلى ذلك : تلك التعليمات الزاجرة القاسية لتضع الطفل تحت هيمنة " كلية " مبنية على القهر والإستبداد . ومقترنة بنشر ( ثقافة الخوف ) في داخل الطفل من " العقوبات " الجسدية والمعنوية التي تمارس فعلآ وتطبق عليه دون تفهيم وشرح وتوضيح ، بما تترك من بصمات واضحة على نفسيته وشخصيته ، وفي ظل غياب شبه كامل للحب العميق ، غير " تدليل " الأم ، والذي فجأة ينقلب إلى زجر وصراخ وشتائم وضرب .
إن مفهوم " الأخلاق " وحدودها ومعانيها ودلالاتها تبقى عائمة دون توضيح وتحديد حقيقي بتشابكها مع الذات ومع الآخر داخل العائلة أو في المحيط الإجتماعي . فكيف للطفل أن يفهم مثلآ : ذلك التناقض الصارخ ، بين تعليمات الأب والأم " بذم الكذب " والنهي عنه ، ثم يرى أباه أو أمه يمارسانه بطبيعية وتلقائية على بعضهما البعض ، أو في محيطهما الإجتماعي ، والطفل شاهد على قسوة هذا التناقض ؟ .
والطفل سيصبح رجلآ : - يحمل تراكمات سنين الماضي من تجاربه ومشاهداته وخبراته القائم معظمها على أفكار وممارسات : الهيمنة والتسلط في الأسرة ، في العمل ، في الجيش ، في الوزارات ، في الأحزاب ، في كل مراكز السلطة والقرار ، ورفض الرأي الآخر .. والرأي الآخر هو : مشاركوه الإجتماعيين ، وأصدقائه ، وأقربائه . وخصوصآ " زوجته " التي لايجب أن يكون لها رأي ، وإن كان وسمع فلا يؤخذ به ولا يفكر بجديته وصلاحيته ، وأحيانآ مع قناعته بصوابية رأي الزوجة ، لايعمل به نكاية أو خوف إجتماعي ذو مدلول على تبعيته لزوجته . ويكون ( للفكر الذكوري ) السائد والمتوارث إجتماعيآ ، الدور الأساسي في ذلك . ثم يضاف إليه : [ الرجال قوامون على النساء ] كفكر ديني متخلف خارج نهائيآ عن " المقاصد الحقيقية للآية الكريمة " ، أو تغييب ربطها بآيات كريمة أخرى كثيرة تحض على المشاركة والندية والمساواة والتكامل والإستشارة .
والطفل الأنثى .. إمرأة : - تتوارث وأبنائها " ثقافة الخوف " وثقافة القهر والإستبداد ، كدوافع للإستسلام وللكذب وللمراءآة . وتقبل أن تكون شبه محذوفة من فاعليات ووظائف وجودها الأساسي في الأسرة ، لتنحصر وظائفها ، كآلة : جنس ، وتفريخ ، وإطعام ، وتنظيف . وتحذف الوظائف الأهم في : الحنان والحب ، في التربية ، في التوجيه ، في المشاركة . وتبقى في معظم حالاتها تعتاش من مستنقع الجهل والأمية .. الأمية النسبة الأكبر في وطننا العربي والإسلامي . وتبقى ( كتلة لحم ) هذا يريد تغطيتها والحجر عليها بالكامل ، وهذا يريد تعريتها وإستغلالها غثارة جنسية لتحقيق التوسع في الأعمال وفي الأرباح وحتى في تحقيق إنحراف الرؤية الشبابية عن عمقها وأخلاقها .
وكثيرة هي النساء اللائي يمضين معظم حياتهن في : [ يوقرن بيوتهن ] ككلمات منزوعة السياق من روحية القرآن . أو في تجوال وزيارات فارغة من ضروراتها الإجتماعية ، أو بأعمال " غير منتجة " تأخذ فرصة رجل رب أسرة آخر ، فتوقعه في بطالة .. فتمضية ساعات في عمل غير منتج ، يمكن تحويلها إلى ساعات عمل منتج في التربية الصحيحة والمعرفة والثقافة المساعدة لها في حياتها ووظائفها .
كل ذلك سينعكس إنعكاسآ سلبيآ ومع تراكمه ، على تداول وتوريث الأجيال ، وعلى الهيئة افجتماعية وتركيبتها ، وعلى جميع الهيئات والمؤسسات ، مما يقارب أن يشكل ( عقلآ جمعيآ ) متأثرآ بتلك العلاقات السلبية ، ومعيدآ إفراز ذاته وبشكل أكثر سوءآ وتعقيدآ على العقل الجمعي والعقل الفردي .
كما أن ( الوضع الإقتصادي ) : سيتأثر بذلك ويؤثر فيه . فمساهمة تردي الوضع افقتصادي في الأزمة لايمكن إغفاله . إن الأوضاع الإقتصادية السيئة تتسبب في الإنصراف شبه الكامل لتحصيل لقمة عيش الشعب . فتنتشر الأمية لهروب الأطفال أو إخراجهم من المؤسسات التعليمية ، إلى الشارع للمساهمة في تكاليف المعيشة ، ويتسع وقت البحث لتأمين وسائل الحياة عند الأب والأم ، ويضيق وقت التوجيه والتربية لأطفال الشوارع ، ويتزايد الجهل وغياب المعرفة ومتابعتها ، ليزداد تعمق تخلف الوعي في الأسرة والمجتمع . ويصبح ضيق الوقت ، وشلل التفكير ، عوامل أساسية للإعتماد على التكرار والأخذ بالسائد في كل الأمور . إنه إعتماد شبه كامل على ( النقل ) ..
إن سيادة شلل التفكير يفرزه ضيق الوقت ، ووجود من يفكر ويقرر عن الجموع ، فتضعف أو تتلاشى الرغبة في التفكير الجاد الواعي ، أو بالرغبة في المساهمة بالقرار والمطالبة بها بكل درجات القرار ، والعزوف عن تحمل مسؤولية ذلك . وتسود في ظل كل ذلك .. ثقافة : الشطارة ، الفهلوة ، التقرب والمراءاة ، الكسب السهل الغير مشروع .
وفي الثقافة : - تتسيد ( ثقافة البقرة ) التي تكلم عنها الفيلسوف الألماني / نيتشه / وسماها " ثقافة الإجترار " . بكون الإنسان لايمتص مايراه ويسمعه ويقرأه فقط ، بل يدخره وثم يقوم بإجتراره .
أو ( ثقافة العنزة ) عنزة /المهاتما غاندي / القائمة على الرضاعة ، ثم التوقف عنها نهائيآ ، لتقوم بإنتاج الحليب . حالها حال معظم المتعلمين الذين قد يقرأوا ويعرفوا في عهد الصبا ولفترة محدودة من الوقت ، ثم يتوقفون ويقلعون ، ثم يتفرغون للكتابة والنشر بمعزل عن متابعة القراءة وتوسيع المعرفة .
إفرازات الفكر الديني :
ان من أحد أكبر أسباب وصول العقل العربي إلى ماوصل إليه ، هو ( ممارسة السلفية الدينية ) ، ومساهماتها الكبيرة في وضع الحواجز أمام العقل ، وخلق حالة صدامية كاذبة ومدمرة ، بين الدين وبين العقل النّزاع إلى التجديد والتطوير والإبداع . والمحاولات الدائمة للخلط ضمن هذا الفكر الديني السلفي : بين العبادات والعقائد ، وبين المعاملات . بين الثابت ، وبين المتغير والمتبدل .
1- تستخدم هذه السلفية الدينية ، ( ثقافة القطيع ) .. في الوعظ ، وتقليص الحلال ، وتوسيع الحرام ، وفي توسيع مدى المقدس ، والإعتماد على النقل والتكرار والتحجر . مستندة في ذلك ، على الخلط ، وجهل العامة بالدين والتمايز فيه . ومن أخطر ماتقوم به هذه السلفية ، هو البناء على " الرأي الخاص " وتعميمه ، وتشويه " القياس" وتسييده الأعمى ..
2- وكذلك .. تشويه الوحي / القرآن : بنزع الآيات من أماكنها وأزمانها ، وإستخدامها في أماكن متخالطة وفي غير مكانها وزمانها ، لإثبات توجه ما ، أو تأكيد على رأي خاص . كما تسعى عبر ذلك بإدراك أو بعدم إدراك ، "بتغييب قيمة الإنسان " امام أهداف الدين . فلم تستوعب أن الإنسان لم يخلق من أجل الدين ، بل أن الأديان وجدت من أجل الإنسان ، وفي ظل تغييب السلفية " لفقه المصالح المرسلة " و " تغير الأحكام بتغير الأزمان " ، كذلك في الخلط بين المقدس في العقيدة ، واللامقدس في المعاملات .
3- وفي إستخدامها للحديث : - فتجري في معظم الأحيان عملية " تشميل " أحاديث / الخصوصية لشخص ما ، لحادثة ما ، وتعميمها بالقياس . وإصرارها شبه المتعمد لعدم الفصل والتوضيح للعامة بالتفرقة بين : أحاديث الآحاد ، وأحاديث الإعتقاد . حيث ان الأولى لاتستوجب فرض الإعتقاد أو العمل بموجبها .
على أن المشكلة الأساسية تكمن في : تصادم أمرين يتعلقان بالحديث النبوي وكيفية التعايش في تناقضهما :
الأول .. أحاديث أوامر الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ، بعدم الكتابة عنه ، ( لاتكتبوا عني شيئآ ، ومن كتب فليمحه ) . وكذلك فعل سيدنا عمر رضي الله عنه بضرب أبا هريرة بدرته عندما ينقل ويقول : قال رسول الله .. فيضربه وينهاه عن التقول والنقل عن كلام رسول الله . ولو مات أبو هريره الذي إمتد به العمر حتى الدولة الأموية ، لو مات قبل سيدنا عمر ، لما وصلنا هذا الكم الهائل من أحاديثه ، مع الأخذ بعين الإعتبار مدة عيشه مع الرسول : عامان فقط .. ونقل كل هذا ..
الثاني .. وجود وتداول هذا الكم من الأحاديث المروية – إنسانيآ – عن الرسول صلى الله عليه وسلم ، وأخذها صفة القداسة بدون تمحيص ومقارنة مع الأصل / القرآن .
هذه الإشكالية .. بين رفض كتابة الحديث والتقول به ، وبين كم الأحاديث بين أيدينا ، لابد أن توضح وتحدد وتشرح وتفسر .
أمر آخر يدخل ضمن " إشكاليات الحديث " : فهل جميع تلك الأحاديث المرواة بالعنعنة عن البشر ، هي أحاديث عن
( محمد الرسول / كقارئ للوحي ) ، أم بينها الكثير من أحاديث عن ( محمد النبي والإنسان ) ؟
الرسول معصوم عن الخطأ ، ومرتبط بالوحي .
والنبي هو إنسان يعيش حياته الطبيعية بكل معانيها الدنيوية والمعيشية والتفكيرية .
حتى أن الوحي كان " يعاتب " محمد صلى الله عليه وسلم ، على خطأ ما ، بصفة "النبي " لا بصفة " الرسول "
ماكان لنبي ...
ومما أكاد أراه خلط الأحاديث ، بين أقوال الرسول ، وأقوال النبي الإنسان ، هو إتساع الأحاديث القولية وكثرتها ، على حساب الأحاديث العملية .
كذلك .. عدم التوضيح للعامة وفرز الحديث .. كحديث مرفوض ، وحديث ضعيف ، وحديث مشكوك فيه ، وحديث صحيح ، بالإسناد والمعنى والمضمون ، مقارنة بالقرآن الكريم وروحه . مما يدفع العامة نتيجة جهلهم بهذا التصنيف وإلتباسه عليهم ، إلى إستخدام أحاديث وخلطها ببعضها البعض لإثبات أمر ما أو رأي . فلم لايبقى على الأحاديث ( الصحيحة ) بالنقل والإسناد والمعنى والمضمون ، وحذف وإتلاف الباقي ؟ .. لقد تحولت " الأحاديث " إلى نمط" أناجيل " سائدة في الدين اليهودي والدين المسيحي ، تروي " عن الأنبياء " بلسان إنساني .
4- إتساع رقعة " الخيال " الإيماني بالقدرية ، والتسييرية ، والجبرية ، والشيطان ، والجان .. الخ ، عند السلفية الدينية ، وإنتقالها وتغلغلها في العقل الفردي ، والعقل الجمعي المجتمعي ، بتأثيراتها على إفرازات العقل من أنماط تفكير وتعامل مع الواقع والحياة .
5- تجيير الدين ، وتفسيراته ، وليّمقاصده ، لخدمة مصالح المؤسسة الدينية والمؤسسات السياسية الحاكمة .
6- الإستكانة والتسليم للتراث / النقل ، وتسليطه على العقل الزماني والمكاني ، وإضعاف حالة المحاكمات العقلية لتلاحم الدين مع الدنيا .
7- إتخاذ الدين كوسيلة ترهيب ، لاكوسيلة تحبيب وتطوير وبناء ، في توازن خلاق بين الروحانية والمادية ، التي أبدع فيها ديننا ألإسلامي .
8- إلباس الخلافات السياسية ، والحياتية المجتمعية ، رداء الدين والمذاهب والطائفية . مع العمل على تغييب الرابط القومي بين الأمة .
9- إستغلال المشاعر الروحانية الدينية ، في تجييش القطيع لخدمة مآرب خاصة ، أو توجهات سياسية .
10- عدم الإنفتاح على الثقافات والمعارف الإنسانية ، والتقوقع لعدم تسييد الوعي والمعرفة ، ولعدم الخروج عن هيمنة وتسلط المؤسسة الدينية .
كما أنني ارى .. أن هناك نقطة هامة تحكم الفكر الديني في عمومه ، وهي ( التخوف من التجربة ) ..
فالملاحظ أنه وبكل الفكر الديني : اليهودي ، المسيحي ، الإسلامي ، هناك محاولات تحض على الإبتعاد عن " التجربة " وتدعو الله أن يبعدنا كبشر عن الخوض في التجربة . وكأن هناك هروب كبير من الحياة الدنيا ، سواء كان بسبب التضعضع افيماني ، أو الإعتراف بالضعف الإنساني الذي لا يواجه .. إلا بالهروب .
إن الإنسان في بداية الخلق ، وضعه الله ضمن ( التجربة ) ..
وإن لم نخض التجربة إنسانيآ ، فعلى ماذا سيتحاسب البشر أو يعاقبوا ؟
وإن لم يكن من الأهداف الإلهية " خوض التجربة " ، فلم خلق الشيطان ، ثم أمهله ؟؟ .
وأخيرآ .. فمن أدق ما قرأت عن الثقافة ومفاعليها المعرفية ، التي يمكن أن تؤثر تأثيرآ كبيرآ في العقل وإفرازاته الفكرية ، كتابآ للدكتور /جابر عصفور / بإسم ( حوار الحضارات والثقافات) يوضح بشكل أدق ، ما أردت إيصاله وطرحه .
[[ على صعيد عالمنا العربي مثلآ ، يبرز تياران ثقافيان متعارضان ، متفاعلان أحيانآ ومتصارعان بإستمرار ، وبالأخص في زماننا :
تيار ماضوي في الثقافة والسلوك ، يتصور المستقبل بوصفه إستعادة لعصر ذهبي مضى ، كما لو أن هذه الثقافة – وغد الأمة – ليس أكثر من إحياء لأمسها الذاهب ، أو صورة متأولة من صوره المتخيلة . فهي ثقافة تنبني على فهم دائري للزمن . فكأن هذا الفهم يفترض أن الزمن يتكرر بإستمرار .. أي هي ثقافة ترى مستقبلها – ومستقبل الأمة – في الماضي .. وذلك في محاولة عبثية للنكوص بهذا الزمن إلى الوراء ..
وتيار ثقافة عصرية تقفز فوق الحاضر ، لتصنعه من منظورها المستقبلي ، كتيار ما بعد الحداثة .
إن خطأ النظرة الوحيدة الجانب ، والوحيدة البعد ،بالمطلق ، سواء كانت نظرة ماضوية أصولية ، أو نظرة تسمت بأنها مستقبلية وما بعد حداثية ، هو مؤكدآ . ذلك أن كلآ منهما لاترى إلى كل من هذين التوجهين الأساسيين ( الوراء ، الأمام ) إنطلاقآ من " ممكنات " الحاضر المجتمعي بالذات للدفع به إما إلى الوراء ، كما الأصوليين الحالمين بالماضي الذهبي ، أو إلى الأمام كما الآخرين الحداثيين الذين لايتعرفون مستويات الواقع الإجتماعي الفعلي الذي يتيح إمكانات إقتحام المستقبل بإعتماد العلم والمعرفة الملموسة وتعبئة القوى والتحريك ألإجتماعي العام والتغيير في بنية الدولة نفسها .
هذا الوهم الماضوي هنا ، إنما يوازيه في خطئه ، خطأ أصحاب القول الحداثي وأوهامه ، بإمكانية افنتقال بهذه البلدان المتخلفة ، والقفز بها رأسآ إلى زمن مابعد الحداثة ، دون نظر معرفي موضوعي وملموس إلى الممكنات الفعلية للواقع وللنظام الإجتماعي ، والبنى المجتمعية المادية الراهنة ، ومستويات الثقافة والتعليم ونسب الأمية ... هذا الموقف الحداثي واللاواقعي ، يتطابق بلا واقعيته ، مع ذلك الموقف الأصولي نفسه ، ولكن من الجانب الآخر وبنظرة هي أيضآ وحيدة البعد ووحيدة الجانب ]] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فائز البرازي : 10/2/2007
العقل العربي / ساحة صراع
الجغرافيا / المحيط .
التاريخ / الأحداث والتجارب .
العلاقات الإجتماعية والثقافية .
دائرة حكمت وتحكم " تكون العقل العربي " . ومنها أيضآ يتم الإنطلاق لإعادة " تكوين العقل العربي " .. يتم ذلك بعكس الدوران الذي بدء منه بالجغرافيا ، التاريخ ، العلاقات المجتمعية الثقافية . فتصبح معاكسة الدوران : العلاقات المجتمعية والثقافية ، التاريخ ، الجغرافيا ..
تراكمات إعادة التكوين وبالشكل العلمي والموضوعي .. بالمعرفة ، والوعي ، والإرادة ، والفعل .. ستؤثر تراكميآ على العلاقات الإجتماعية والثقافية .
ذلك .. سيؤدي بالضرورة إلى إعادة قراءة وإستقراء التاريخ .. بحيث لاتؤخذ " النتائج " سلبية أم إيجابية بشكلها المجرد والمعزول . بل تدرس وتبحث " الأسباب " التي أدت لهذه النتائج . ويستمد منها دروس وتوجهات وأحكام عامة ، وأحكام خاصة متعلقة بالزمان والمكان والعوامل السائدة .
عندها لايكون التاريخ سيفآ مسلطآ على العقل بنتائجه ، بل سيفآ داعمآ للعقل بأسبابه .
وذلك .. سيؤدي بالضرورة إلى إعادة الإعتبارات الإيجابية للجغرافيا ..
على مستوى الإقليم والعالم : لايعود المحيط / الجغرافيا .. بالموقع ، والثروة محرضآ سلبيآ للآخرين بالسيطرة عليه لأهميته الإستراتيجية ولثرواته .. بل يكون محرضآ إيجابيآ لنا نحن العرب. الكتلة التاريخية الإنسانية للإستفادة من الجغرافيا الخاصة بنا ، لنقوى ونتقوى ونتوحد ونستغل هذه الجغرافيا لتراكمات الوعي والقوة ، مقاومة وتحرر وبناء .
على المستوى الداخلي للمحيط : لاتعود عقلية البداوة لتفرز الفردية والعشائرية القبلية والأسرية والحزبية والفئوية والطائفية .. الوعي سيقود إلى إعادة هيكلة المجتمع ..
هيكلة أي مجتمع ينمو ويتقدم ، ليست مبنية على تجزئة المجزئ . ليست مبنية على قبيلة أو طائفة دينية أو إثنية ، والصراعات بينهم وبداخلهم .
هيكلة أي مجتمع ينمو ويتقدم .. مبنية على تحقيق الكتلة التاريخية لهذا المجتمع / الأمة .
ومبنية على مسار وحوافز الطبيعة البشرية .. صراع الطبقات السلمي .. صراع الطبقات السلمي ضمن الوحدة الوطنية والكتلة المجتمعية الواحدة / الأمة ، هو الدافع والمحرض .
في المذهبية الدينية : مسلمين ومسيحيين . سنة ، شيعة ، إسماعليين ، علويين .. الخ . كاثوليك ، أرثوذكس ، أقباط ، مارونيين ، أرمن .. الخ . في المذهبية الدينية على إختلافاتها : هناك إقطاع ورؤوس أموال . وكادحين وفقراء . هناك المستَغٍل ، وهناك المستَغَل .. وكذلك في العشيرة القبيلة ، في الإثنيات ، في الأحزاب ..
المجتمعات الإنسانية تقوم على : تلاحم وتكالب وإتفاق الإقطاع ورأس المال ، مقابل : الفقراء والكادحين والمستَغلين . بين أصحاب المصالح الفردية الذاتية الإستغلالية – رأس المال لاوطن له – وبين أصحاب المصلحة الحقيقية في الوطن ..
وهذا يتجاوز كل المجزئ ، ويعيد تشكيل الكتلة الوطنية .
والهيكلية المجتمعية ستطرح مشكلات تحتاج إلى حلول عملية وعلمية : الريف ، والمدينة – العلاقات الزراعية والتجارية والصناعية – طبيعة نظام الحكم والتمثيل المجتمعي الوطني ..
كل ذلك .. في التاريخ والجغرافيا : سيف ذو حدين . وعلينا أن نكون على معرفة ووعي بطريقة إستخدام هذا السيف .
كيف نسير على طريق المعرفة والوعي ؟ بالعودة إلى الثقافة .. إلى إفراز علاقات إجتماعية بناءة . كيف ؟ لنبحث ..
فائز البرازي : 3/2/ 2007
التاريخ: الثلاثاء 13 فبراير 2007
الموضوع: مقالات وآراء
..............."
إنتهى النقل
يحى الشاعر
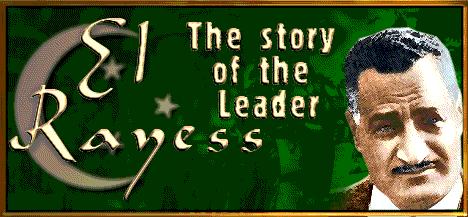 |
الــــرجوع الى الفهـــرس للمتابعة والمواصلة